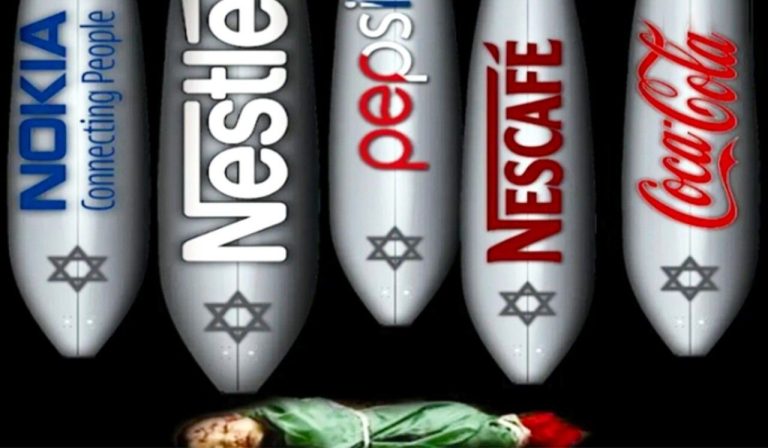“مِن الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم، أمّا بعد، فإنه من لحق بي منكم استُشهد معي، ومن تخلّف لم يبلغ الفتح”.
بحسب نصِّ هذه الرسالة “البرقيّة”، فإنَّ الملتحقين هم شهداء، وبالتالي لا انتصارَ عسكريّاً لهم، وعليه فالفتح لا يعني النصر العسكري، إذاً ماذا يعني ؟
إنَّ إطلاق مصطلح “الفتح” في هذه الرسالة الموجَّهة إلى بني هاشم – وهم عائلة بيت الوحي، ونخبة الأمَّة – يفيد وضوح هذا المصطلح في أذهانهم، وهذا ما يدفعنا نحو التعمّق في معنى الفَتْح الذي يشكِّل في هذه الرسالة عنواناً كبيراً للنهضة الحسينية.
معنى الفَتْح في اللغة والقرآن الكريم
الفتح في اللغة نقيض الإغلاق، فـ “فَتَحَ” “ضد أَغْلَق، كفَتَحَ الأبواب فانفتحت”.
أمَّا القرآن الكريم، فقد استخدم الفَتْح في غير آية نعرض منها ما ورد في سورتين تُضيئان على معنى الفَتْح في رسالة الإمام الحسين عليه السلام:
1- ما ورد في سورة الفتح: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمً ﴾.
2- ما ورد في سورة النصر: ﴿ إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾.
من الواضح أنّ الفَتْح في الآيتين بمعنى واحد، هو قرين للنصر الذي منَّ الله تعالى به على نبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين.
وقد نقل العلاّمة الطباطبائي في الميزان عدة معانٍ قيلت في تفسير الفَتْح في الآية الأولى، هي:
1- المُراد بالفتح فتح مكة.
2- المُراد به فتح خيبر.
3- المُراد به الفَتْح المعنوي، وهو الظفر على الأعداء بالحجج البيِّنة والمعجزات الباهرة التي بها تمَّت غلبة كلمة الحقّ على الباطل، وظهر الإسلام على الدِّين كلّه.
إلا أنَّ العلاَّمة رفض هذه التفاسير الثلاثة بسبب عدم ملاءمتها لسياق الآيات، فضلاً عن أنَّ القرائن لا تساعد على بعضها.
وما يدلُّ على صحة ما ذكره –رحمه الله- هو التأمل بسياق ما تَقدَّم من آيات. ففي آيتي سورة الفَتْح هناك ربط واضح بين الفَتْح وذنب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما تقدم منه وما تأخر، والذي لا بدَّ أن يُحلَّل حتى يتضح المُراد من معنى الفتح.
وقفة مع ذنوب الأنبياء:
من الواضح في عقيدتنا عصمة أنبياء الله تعالى من الآثام والمعاصي، والتي يمكن مقاربتها من خلال دليلين:
الأول: دليل عقلي ينطلق من غاية النبوة في هداية الناس، فلو كان النبي يعصي الله تعالى، فإنّ عصيانه سيكون ذريعة لأتباعه لارتكاب الآثام حينما يقارنون بين أنفسهم وبين النبي المُتصل بالوحي، والمصطفى من الله تعالى في النبوة من بينهم، لكونه أكملهم، فلو كان هذا النبي يعصي الله عزّ وجلّ، فإنَّ أتباعه سيسوِّغون معاصيهم بعصيانه، وهو الأكمل والمُجتبى الإلهي. إضافة إلى أنَّ الله تعالى جعل الأنبياء عليهم السلام أسوةً وقدوةً للناس، ودعاهم إلى الاقتداء بهُداهم، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ * وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾، فهل يُعقل أنَّ الله تعالى يجعل المذنبين والعاصين قدوة وأسوة للناس، وهو يريد أن يهتدي الناس من خلال الاقتداء بهم؟!
والأغرب من ذلك أن يُخبر الله تعالى الناس عن آثامهم ومعاصيهم، مع أنه هو الذي بعثهم وأرسلهم لهداية الناس. ألا يُخالف هذا الأمر الحكمة والمنطق ؟!!!
أعرض مثالاً مُقرِّباً للفكرة:
أنا حينما أكون إماماً لمسجد، والناس يثقون بي، فلو أردت أن أغيب عن المسجد شهراً، واستعنتُ بأحدهم ليصلي إماماً بالناس أثناء غيابي، وتمهيداً لذلك أردت أن أقدّمه للناس كي يثقوا به، ويصلّوا خلفه، فقلت لهم: “من يثق بي، فَلْيثقْ بفلان الذي سيأتي ويُصلّي إماماً أثناء غيابي. وأكملتُ قائل: صحيح أنه كاذب وسارق، وقاتل للنفس المُحترمة، ولكن عليكم أن تصلّوا وراءه وتهتدوا بهداه.
أليس كلامي هذا مخالفاً للحكمة والهدف الذي ابتغيته ؟!!!
وبناءً عليه لا يُعقل أنَّ الله تعالى قد أخبرنا عن الأنبياء لنهتدي بهداهم، ثم يُخبرنا عنهم بأنّ أحدهم قاتل بغير حق، والآخر سارق، والثالث كاذب، والعياذ بالله.
من المؤكِّد أنَّ من يفهم هذا، من بعض الآيات، قد أخطأ في فهم كتاب الله تعالى، وابتعد عن الأهداف الإلهية السامية.
وعليه لا بُدَّ من فهم آخر للكتاب العزيز ينسجم مع ما مرَّ من الدليل العقلي.
الدليل الثاني: هو إخبار الله تعالى بوضوح أنَّ الشيطان لا يدخل دائرة المخلَصين، بل هو يائس غير طامع في إغوائهم، لذا أقسم إبليس على إغواء جميع بني آدم عليه السلام، لكنه استثنى المُخلَصين. قال تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾، فلو كان الشيطان مُتمكِّناً من إغواء هؤلاء المُخلَصين لما تخلّى عن إغوائهم.
والمخلَصون –بفتح اللام، مقابل المخلِصين بكسرها، وهم الذين اصطفاهم الله تعالى خالصين له- وإن لم يوجد دليل على أنهم ينحصرون بالأنبياء عليهم السلام – إلا أنّه مما لاشك في شمول المخلَصين لجميع الأنبياء، ولتأكيد ذلك وصف الله تعالى جملة من الأنبياء بوصف المخلَص:
– قال تعالى عن النبِّي موسى عليه السلام، والذي قد يُفهم خطأً أنه قَتَلَ بغير حق ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّ ﴾.
– وقال تعالى عن النبِّي يوسف عليه السلام، والذي قد يُفهم خطأ انجذابه السلبي نحو امرأة العزيز: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾.
– وقال تعالى عن جُملة من أنبيائه عليهم السلام: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ * إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّار ﴾.
بناءً على ما تقدَّم لا يُمكن أن نُفسِّر الذنب الوارد في سورة الفَتْح بالمعصية والإثم، لا سيَّما أنَّ الحديث هو عن سيِّد بني البشر، وخاتم الأنبياء والرُسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وعليه نقول: إنَّ معنى الذنب في اللغة “الجُرم”، وهو من المفاهيم النسبية التي يَختلف انطباقها بحسب حال الإنسان وموقعه وبيئته. حاله في ذلك حال معنى العيب، فإنه أيضاً من المفاهيم النسبية، إذ نلاحظ أنّ بعض تصرفات الإنسان البدوي في بيئته لا يُرى عيباً، بينما نفس التصرّف يُحكم عليه بالعيب في البيئة الحضرية، وكذلك نُلاحظ أنه لو أكل شابٌّ عادي في شارع عام لا يُعتبر ذلك منه عيباً، ولكن لو أنّ عالم دين ذا مكانة فعل ذلك فقد يُلام، ويُعتبر ذلك منه عيباً، بل قد يراه البعض مُسقطاً للمروءة.
واللافت في نظرة الناس إلى نسبيَّة الذنب أنهم قد يعتبرون نفس الفعل حسناً من ناحية، وذنباً من ناحية أُخرى، وقد يكون منشأ هذا الأمر مقام الإنسان وشأنيَّته، فلو أنّ شاباً متديناً ليس له تميّز في موقعه وشأنه الاجتماعي، طلب من أحد الأشخاص البعيدين عن أجواء التدين والأخلاق مساعدةً لأجل نشاط إسلامي، فقام ذلك الشخص ووبَّخه وطرده رافضاً إعطاءه أية مساعدة، فما هو موقفنا من عمل هذا الشاب؟
من الطبيعي أن نثني على عمله، ونعتبره حسناً، وإن لم تحصل النتيجة المطلوبة.
ولكن لو أنَّ مرجعاً دينياً أو قائداً كبيراً قام بهذا الطلب، وطرده ذلك الرجل، فهنا قد نُعاتب المرجع أو القائد: بأنّ هذا العمل غير لائق ومناسب لمقامه وشأنه، فلا نعدُّ ما صدر عنه حسناً باعتبار شأنيَّته وموقعه، فهذا الفعل هو حسن باعتبار، وهو ليس كذلك باعتبار آخر.
ولتقريب الفكرة أكثر أُعطي مثالاً يتعلق بالحكم على الشيء تارة بلغة العقل وأُخرى بلغة القلب.
فقد ورد في الأدب العالمي قصص حبٍّ وعشقٍ خرجت عن مألوف الناس، كعشق روميو لجوليت، في الأدب الإنكليزي، وشيرهاد لشيرين في الأدب الفارسي، وقيس لليلى في الأدب العربي الذي ورد فيه أنَّ قيساً كان يتبدل حاله بين العقل والجنون بسبب لقائه ليلى.
وبغضّ النظر عن واقعية تلك القصة، واعتماداً على المعروف منها، فلو أنَّ قيساً كان يجلس مع ليلى، فهو يعتبر أنّ جلوسه معها يُمثِّل قمة السعادة وغاية الكمال المنشود، فلو أنه أثناء جلوسه مع معشوقته اضطرَّ إلى تركها نصف ساعة ليُعطي الدواء لأُمِّه المريضة، ثم عاد إليها، فما هو الحكم المناسب لذهابه إلى والدته لأجل مداواتها ؟
فمن الواضح أنّ هذا العمل، بلغة العقل والمجتمع، هو حسن، بل من أوجب الواجبات، وأفضل ما يقوم به الإنسان في حياته من أعمال.
ولكن إذا أردنا الحديث عن موقف قيس حينما يرجع إلى ليلى – وهي عارفة بما قام به- وقد تركها نصف ساعة، فهل يعود بشكل طبيعي بدون اعتذار؟ أو أنه يعتذر إليها لغيابه عنها نصف ساعة، على رغم ضرورة ما قام به؟ الجواب بلغة القلب: أنه يعتذر إليها، على قاعدة أنّ للعقل لغة، وللقلب لُغة أُخرى، ففعله بلغة العقل حسنٌ، وبلغة القلب بحاجة إلى اعتذار.
وهكذا هو حال الأنبياء عليهم السلام في كثير من حالاتهم التي يعتبرون فيها أنّ خلوتهم مع الله تعالى، وقيامهم بين يديه- عزَّ وجل- تُمثِّل لهم قمة الكمال الإمكاني، والعبودية الإنسانية. لذا فهم حينما ينصرفون من بين يدي الله تعالى لأجل القيام بأمور لا تخلو من حُسْن، فإنَّهم يرجعون إلى الله تعالى في خلوتهم معه، معتبرين ما صدر عنهم بأنه ذنب، وعليهم أن يستغفروا الله بسببه. وهذا من مصداق القول المعروف: “حسنات الأبرار سيِّئات المقرّبين”
والخلاصة:
أول: أنّ الذنب لا يعني -دائماً- الإثم باعتباره معصية لأوامر الله الإلزامية.
ثاني: أنّ الذنب قد يُطلق على أمر حسن بذاته، لكنّه ليس كذلك باعتبار مقام بعض الناس وأولويّاتهم.
ثالث: أنّ الذنب قد يُطلق على أمرٍ ليس فيه حُسن ذاتي، إلاّ أنّه يُعدّ جرماً لبعض الاعتبارات دون بعضها الآخر.
عودة إلى آيتي الفتح
وبناءً على ما تقدّم اتضح أنَّ المُراد من الذنب المُتقدِّم والمُتأخر، في الآية الثانية من سورة الفَتْح، ليس الإثم والمعصية، فما هو المُراد منه إذاً؟
إنَّ التأمل بسياق الآية في ضوء السيرة النبوية يوصل إلى أنّ المراد من ذنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آيتي الفَتْح هو التبعة السيِّئة التي لدعوته صلى الله عليه وآله وسلم عند الكفار والمشركين، فقد تأذَّى المشركون والكافرون كثيراً من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي اعتبروها مقوِّضة لأركان تراثهم وما يعتبرونه ديناً لهم، وبالتالي لعزّتهم وكرامتهم أمام سائر العرب وغيرهم. لذا كانوا يعتبرون ما قام به النبِّي صلى الله عليه وآله وسلم من الدعوة إلى الإسلام، ومناهضة عبادتهم للأوثان ذنباً كبيراً أرادوا أن يؤكِّدوا نظرة الناس إليه كذَنْب، ويروِّجوا ذلك في أوسع بقعة يتمكنون منها.
ولأجل ذلك شنّوا هجوماً على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية الإعلان عن دعوته من خلال الدعاية المُشوِّهة لصورته ودينه الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إليه، فنعتوه بالساحر والمجنون والشاعر المختلق للقرآن، بل ورد أنهم كانوا في مراسم الإقبال على مكة يجعلون بعض رجالهم قرب النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشوِّشوا عليه ويشوِّهوا صورته بنعته بتلك الصفات السلبية.
وقد أثَّرت هذه الدعاية بشكل كبير في العرب فحالت بين عقولهم وتأثُّرها بالمنطق النبوي، وبين قلوبهم وتوجُّهها نحو رسالته الإلهية.
نعم لقد اختلق أهل قريش قضية كاذبة حول شخصية النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته، وعمَّموها على البلدان، وسيطروا بها على عقول كثير من العرب وقلوبهم، فأصبحت عقولهم وقلوبهم مُغلقة أمام دعوة الإسلام.
لقد كان عمل أهل قريش يُركّز على إدراك الإنسان، لأنّ من يستطيع السيطرة عليه يُمكنه تسيير الإنسان بالوجهة التي يريد، إذ أنّ سلوك الإنسان تابع لإدراكه وعلمه، وليس لواقعية الشيء، فالإنسان الذي تقترب منه أفعى سامة، وهو لا يعلم بوجودها، فإنّه لا يتحرك من مكانه ولا يهرب منها، فإذا علم بها، فإنه يتحرك هارباً. وهذا يدلُّ على أنّ الذي يحرِّك الإنسان ويؤثِّر في سلوكه هو إدراكه، وليس وجود الشيء الواقعي.
وهكذا نلاحظ أنّ نظرة الإنسان إلى الإنسان الآخر وسلوكه معه لا يكونان بحسب ما هو عليه الآخر من واقع، بل بحسب إدراك الإنسان الذي قد يكون وهماً لا حقيقة. بل إنّ الإنسان قد لا يتفاعل مع قيمة عالية لعدم إدراكه لها، فقد يطوف المؤمن حول الكعبة الشريفة وكتفه إلى جنب كتف إمام الزمان وصاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لكنه لا يتأثر بذلك بسبب عدم معرفته به، في حين أنه لو عرفه ستكون حالته مما يصعب توصيفها. وقد يعتقد الإنسان بمقام إنسان آخر، فيقدِّره، ويحترمه، ويجلّه، مع أنّه قد يكون واهماً في اعتقاده.
إذاً ما يحرك الإنسان ويؤثِّر في سلوكه هو إدراكه، وليس الواقع المجرَّد عن ذلك الإدراك.
وبالعودة إلى أهل قريش الكافرين فقد مارسوا لعبة الإدراك بذكاء وشيطنة حتى استطاعوا أن يؤثِّروا في عقول العرب وقلوبهم بشكل كبير بحيث إنَّ الدعاية المنتشرة المشوِّهة لصورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودينه أضحت قابلة للاستمرار بشكل مركّز في المستقبل.
فعقول العرب وقلوبهم كانت مُغلقة بشكل مُحكم قابل للاستمرار والبقاء، بحيث كان ذلك مانعاً من دخولهم إلى دين الله تعالى.وبعبارة أُخرى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نظرهم مُذنباً ذنباً كبيراً كما تقدَّم في ما قام به من الدعوة، وسيستمرُّ ذنبه في المستقبل طالما هو سائر في دعوته.
من هنا كان هذا الإغلاق للعقول والقلوب مانعاً من دخول الناس في دين الله أفواجاً، فكيف يُحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغييراً في المُجتمع، وفتحاً لعقول أبنائه وقلوبهم؟ وبالتالي كيف ينجح في نشر الدين الإسلامي بدون عقبات وموانع، فيفتح بنجاحه الأبواب المغلقة؟
عناصر نجاح الدعوة
هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح الدعوة وفتحها للمُغلق هي:
1- قوة الأطروحة.
2- مصداقية صاحب الأطروحة.
3- التضحية بالأعزّ.
وهذه العناصر نجدها واضحة في دعوة النبِّي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
فأطروحته هي الإسلام، الرسالة الخاتمة التي تُمثِّل أعظم رسالة تُحقق الكمال الإنساني. وهي تعتمد على العقل القطعي الذي يواكبه ويكشف عمَّا لا يطاله النصُّ الإلهي الذي تُفصِّله وتكشف خباياه السُنَّة النبوية الشريفة.
وقد دعم هذه الأطروحة إعجاز بياني عجز ويعجز الناس عن الإتيان بمثله، ولو كان سورة قصيرة من سور القرآن، وإعجاز واكب النص في دلالة الصدق.
أمَّا مصداقية صاحب الأطروحة فكان لها أثر كبير في تأثُّر الناس بالرسالة،وكما يقول أحد المستشرقين: إنّ الإسلام لو نزل قرآناً بدون أن يرتبط بسيرة وسلوك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أثّر ذلك في انتشاره الواسع، فإنّ ما أثَّر في ذلك هو أنَّ المسلمين كانوا يسمعون ويقرؤون القرآن، ويرَوْنه ناطقاً متجسِّداً في سيرة ومسلك نبيِّ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما أدَّى إلى ذلك الانتشار الكبير.
وكنموذج على تأثير المصداقية نعرض قصة ذلك الجار اليهودي الذي كان كثيراً ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يضع كلَّ يوم نفاياته قرب باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يصدر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أي موقف سلبي منه رغم طول المدة في هذا الأذى.
وذات يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته، ولم يجد أثراً للنفايات، فتعجَّب وسأل عن سبب ذلك، فقيل له: إنّ اليهودي مريض. وهنا انبرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليُجسِّد أمام أصحابه قيمة مهمَّة من قيم الإسلام، ألا وهي زيارة المريض، لا سيّما إذا كان جاراً. فذهب لزيارته مطمئنّاً عن صحته. وحينما علم اليهودي ما قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيارته من قيمة عاليةٍ عَلِم بأنّ هذه الأخلاق هي أخلاق أنبياء، فإذا به يقرّ أمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين: “أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً رسول الله”.
إنَّ هذا اليهودي، رغم أنه قد سمع الأطروحة القوية، لم يتأثَّر، أوّل الأمر، إلا أنّه تأثّّر بتلك المصداقية الحقة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا شواهد كثيرة في حياة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم.
أمّا التضحية بالأعزّ، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المقدام الأول في طريق التضحية بنفسه وبأحبّ الناس إليه، وهو الذي كان الأول في ميدان القتال، فكان أصحابه يلوذون به، وكما يُعبِّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: “لقد رأيتُنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أقربنا إلى العدوّ، وكان من أشدّ الناس بأساً”. وقدَّم صلّى الله عليه وآله في بداية هذه المعركة، أهل بيته وخاصّة عائلته دون بقية المسلمين، وهكذا في المحطات الأُخرى من سيرة حياته.
ولعلَّ ما يوضّح هذه العناصر الثلاثة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضية المباهلة، فقد روى القُمّي في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام أنَّ نصارى نجران لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سيدهم الأهتم والعاقب والسيد، وحضرت صلاتهم، فأقبلوا يضربون بالناقوس، وصلّوا، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا في مسجدك؟! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: “دعوهم”. فلما فرغوا دنوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالو: إلى ما تدعونا؟ فقال: “إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأنَّ عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويُحدث”، قالو: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: “قل لهم ما تقولون في آدم عليه السلام، أكان عبداً مخلوقاً، يأكل، ويشرب، وينكح”؟ فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالو: نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: “فمن أبوه”؟ فبهتوا، فبقوا ساكتين، فأنزل الله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “فباهلوني، فإنْ كنت صادقاً أُنزلت اللعنة عليكم، وإنْ كنت كاذباً نزلت عليّ”. فقالو: أنصفت، فتواعدوا للمباهلة، فلما رجعوا إلى منازلهم، قال رؤساؤهم السيد والعاقب والأهتم: إن باهلَنا بقومه باهلناه، فإنه ليس بنبي، وإن باهلَنا بأهل بيته خاصة، فلا نباهله، فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا وهو صادق. فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا ابن عمه، ووصيُّه وخَتَنُه [أي صهره] علي بن أبي طالب، وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابناه الحسن والحسين عليهم السلام، فعرفوا، وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعطيك الرضى، فأعفِنا من المباهلة، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجزية وانصرفوا.
فالملاحظ في قصَّة المباهلة أنَّ النبَّي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق في البداية في حواره معتمداً على قوَّة الأطروحة، إلا أنَّ ذلك لم ينفع معهم، فلجأ إلى الخيار الثاني الذي يدلُّ على العنصرين الآخرين وهما المصداقية والاستعداد للتضحية بالأعزّ، وهذا ما أدركه جيداً رؤساء الوفد الذين اعتبروا أنَّ مجيء النبِّي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل بيته – وهم الأعزّ على قلبه – يُمثِّل المصداقية العالية والاستعداد للتضحية بهم، وهذا ما دعاهم إلى التراجع والقبول بالجزية.
إلا أنَّ هذه العناصر الثلاثة رغم توافرها (مع ملاحظة أنًَّ العنصر الثالث كان في مستوى الاستعداد لا الفعلية لعدم توفر الظروف الموضوعية) لم تفلح في صناعة فتح العقول والقلوب بشكل عام، وبالتالي فتح باب الإسلام على مشراعيه أمام الوافدين. إلا أنَّّ الله تعالى منَّ على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بعنصر رابع هو النصر العسكري الذي هُزِم من خلاله أهل قريش في مكة، وفُتحت به أبوابها أمام المجاهدين المسلمين حينها. وبعد النصر العسكري، تحقق الفَتْح الأكبر لعقول الناس وقلوبهم، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينً ﴾. وبهذا انتصرت رسالة الإسلام على لعبة الإدراك القريشية في تشويه صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودينه، فكانت عاقبة النصر والفتح ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمً ﴾، فبَطُلَ خداعهم، وذهب تشويههم ماضياً ومستقبلاً أدراج الرياح، وعندها، وبعد أن ﴿… جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ *… رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجً ﴾.
الفتح الحسيني
نعم، لقد استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفتح عقول الناس وقلوبهم من خلال عناصر أربعة:
1- قوة الأطروحة.
2-مصداقية صاحبها.
3- الاستعداد للتضحية بالأعزّ.
4- النصر العسكري.
إلا أنَّ فتحاً يشابه هذا الفَتْح حصل بعد حوالي خمسين عاماً من هذا الفتح، فيه قوَّة الأطروحة امتداداً لقوَّتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مصداقية صاحبها المتماهي بكلِّه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها استبدلت النصر العسكري بالتضحية بالأعزّ فعلاً لا استعداداً، كما حصل في زمن الرسالة، وذلك في أروع مشاهد التضحية في التاريخ.
ومن الطبيعي أن يُطرح عند هذا الكلام سؤال عن الإغلاق الذي احتاج إلى هذا الفتح، فما الذي حصل لتُغلق العقول والقلوب ثانية وتحتاجَ إلى فتح جديد؟
الإغلاق بعد الفَتْح النبوي
إنَّ الإضاءة على السنوات العشرين التي حكم فيها معاوية ابن أبي سُفيان تُبيِّن لنا حقيقة التحوُّل الذي حصل في الأمة، فأُغلقت عقول أبنائها وقلوبهم.
أبتدئ بما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لنهج البلاغة، فقد قال: “روى الزبير بن بكار في الموفّقيات، وهو غير مُتَّهم على معاوية، ولا منسوب إلى اعتقاد الشيعة، لما هو معلوم من حاله من مجانبة علي عليه السلام، والانحراف عنه -: قال المطرف بن المغيرة ابن شعبة: دخلت مع أبي على معاوية، فكان أبي يأتيه، فيتحدث معه، ثم ينصرف إليَّ، فيذكر معاوية وعقله، ويعجب بما يرى منه، إذ جاء ذات ليلة، فأمسك عن العشاء، ورأيته مغتمًّا، فانتظرته ساعة، وظننت أنه لأمر حدث فينا، فقلت: ما لي أراك مغتمًّا منذ الليلة ؟ فقال: يا بني، جئتُ من عند أكفر الناس وأخبثهم، قلت: وما ذاك ؟ قال: قلت له وقد خلوت به: إنك قد بلغتَ سنّاً يا أمير المؤمنين، فلو أظهرتَ عدلاً، وبسطتَ خيراً، فإنك قد كبرت، ولو نظرتَ إلى إخوتك من بني هاشم، فوصلتَ أرحامهم، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه، وإنّ ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه، فقال: هيهات هيهات ! أيّ ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تَيْم فعدل، وفعل ما فعل، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: أبو بكر. ثم ملك أخو عَدِيّ، فاجتهد وشمَّر عشر سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر، وإنّ ابن أبي كبشة لَيُصاح به كلَّ يوم خمس مرات: (أشهد أنّ محمداًَ رسول الله)، فأيُّ عملٍ يبقى، وأيُّ ذكرٍ يدوم بعد هذا، لا أباً لك ! لا والله إلا دفناً دفناً!!”.
إنَّ هذه الرواية تُسلِّط الضوء على الخلفية الثأرية في سياسة معاوية بن أبي سفيان الذي كان يرى أنَّ محمد بن عبد الله قد أذلَّ بني أمية وأخذ عزَّهم بقوة السلاح، لذا سعى معاوية جاهداً للقضاء على إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبر تفريغه من مضمونه ومحتواه الحقيقي، وقد أدرك الكثير من البحَّاثة – من المسلمين وغيرهم- هذه الحقيقة، وهذا ما نقرأه في كتاب نيكلسون، حسب ما نقله الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام، إذ يقول ذلك المستشرق: “اعتبر المسلمون انتصار بني أمية وعلى رأسهم معاوية انتصاراً للأرستقراطية الوثنية التي ناصبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه العداء، والتي جاهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قضى عليها، وصبر معه المسلمون على جهادها، ومقاومتها حتى نصرهم الله، فقضوا عليها، وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام، ذلك الدين السمح الذي جعل الناس سواسية في السراء والضراء، وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون الفقراء، ويستذلون الضعفاء، ويبتزون الأموال، لذلك لا ندهش إذا كره المسلمون بني أمية وغطرستهم وكبرياءهم وإثارتهم الأحقاد القديمة، ونزوعهم للروح الجاهلية، ولا سيما أنّ جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأمويين رجالاً كثيراً لم يعتنقوا الإسلام إلا سعياً وراء مصالحهم الشخصية. ولا غرو، فقد كان معاوية يرمي إلى جعل الخلافة ملكاً كسروياً، وليس أدلَّ على ذلك من قوله: أنا أول الملوك”.
نعم، إن قراءة سلوك معاوية وسياساته تظهر بوضوح ما كان يخفيه من هدف القضاء على المضمون الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل.
خطوات معاوية لتحقيق المشروع الأموي
وقد سلك معاوية لأجل تحقيق هذا الهدف خطوات عديدة نذكر منه:
1- التحريف في العقيدة الإسلامية
حاول معاوية أن يُغيِّر أساساً عقائدياً ليكون في خدمة نجاح خطته وتوطيد سُلطانه، فتظاهر بعقيدة الجبر، ليكون ذلك مسوِّغاً لأفعاله الظالمة بنظر الناس، فعلى مبدأ الجبر لا يكون له الخيار في هذه الأفعال، بل يكون مجبراً عليها، وبالتالي فإن أفعاله هي من الله تعالى، فلا يجوز أن يعترض عليها أحدٌ.
كما تظاهر معاوية بعقيدة الإرجاء، التي تعتبر أنَّ الإيمان هو عمل قلبي خالص لا يحتاج إلى التعبير عنه بفعل من الأفعال، فيكفي الإنسان أن يكون مؤمناً بقلبه ليعصمه الإسلام، ويحرم الاعتداء عليه.
فمن مشهور أقوال المرجئة: “لا تضرُّ مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة”. بل قالو: “إنَّ الإيمانَ الاعتقادُ بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه، وعبد الأوثان، أو لزمَ اليهودية والنصرانية في دار الإسلام، وعبدَ الصليب، وأعلن التثليث في دار الإسلام، ومات على ذلك، فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عزَّ وجل ومن أهل الجنة”.
ومن الواضح مدى استفادة معاوية وبقية الأمويين من هذه العقيدة التي تجعلهم مؤمنين مهما ارتكبوا من الكبائر.
“وقد كان المرجئة يبشِّرون بهذه الأفكار بين صفوف الأمة المسلمة لأجل تخديرها، وصرفها عن الاستجابة لدعاة الثورة على الأمويين.
وبينما نجد الأمويين يضطهدون كل دعوة دينية لا تلائمهم نراهم بالنسبة إلى المرجئة على العكس من ذلك، فهم يحتضنون هذه الفرقة، ويعطفون على قادتها، وما ذلك إلا لأنّ معاوية سيدهم هو واضع أُسسها”.
2- التغيير في الشريعة الإسلامية
كتب الإمام الحسين عليه السلام رسالة لبعض زعماء الكوفة قال فيه: “وإنّما أدعوكم الى كتاب الله، وسُنّة نبيّه، فإنّ السُّنّة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أُحييت”. ومعنى البدعة هو إدخال شيء في الدّين وهو ليس من الدّين، وإماتة السُّنّة وإحياء البدعة، إن كانا في الممارسة العملية فهذا أمرٌ خطير، إلا أنّ الأخطر منه أن يكون ذلك بتغيير المفاهيم والأحكام.
وفي خطبة الإمام الحسين عليه السلام أمام جيش الحرّ بن يزيد الرِّياحي أخبر عليه السلام بنفس المضمون السابق قائلاً “…. وقد علمتم أنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتولَّوا عن طاعة الرحمان، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله…”.
سعى معاوية إلى تخدير الناس باسم الدين، عبر تحريف الأحكام الإسلامية السياسية، ليشلَّ بذلك الحركات الثورية المناهضة له، لا بقوة السلاح، بل بخلفية دينية أراد أن يزرعها في أذهان الناس من خلال أحاديثَ موضوعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشترى علماء السوء ليبثُّوها في المجتمع، كذلك الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “من رأى من أميره شيئاً يكرهه، فليصبر، فإنّ من فارق الجماعة بشبر فمات، إلا ميتة جاهلية”.
وقد أدَّت هذه الأحاديث الموضوعة والتي كانت تدرَّس في الدواوين والكتاتيب إلى إيجاد حالة شعبية تعتقد بتحريم المعارضة ضدّ الحكم الظالم، بل تدعو إلى القضاء عليها، بغضّ النظر عن مدى صوابيّة طرحها، ومع عدم أخذ الممارسات الظالمة من قبل الحكومات بعين الاعتبار.
3- التشويه في القدوة الأصيلة
أدرك معاوية جيداً أثر القدوة في العقيدة والسلوك، وهو قد لامس الآثار المهمَّة الناتجة في الاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ما كان يسبب انزعاجه الكبير، كما تقدم.
تشويه صورة النبِّي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
من هنا راح يخطّط ويسلك لتشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أذهان المسلمين، من خلال شراء علماء السوء لنشر أحاديث كاذبة في ذلك والتي نقرأ – منها – وللأسف ما بقي إلى يومنا هذا.
– منه: ما رُوي في مناجاة منسوبة إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: “إنَّما أنا بشرٌ، فأيُّ المسلمين لعنتُه، أو سببتُه، فاجعلها له زكاة وأجراً”.
– ومنه: ما روَوه أنه صلى الله عليه وآله وسلم ساعد إحدى زوجاته، لتنظر إلى رقص الحبشة في مسجده.
– ومنه: ما رووه من إقامة حفل موسيقى في منزله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل جاريتين كانتا تدفِّقان، وتضربان، فدخل عليه أبو بكر، وانتهرهما، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: “دعهما يا أبا بكر، فإنها أيّام عيد”.
لقد أدّى هذه التشويه الفاضح للصورة المقدَّسة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبري أحد الولاة على منابر المسلمين، ويقول لهم: “أخليفة أحدكم أكرم عند الله أم رسوله؟!”.
تشويه صورة الإمام علي عليه السلام
وفي نفس المسلك الهادف إلى تشويه القدوة الأصيلة لمنع تأثيرها في المجتمع الإسلامي خطَّط معاوية وسلك في تشويه صورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فاشترى سَمُرَة بن جندب بـ 400 ألف درهم – وفي بعض الروايات 500 ألف درهم – ليروي أنّ قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ…. لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ﴾ نزل في علي بن أبي طالب.
وأنّ قوله تعالى ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ قد نزل في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام.
وكتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله: “أن برئت الذمة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب (أي الإمام علي عليه السلام) وأهل بيته، فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علياً، ويبرؤون منه، ويعقُّون فيه، وفي أهل بيته”.
بل ذكر ابن أبي الحديد أنّ الأمويين منعوا الناس أن يسمّوا أبناءهم باسم علي.
وقد ذكر التاريخ أنّ كثيراً من الناس كانوا يتفرَّقون بعد صلاة العيد حتى لا يسمعوا الخطيب يلعن علياً، فأحدث معاوية تقديم خطبة العيد على الصلاة، لكي يسمع الناس لعن علي عليه السلام.
معاوية قدوة دينية !!
ومقابل التشويه الكبير لصورتي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام حاول معاوية أن يدخل نفسه قدوة دينية في المجتمع الإسلامي، فأخذ يعمل على بثِّ الأحاديث الكاذبة في ذلك، والتي منها ما رُوي كذباً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “الأمناء عند الله ثلاثة: أنا، وجبرئيل، ومعاوية”. “أنا مدينة العلم، وعليٌّ بابها، ومعاوية حلقتها”. وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناول معاوية سهماً وقال له: “خذ هذا السهم حتى تلقاني به في الجنة”.
ولكي يؤكد معاوية موقعه الديني المتقدم في المجتمع الإسلامي نصَّب أناساً يدعون له، وللمتعلِّقين به بعد الصلاة، فعن الليث بن سعد: “وأما قصص الخاصة، فهو الذي أوجده معاوية، ولّى رجلاً على القصص، فإذا سلَّم من صلاة الصبح، جلس، وذكر الله عز وجل، وحمده، ومجده، وصلَّى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودعا للخليفة ولأهل بيته، وحشمه، وجنوده، ودعا على أهل حربه، وعلى المشركين كافة”.
4- تفريق المجتمع الإسلامي
إضافة إلى سياسة التضليل الديني وتشويه القدوة التي مارسها معاوية، ولكي يحقق أهدافه في بسط سلطانه والقضاء على مضمون الرسالة المحمدية أخذ معاوية يزرع الفتنة بين القبائل منتهجاً نهج “فرِّق تسد”، ليستطيع بذلك القضاء السهل على أية معارضة تعمل ضده.
وكانت أولوية معاوية في هذه السياسة البلدان التي يصعب فيها التشويه الديني كالمدينة ومكة ومدن العراق، مقابل بعض البلدان المفتوحة كالشام التي كان من السهل تشويه دينها وتغيير قيمها.
ومن شواهد هذه السياسة ما قاله معاوية لرسوله إلى البصرة طالباً منه أن يُذكِّرهم بحرب الجمل، وبقتل عثمان قائل: “فانزل في مُضَر، واحذر ربيعة، وتودَّد الأزد، وانعَ ابن عفَّان، وذكِّرهم الوقعة التي أهلكتهم، ومنَّ لمن سمع وأطاع دنيا لا تَفنى وأثرةً لا يفقدها”.
5- إرهاب الناس
وتحقيقاً لأهدافه مارس معاوية سياسة الإرهاب والقتل والتعذيب والتشريد لا سيَّما في المناطق التي يصعب فيها – كما قلنا- تحريف الدين وتشويه قادته، وكان من أبرز أساليبه القتل وحرق البيوت وسلب الأموال، حيث قُتل في المدينة ومكة ثلاثون ألفاً عدا من أُحرق بالنار، “وكان أشدَّ الناس بلاءً أهلُ الكوفة، لكثرة من بهم من محِّبي علي عليه السلام، فقتلهم تحت كل حجر ومدر، وقطع الأيدي والأرجل، وأعمى العيون، وصلبهم على جذوع النخل، وطرد الكثير منهم، وشرّدهم عن العراق”.
وقد نقل المؤرخون أنه شرَّد من الكوفة خمسين ألفاً من أهلها ليغيّر الوضع الديمغرافي فيها. وقد بلغ إرهاب معاوية حدًّا جعل الرجل يفضّل أن يقال عنه: إنه زنديق أو كافر، ولا يقال عنه: إنه من شيعة عليّ.
ولم يتورَّع معاوية، وكذا ولاته في ممارستهم، عن أيِّ شيء.ويكفي شاهداً لذلك ما رُوي من جرائم فظيعة ارتكبها سمرة بن جندب أحد ولاة معاوية، فقد قتل في غداةٍ سبعة وأربعين رجلاً ممَّن جمعوا القرآن، وسبى نساء همدان، وباعهن في الأسواق، فكنَّ أول مسلمات اشتُرِين في الإسلام.
وهدم دور أهل المدينة المنورة، وجعل يستعرض الناس، فلا يُقال له عن أحد: إنه شريك في دم عثمان إلا قتله. وقتل ثمانية آلاف من أهل العراق، وحينما قيل له: هل تخاف أن تكون قتلت أحداً بريئاً؟ فردَّ قائل: لو قتلت مثلهم ما خشيت. وقد فعل كل ذلك لدعم ملك معاوية، وقد قال في ذلك: لعن الله معاوية، والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذبني أبداً.
آثار سياسات معاوية في المجتمع الإسلامي
عشرين سنة مارس معاوية تلك السياسات في المجتمع الإسلامي.
عشرين سنة ضلّل معاوية المجتمع محرِّفاً في عقيدته، مغيِّراً في أحكامه، مشوِّهاً صورة القادة الحقيقيين له، مفرِّقاً أبناءه، مسلطاً سيفه على كل من عارضه، مرهباً كل من لم يوالِهِ.
عشرون سنة مضت على حكم معاوية تحوَّل فيها المجتمع الإسلامي إلى ما يمكن تقسيمه إلى قسمين:
1- قسم أثَّرت فيه سياسة التضليل الديني أثرها، فتخدّر باسم الدين، واتخذ معاوية قدوته الأولى، منشدًّا نحوه لتحقيق ما يريد منه، حتى لو كان يخالف قيم الإسلام الأصيلة، وتشوَّهت لديه صور القادة الإلهيين حتى وصل الأمر بمجتمع أهل الشام الداخل في هذا القسم إلى أن يتعجَّب من قول المنادي: قتل علي بن أبي طالب وهو يصلي في المسجد، وسبب تعجبه عبَّر عنه بعض الناس في ذلك المجتمع: أو كان عليٌّ يصلي؟!!!
2- والقسم الآخر لم تستطع سياسة التضليل الديني أن تؤثِّر فيه، لكنّ الإرهاب والقتل والتشريد والتفريق أخذت فيه كلَّ مأخذ، فأصبح مجتمعاً مهزوماً هزيمة يصعب تصوّرها. وقد نقل التاريخ بعض مشاهدها من مجتمع الكوفة الداخل في هذا القسم حينما تجمَّع مع مسلم بن عقيل سفير الحسين عليه السلام أربعةُ آلاف مقاتل وأحاطوا قصر الإمارة الذي لا يوجد فيه ما يزيد على ثلاثين رجلاً، لكن أربعة آلاف انهزموا أمام الثلاثين.
وسبب ذلك هو الهزيمة النفسية لذلك القسم من المجتمع، والتي جعلت الأم تسحب ولدها من جيش مسلم، والأب يُرجع ابنه، والأخ يحبِّط معنويات أخيه، والجار يخيف جاره، حتى بقي مسلم وحده.
ومن مشاهد الهزيمة النفسية لذلك المجتمع ما حصل مع حبيب ابن مظاهر حينما استأذن أبا عبد الله الحسين عليه السلام ليدعو بني أسد لنصرته، فأذن له الإمام عليه السلام، فلما أتاهم ودعاهم أجابه منهم عشرات فقط، ولكن مع ذلك، وقبل أن يصلوا إلى معسكر الإمام الحسين عليه السلام، حصل تصادم بينهم وبين فرقة من جيش ابن سعد، كانت نتيجته ليس انسحاب هؤلاء فحسب، بل انسحاب جميع أفراد قبيلة بني أسد في جوف الليل خوفاً من ابن سعد، مما جعل حبيباً يرجع إلى الإمام الحسين دون أيِّ واحد منهم.
بل إنَّ خوف المُجتمع يُقرأ في كلمات الكبار حينما خاطبوا الإمام الحسين عليه السلام من مُنطلق حرصهم عليه، عندما قرَّر الخروج إلى العراق.
فها هو ابن عباس يقول له: “أتخوَّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال”.
وها هو عبد الله بن جعفر يكتب إليه: “إني أسألك الله لما انصرفت حين تقرأ كتابي هذا، فإني مشفق عليك من هذا الوجه أن يكون فيه هلاكك، واستئصال أهل بيتك”.
وها هو عمر بن لوذان يقول للإمام عليه السلام: “أنشدك بالله، يا ابن رسول الله لمّا انصرفت، فوالله ما تقدم إلا على الأسنّة وحدِّ السيوف”.
هذا هو حال مجتمع السنوات العشرين الذي تسلَّط عليه معاوية وعايشه الإمام الحسين عليه السلام.
إنه مجتمع مضلّل، مخدّر، مفرّق، خائف، في الوقت الذي يتعرَّض فيه الإسلام لأعنف حرب ثقافية تستهدف مضمونه الأصيل، دون أن يحرِّك أحدٌ ساكناً، والسبب هو إغلاق العقول والقلوب.
إغلاق للعقول نتيجة التضليل والتخدير.
وإغلاق للقلوب نتيجة الخوف والرعب.
رأى الإمام الحسين عليه السلام الخطر العظيم على دين الله ورسالته الخالدة، وعَلِمَ أنَّ فتح العقول والقلوب لن يتمّ من خلال خطابات ومحاضرات وكلمات ومواعظ، بل لا بد لتحقيق هذا الفتح- إضافة إلى قوة الأطروحة ومصداقية صاحبها- من التضحية بالأعزّ، التضحية بالنفس وبأهل البيت وبالأصحاب، لا بد من تقديم ذلك كله مع دموع اليتامى، وسبي النساء في مسار المذبح الإلهي المقدّس.
واستطاع الإمام الحسين عليه السلام من خلال ذلك ومن دون نصرٍ عسكري، أن يحقِّق الفَتْح الثاني لعقول الأمة وقلوبها، وبالتالي استطاع كما عبّر عنه حفيده الإمام الخميني قدس سره أن يولد الإسلام ولادة ثانية، ليحقق بذلك المغزى العميق لمقولة جدِّه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيه: “حسين مني وأنا من حسين”.
لعلّ أروع ما يعبِّر عن تطبيق عملي لمقولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو جواب الإمام زين العابدين عليه السلام لذلك الرجل الذي سأل الإمام عليه السلام عمّن انتصر في كربلاء. فأجابه عليه السلام بأنّ علامة الجواب الصحيح هي أذان المسلمين، فحينما يقول المؤذِّن: أشهد أنّ محمداً رسول الله، يُعرف من انتصر في كربلاء.
إنه ليس انتصاراً عسكرياً، بل هو فتح لولاه لما بقي الإسلام.
هو فتح يَدين له كلُّ خير في الإسلام حصل بعده.
هو فتح يرجع إليه كلُّ فضل في الإسلام، حدث بعده.
هو فتح أسّس لجهاد المجاهدين، وشهادة الشهداء بعده.
هو فتح يعود بسببه إلى الفاتحين الك