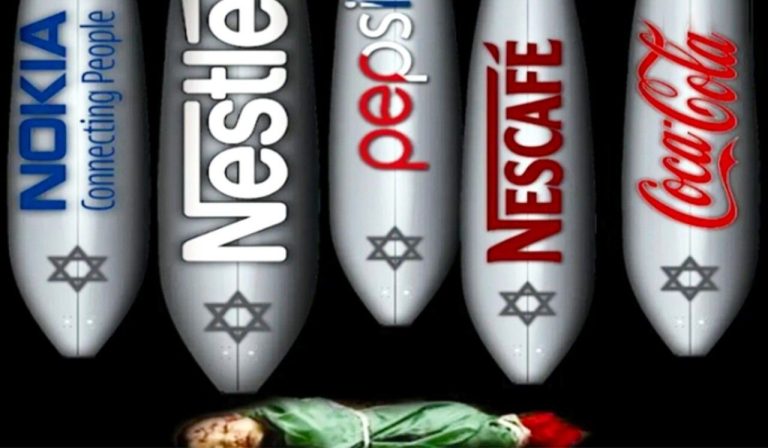.رُويَ عنْ فاطمةَ (صلواتُ اللهِ عليها) أنَّها قالت: «مَنْ أصعَدَ إلى اللهِ خالصَ عبادتِه، أهبطَ اللهُ [إليهِ] أفضلَ مصلحتِه»[1].
الإخلاصُ هو صدقُ العبدِ في توجُّهِهِ إلى اللهِ اعتقاداً وعملاً. وذلك مِن خلالِ تجريدِ القَصْدِ والفعلِ مِن كلِّ شائبةٍ وغايةٍ سوى اللهِ عزَّ وجلَّ، قالَ تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِين لَهُ الدّين﴾[2]. وفي حديثٍ للإمامِ الباقرِ (عليه السلام) يشرحُ حقيقةَ الإخلاصِ بالانقطاعِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ: «لا يكونُ العبدُ عابداً للهِ حقَّ عبادتِه حتّى ينقطعَ عَنِ الخَلقِ كلِّه إليه، فحينئذٍ يقول: هذا خالصٌ لي، فيتقبَّلُهُ بكرمِه»[3].
وطريقُ الوصولِ إلى حالةِ الإخلاصِ هو المعرفة، وذلكَ بأنْ يتحلَّى الإنسانُ باليقينِ بأنَّ الأمورَ كلَّها بيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فعنْ أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام): «الإخلاصُ ثمرةُ اليقين»[4]؛ وأنْ يعلمَ أنَّ أحداً مِنَ الناسِ لا يملكُ مِنْ أمرِهِ شيئاً، فعنْ أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام): «أوَّلُ الإخلاصِ اليأسُ ممّا في أيدي الناس»[5].
ومتى حضرَ في بالِ الإنسانِ دائماً أنَّ مردَّ الأمورِ كلِّها إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، أدركَ أنَّ عليهِ أنْ لا يُشرِكَ بِهِ أحداً في عملٍ أو عبادة، فعنِ الإمامِ الباقرِ (عليه السلام): «ما بينَ الحقِّ والباطِلِ إلّا قِلَّةُ العَقلِ. قيلَ: وكيفَ ذلكَ يابنَ رسولِ اللَّهِ؟ قال: إنَّ العَبدَ يَعمَلُ العَمَلَ الّذي هُو للَّهِ رِضاً، فيريدُ بهِ غَيرَ اللَّهِ، فلَو أنَّهُ أخْلَصَ للَّهِ، لَجاءَهُ الّذي يريدُ في أسْرَعَ مِن ذلكَ»[6].
كما ينبغي للعاملِ أنْ يلتفتَ إلى مخاطرِ الرياء، وهو الصفةُ المضادَّةُ للإخلاص، فالرياءُ مِنْ مبطلاتِ الأعمال والأجرِ والثواب، ففي الروايةِ عنْ رسولِ اللهِ (صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم): «إنَّ المَلَكَ لَيَصعَدُ بعَملِ العَبدِ مُبتَهِجاً بهِ، فإذا صَعِدَ بحَسَناتِهِ، يقولُ اللَّهُ عزَّ وجلّ: اجعَلُوها في سِجِّينٍ، إنّهُ لَيسَ إيّايَ أرادَ بِها»[7].
ولهذا الإخلاصِ علامةٌ في العمل، وهي الّتي دلَّنا عليها أميرُ المؤمنينَ (عليه السلام) بقولِه: «مَنْ لَم يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وعَلانِيَتُهُ، وفِعلُهُ ومَقالَتُهُ، فقد أدّى الأمانَةَ وأخْلَصَ العِبادَةَ»[8].
يقولُ الإمامُ الخمينيُّ (قُدِّسَ سرُّه): «النيّةُ عبارةٌ عَنِ الإرادةِ الباعثةِ نحوَ العمل، … فمَنْ لهُ حبُّ الجاهِ والرياسة، وغدا هذا الحبُّ مَلَكةً نفسانيّةً وشاكلةَ روحِه. كان منتهى أملِه البلوغَ إلى سدَّةِ الزعامة. وكانتْ أفعالُه الصادرةُ عنه تابعةً لتلكَ الغاية، وكانَ دافعُه ومحرِّكُه هو مبتغاهُ النفسيَّ المذكور. وصدرتْ عنه أعمالُه للوصولِ إلى ذلكَ المطلوب. فما دامَ هذا الحبُّ في قلبِه، لا يمكنُ أنْ يصيرَ عملُهُ خالصاً».
وفي كلامٍ آخرَ لهُ (قُدِّسَ سرُّه) يقول: «إلهي …! أيقِظْنَا مِنْ سكرِ غرورِ الدنيا. مِنَ النومِ العميقِ الّذي غمرَنَا جرّاءَ الانغماسِ في عالمِ المادّةِ والطبيعة. ومزِّقْ لنا بإشارةٍ واحدةٍ الحُجُبَ الغليظةَ والستائرَ السميكةَ مِنَ الإعجابِ والذاتيّة. وخذْ بأيدِينا إلى مجلسِ الطاهرينَ لدى ساحتِك، ومَحْفِلِ المخلصينَ المقدَّسين، وأبعِدْ عنّا شراسةَ الطبيعة، وسوءَ الخُلُق، وغِلظَ اللسان، والنفاقَ والانحراف، وأقرِنْ حركاتِنا وسكناتِنا. وأفعالَنا وأعمالَنا. وأوَّلَنا وآخرَنا. وظاهرَنا وباطنَنا بالإخلاصِ والصفاء».
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين
[1] الإمام الحسن العسكريّ (عليه السلام)، تفسير الإمام الحسن العسكريّ (منسوب)، ص327.
[2] سورة البيّنة، الآية 5.
[3] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، ج67، ص198.
[4] الليثيّ الواسطيّ، عيون الحكم والمواعظ، ص23.
[5] المصدر نفسه، ص124.
[6] أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ، المحاسن، ج1، ص254.
[7] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2 ، ص295.
[8] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص382، الكتاب 26.