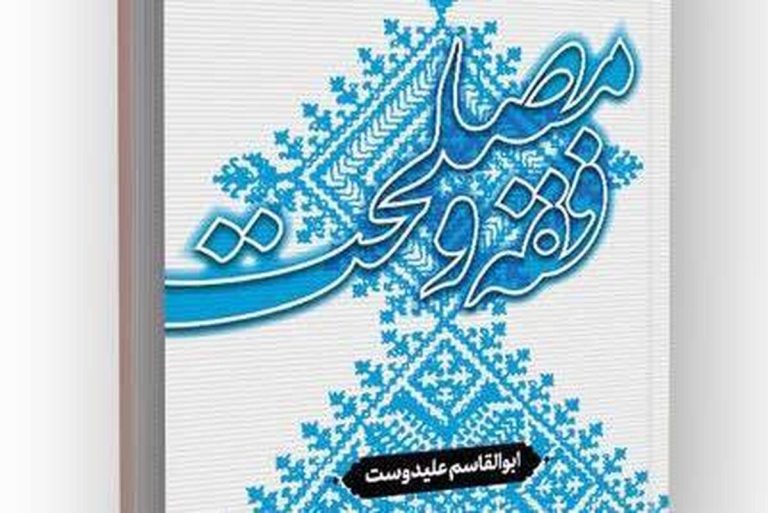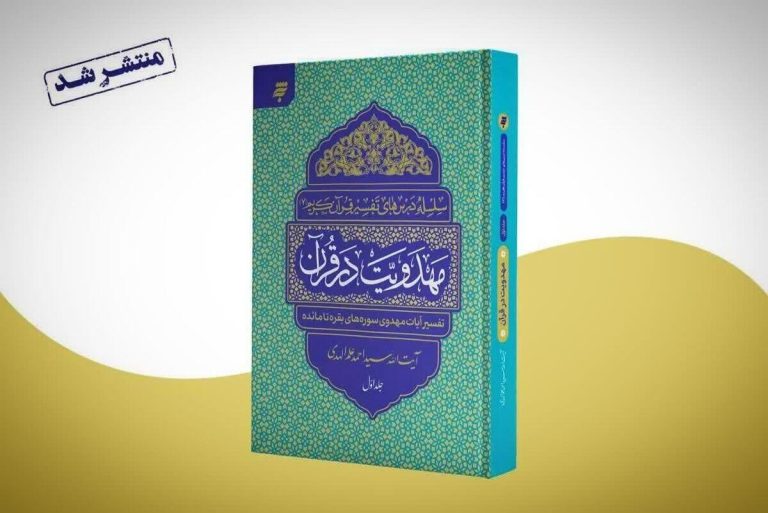في عام 1966 – أي قبل نحو خمسين عامًا – تنبأ العالم الأنثروبولوجي المعروف أنثوني وولس- بلغة واثقة- بزوال الدين في طور التقدُّم العلمي المستمر، “الإيمان بقوى ما وراء الطبيعة محكوم عليه بالموت في العالم، في ظل تقدم المعرفة العلمية وانتشارها”. ولم تكن رؤية وولس أمرًا شاذًّا أو مستغربًا؛ فالعلوم الاجتماعية التي استبانت ملامحها في القرن العشرين في غرب أوروبا اتخذت من التجربة التاريخية لشعوبها مع العلمنة نموذجًا عالميًّا. فثمة دعوى في صلب العلوم الاجتماعية تفترض أو تتنبأ بأن جميع الثقافات سينتهي بها المطاف إلى حالة من العلمنة الغربية والديمقراطية الليبرالية، ولكن شيئًا يقترب أن يكون نقيضًا لهذه الفرضية هو ما حدث. لم تفشل العلمانية في مواصلة تمددها العالمي فحسب، بل إن دولًا متفرقة كإيران والهند وإسرائيل والجزائر وتركيا استبدلت حكوماتها العلمانية بأخرى دينية، وشهدت تقدمًا مؤثرًا للحركات الدينية الوطنية فيها، وعليه فإن العلمنة التي تنبأت بها العلوم الاجتماعية قد فشلت.
نسبة الملحدين في الولايات المتحدة اليوم تسجل رقمًا قياسيًّا في تاريخ الولايات المتحدة بواقع ما يقارب 3% من السكان.
وعلى كل حال فهذا الفشل ليس مطلقًا، فكثير من الدول الغربية مستمرة في شهود تراجع في المعتقدات والممارسات الدينية، فعلى سبيل المثال نجد أن آخر بيانات التعداد السكاني في أستراليا تُظهر أن ثلاثين بالمائة من السكان يعرّفون أنفسهم على أنهم “من غير دين” وهذه النسبة في صعود، ومن ناحية أخرى فإن الاستطلاعات العالمية تؤكد أنه ثمة مستويات منخفضة نسبيًّا في الالتزام الديني في دول الغرب وأستراليا؛ حتى الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعُدُّ نموذجًا لاعتناق أطروحة العلمنة لوقت طويل، شهدت ارتفاعًا في نسَبِ الإلحاد، فنسبة الملحدين في الولايات المتحدة اليوم تسجل رقمًا قياسيًّا في تاريخ الولايات المتحدة بواقع ما يقارب 3% من السكان.

وبعد كل هذا فبالنظر إلى العالم ككل يبقى عدد من يعتقدون أنهم متدينون أعلى، كما أن التيارات السكانية تُشير إلى أن النمط العام في المستقبل القريب سيكون نموًّا دينيًّا. بيد أنه ليس هذا الفشل الوحيد الذي تعاني منه أطروحة العلمنة؛ فالعلماء والمثقفون وعلماء الاجتماع توقعوا أن انتشار العلوم الحديثة سيقود إلى العلمنة بطبيعة الحال، حيث يكون العلم أداة للعلمنة، ولكن الواقع يقول غير هذا، فبنظرنا إلى المجتمعات التي يكون الدين فيها حاضرًا وحيويًّا، نجد أن السمات الرئيسة المشتركة بينها لا تتعلق بالعلم بقدر تعلقها بالشعور بالأمان الوجودي والحماية من بعض المهددات للمصالح العامة.
ولشبكة الأمان الاجتماعي ارتباطٌ بالتقدم العلمي ولكنه ارتباط بعيد، ونجد في النموذج الأمريكي مثالًا ذا دلالة، فمجتمع الولايات المتحدة الأمريكية يعدُّ من أكثر المجتمعات تقدمًا على الصعيدين العلمي والتقني، ومع ذلك نجده أكثر المجتمعات الغربية تدينًا. وننقل هنا ما قاله عالم الاجتماع البريطاني ديفيد مارتن في كتابه “مستقبل المسيحية”؛ حيث يخلص إلى التالي: “ليس ثمة علاقة ثابتة بين درجة التقدم العلمي وانخفاض مستوى التأثير الديني في الاعتقادات والممارسة”.
وتغدو قصة العلم والعلمنة أكثرَ جاذبية وإثارة حين ننظر إلى مجتمعات شهدت ردات فعل مميزة ضد أجندة العلمنة، فهذا جواهر لال نهرو- أول رئيس وزراء للهند- قد ناصر المثل العلمانية والعلم، وعزز مشروع التحديث بالتعليم العلمي، وكان واثقًا من أن كلًّا من رُؤى الهندوسية المتعلقة بماضي الفيدية وأحلام المسلمين بثيوقراطية إسلامية ستستسلم لحتمية المسيرة التاريخية للعلمنة، “ثمة طريق ذو مسار واحد في التاريخ” كما قال. ولكن تبع هذا التحديث ارتفاعٌ للأصوليات الإسلامية والهندوسية بشكل واضح، وتبيّن خطأ نهرو، وقد أنتج هذا الربط بين العلم وأجندة العلمنة نتيجة عكسية، حيث صار العلم ضحية هامشية في المقاومة ضد العلمنة.

مصطفى كمال أتاتورك
وتظهر تركيا مثالًا كاشفًا، فمصطفى كمال أتاتورك، وهو مؤسس الجمهورية التركية- ككثير من القوميين- كان علمانيًّا ملتزمًا، آمن أتاتورك بأن العلم قادر على تنحية الدين، وكخطوة منه لجعل تركيا في الجانب الصحيح من التاريخ- حسب اعتقاده- أعطى العلم وخاصة بيولوجيا التطور مركزًا مهمًّا في النظام التعليمي لجمهورية تركيا الوليدة. وكنتيجة لهذا صارت نظرية التطور مرتبطة بالبرنامج السياسي الخاص بأتاتورك، والمشتمل على العلمانية بطبيعة الحال. وكردة فعل أخذت الأحزاب السياسية في تركيا الساعية لمواجهة المثل العلمانية التي خلفها المؤسسون، بمهاجمة تدريس نظرية التطور، فبالنسبة لهم كانت النظرية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعلمانية المادية، وقد توّج هذا الشعور في يونيو الماضي بقرار حذف تعليم نظرية التطور من مناهج المرحلة الثانوية، ومرة ثانية راح العلم ضحية لارتباطه بالعلمانية.
خلاصة الأمر، أن علمنة العالم ليس أمرًا حتميًّا، وإن تم وحدث، فلن يكون ذلك بسبب العلم.
وتُقدِّم الولايات المتحدة سياقًا ثقافيًّا مختلفًا؛ حيث يبدو أن ثمة تعارضًا واضحًا بين القراءة الحرفية لسفر التكوين والمعالم الرئيسة لتاريخ التطور، ولكن في واقع الأمر نجد أن كثيرًا من الخَلْقيين (المؤمنين بنظرية الخلق) يتمحور خطابهم على القيم الأخلاقية، وفي ذات السياق الأمريكي نجد أن المعادين لنظرية التطور مدفوعون -ولو جزئيًّا- بكون النظرية التطورية ما هي إلا جسرٌ للمادية العلمانية والأخلاقيات الملازمة لها، وكما رأينا في حالتي تركيا والهند فإن العلمنة في الواقع تُسيء إلى العلم وتضرُّ به. وخلاصة الأمر، أن علمنة العالم ليس أمرًا حتميًّا، وإن تم وحدث، فلن يكون ذلك بسبب العلم، فقد كانت المحاولات التي تسعى إلى توظيف العلم في نشر العلمانية تخلص إلى الإضرار بالعلم، وأما الفرضية المقتضية بأن “العلم مسبب للعلمنة”، فإنها تفشل ببساطة عند اختبارها في الواقع، كما أن استخدامَ العلم كأداة للعلمنة خطة رديئة.
إن المزاوجة بين العلم والعلمانية عمل شاذٌّ يدفعنا لطرح السؤال التالي: لماذا يعتقد إنسان بنجاعة هذه المزاوجة؟
وللجواب على هذا فإننا نلجأ للتاريخ، لنجد مصدرين اثنين روَّجَا لفكرة قدرة العلم على استبدال الدين: أولهما كان في القرن التاسع عشر مع الرؤى التقدمية للتاريخ، وخاصة المرتبطة بالفيلسوف الفرنسي أوغست كونت، ونظريته التاريخية التي تقتضي أن المجتمعات تمرُّ بثلاث مراحل: المرحلة الدينية، المرحلة الميتافيزيقية، وأخيرًا المرحلة العلمية أو الوضعية. لقد قام كونت بصك مصطلح علم الاجتماع “سيسيولوجي Sociology”، وأراد أن ينهي تأثيرَ الدين على المجتمع ويستبدله بعلم الاجتماع الجديد، وامتد تأثير كونت بنظريته حتى بلغ الأتراك، فاعتنقته جماعة تركيا الفتاة وأتاتورك.
كما شهد القرن التاسع عشر بداية نموذج الصراع بين الدين والعلم، حيث انتشرت رؤيةٌ تقتضي النظر إلى التاريخ وحركته على أنه “صراع بين عصرين في تطور الفكر البشري: عصر اللاهوت، وعصر العلم”. هذا الوصف جاء من أندرو ديكسون وايت في عمله المؤثر الذي ألفه عام 1896، الموسوم بتاريخ الحرب بين العلم واللاهوت في الديانة المسيحية، وعنوان الكتاب يلخص بوضوح نظريةَ المؤلف العامة بخصوص العلم والدين.
لقد دشّن عمل وايت ومن قبله جون وليام درابر في كتابه “تاريخ الصراع بين الدين والعلم”، الذي ألفه عام 1874-نظرية الصراع لتكون المنهجية الفكرية الغالبة في دراسة العلاقة التاريخية بين العلم والدين، وقد تُرجِم الكتابان إلى لغات عدة وحققَا انتشارًا واسعًا، فكتاب درابر طُبع في الولايات المتحدة وحدَها أكثر من خمسين طبعة، وترجم إلى عشرين لغة، وأصبح الكتاب الأكثر مبيعًا في نهايات الإمبراطورية العثمانية، وقد زرع لدى أتاتورك قناعةً بكون التقدم يعني استبدالَ العلم بالدين.
أما اليوم فأصبح الناس أقلَّ ثقة بكون التاريخ يمضي خلال سلسلة من المراحل باتجاه غاية واحدة، وعلى نقيض القناعات الشعبية فإن مؤرخي العلم لا يدعمون فكرةَ الصراع الدائم بين العلم والدين. وما اشتهر من تصادم في قضية غاليليو فقد كان فيه عوامل سياسية وشخصية وليس مجرد صراع بين العلم والدين؛ فقد حظي دارون بأتباع ومؤيدين كثير من المتدينين، وبمعارضين ونقاد من العلماء، والعكس صحيح.
كما أن كثيرًا من الأمثلة على صراع الدين مع العلم تم الانتهاء مؤخرًا إلى أنها محض اختلاقات، بل على العكس من دعاية الصراع، فإن المسار التاريخي يؤكد على دعم متبادل بين العلم والدين؛ ففي القرن السابع عشر كان العلم يعتمد على الشرعية الدينية، وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ساهم اللاهوت الطبيعي في ترويج العلم وتسويقه.
إن نموذجَ الصراع بين العلم والدين يُقدم رؤيةً مغلوطة للماضي، وحين تُضم إليه آمال العلمنة فإنه يقود إلى رؤية مختلة للمستقبل، ونظرية العلمنة تفشل على المستويين الوصفي والاستشرافي.
ويبقى السؤال الواقعي: لماذا نستمر في مواجهة أنصار نظرية الصراع بين العلم والدين وكثير منهم علماء بارزون؟
ليس المجدي استحضار تهريج ريتشارد دوكينز حول هذا الموضوع، فليس هو وحده يمثل هذا الصوت، فستيفن هوكينج يعتقد بأن “العلم سينتصر لأنه فعّال”، و”سام هاريس” صرح بأنه “يجب على العلم أن يحطم الدين”، و”ستيفن واينبرغ” يعتقد أن العلمَ عمل على إضعاف اليقين الديني، كما أن كولين بليك مور يتوقع بأن العلم في المستقبل سيسلب أهمية الدين. ولكن مع كل هذا فالأدلة التاريخية لا تدعم أيًّا من هذه المزاعم، بل تؤكد على أنهم مُضلّلين. فلم إذن يصرُّون؟
والجواب أن الدافع سياسي بطبيعة الحال، لنترك كل الدواعي العاطفية للميل إلى فهم التاريخ على طريقة القرن التاسع عشر، ولننظر إلى الخوف من الأصولية الإسلامية، والحنق على نظرية الخلق، والتحالف بين اليمين المتدين وإنكار التغير المناخي، والخوف من تآكل السلطة العلمية.
إن العلم محتاج لكل الأنصار الذين يستطيع جذبهم، ليسدوا نصحية لدعاته بأن يكفوا عن اختلاق العدواة بينه وبين الدين.
وقد نتعاطف مع مخاوفهم من هذه المسائل، ولكن مع ذلك لا يمكننا إخفاء حقيقة أن هذه إقحامات يائسة على معايير الموضوعية في النقاش، هذا التفكير الرغبوي- التأميل على أن العلم سيقضي على الدين- لا يمكن أن يكون بديلًا لتقويم الواقع الحالي، كما أن الاستمرار في هذه الدعاية سيولّد نتائج عكسية. لن يزول الدين في أي وقت قريب، ولن يقدر العلم على تحطيمه، وإن كان ثمة قلق، فسيكون على سلطة العلم في المجتمع وشرعيته مع استمرار هذه الدعاية. إن العلم محتاج لكل الأنصار الذين يستطيع جذبهم، ليسدوا نصيحة لدعاته بأن يكفوا عن اختلاق العداوة بينه وبين الدين، أو الإصرار على أن الطريق لمستقبل آمن يقع في المواءمة بين العلم والعلمانية.