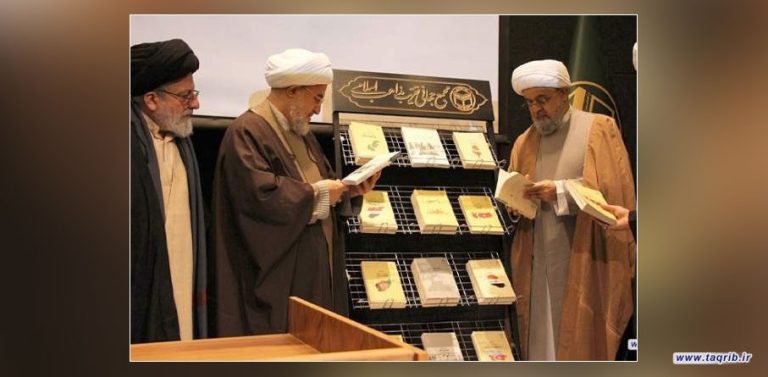شرح وتفسير الآية 255 من سورة البقرة من كتاب تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى.
سورة البقرة – 255
اللّهُ لا إِلَهَ إِلا هُو الْحَىّ الْقَيّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ لّهُ مَا فى السمَوَتِ ومَا فى الأَرْضِ مَن ذَا الّذِى يَشفَعُ عِندَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَينَ أَيْدِيهِمْ ومَا خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطونَ بِشىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شاءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السمَوَتِ والأَرْض ولا يَئُودُهُ حِفْظهُمَا وهُو الْعَلىّ الْعَظِيمُ (255)
بيان
قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قد تقدم في سورة الحمد بعض الكلام في لفظ الجلالة، وأنه سواء أخذ من أله الرجل بمعنى تاه ووله أومن أله بمعنى عبد فلازم معناه الذات المستجمع لجميع صفات الكمال على سبيل التلميح.
وقد تقدم بعض الكلام في قوله تعالى: لا إله إلا هو، في قوله تعالى: “وإلهكم إله واحد:” البقرة – 163، وضمير هو وإن رجع إلى اسم الجلالة لكن اسم الجلالة لما كان علما بالغلبة يدل على نفس الذات من حيث إنه ذات وإن كان مشتملا على بعض المعاني الوصفية التي يلمح باللام أو بالإطلاق إليها، فقوله: لا إله إلا هو، يدل على نفي حق الثبوت عن الآلهة التي تثبت من دون الله.
وأما اسم الحي فمعناه ذو الحياة الثابتة على وزان سائر الصفات المشبهة في دلالتها على الدوام والثبات.
والناس في بادئ مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين: قسم منها لا يختلف حاله عند الحس ما دام وجوده ثابتا كالأحجار وسائر الجمادات، وقسم منها ربما تغيرت حاله وتعطلت قواه وأفعاله مع بقاء وجودها على ما كان عليه عند الحس، وذلك كالإنسان وسائر أقسام الحيوان والنبات فإنا ربما نجدها تعطلت قواها ومشاعرها وأفعالها ثم يطرأ عليها الفساد تدريجا، وبذلك أذعن الإنسان بأن هناك وراء الحواس أمرا آخر هو المبدأ للإحساسات والإدراكات العلمية والأفعال المبتنية على العلم والإرادة وهو المسمى بالحياة ويسمى بطلانه بالموت، فالحياة نحو وجود يترشح عنه العلم والقدرة.
وقد ذكر الله سبحانه هذه الحياة في كلامه ذكر تقرير لها، قال تعالى: “اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها:” الحديد – 17، وقال تعالى: “إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى:” فصلت – 39، وقال تعالى: “وما يستوي الأحياء ولا الأموات:” الفاطر – 22، وقال تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي:” الأنبياء – 30، فهذه تشمل حياة أقسام الحي من الإنسان والحيوان والنبات.
وكذلك القول في أقسام الحياة، قال تعالى: “ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها”: يونس – 7، وقال تعالى: “ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين:” المؤمن – 11، والإحياءان المذكوران يشتملان على حياتين: إحداهما: الحياة البرزخية، والثانية: الحياة الآخرة، فللحياة أقسام كما للحي أقسام.
والله سبحانه مع ما يقرر هذه الحياة الدنيا يعدها في مواضع كثيرة من كلامه شيئا رديا هينا لا يعبأ بشأنه كقوله تعالى: “وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع:” الرعد – 26، وقوله تعالى: “تبتغون عرض الحياة الدنيا:” النساء – 94، وقوله تعالى: “تريد زينة الحياة الدنيا:” الكهف – 28، وقوله تعالى: “وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو:” الأنعام – 32، وقوله تعالى: “وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور:” الحديد – 20، فوصف الحياة الدنيا بهذه الأوصاف فعدها متاعا والمتاع ما يقصد لغيره، وعدها عرضا والعرض ما يتعرض ثم يزول، وعدها زينة و- الزينة – هو الجمال الذي يضم على الشيء ليقصد الشيء لأجله فيقع غير ما قصد ويقصد غير ما وقع، وعدها لهوا و- اللهو- ما يلهيك ويشغلك بنفسه عما يهمك، وعدها لعبا واللعب هو الفعل الذي يصدر لغاية خيالية لا حقيقية، وعدها متاع الغرور وهوما يغر به الإنسان.
ويفسر جميع هذه الآيات ويوضحها قوله تعالى: “وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون:” العنكبوت – 64، يبين أن الحياة الدنيا إنما تسلب عنها حقيقة الحياة أي كمالها في مقابل ما تثبت للحياة الآخرة حقيقة الحياة وكمالها، وهي الحياة التي لا موت بعدها، قال تعالى: “آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى:” الدخان – 56، وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد:” ق – 35، فلهم في حياتهم الآخرة أن لا يعتريهم الموت، ولا يعترضهم نقص في العيش وتنغص، لكن الأول من الوصفين أعني الأمن هو الخاصة الحقيقة للحياة الضرورية له.
فالحياة الأخروية هي الحياة بحسب الحقيقة لعدم إمكان طرو الموت عليها بخلاف الحياة الدنيا، لكن الله سبحانه مع ذلك أفاد في آيات أخر كثيرة أنه تعالى هو المفيض للحياة الحقيقية الأخروية والمحيي للإنسان في الآخرة، وبيده تعالى أزمة الأمور، فأفاد ذلك أن الحياة الأخروية أيضا مملوكة لا مالكة ومسخرة لا مطلقة أعني أنها إنما ملكت خاصتها المذكورة بالله لا بنفسها.
ومن هنا يظهر أن الحياة الحقيقية يجب أن تكون بحيث يستحيل طرو الموت عليها لذاتها ولا يتصور ذلك إلا بكون الحياة عين ذات الحي غير عارضة لها ولا طارئة عليها بتمليك الغير وإفاضته، قال تعالى: “وتوكل على الحي الذي لا يموت:” الفرقان – 58، وعلى هذا فالحياة الحقيقية هي الحياة الواجبة، وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدر بالذات.
ومن هنا يعلم: أن القصر في قوله تعالى: “هو الحي لا إله إلا هو” قصر حقيقي غير إضافي، وأن حقيقة الحياة التي لا يشوبها موت ولا يعتريها فناء وزوال هي حياته تعالى.
فالأوفق فيما نحن فيه من قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية، وكذا في قوله تعالى: “الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم:” آل عمران – 1 أن يكون لفظ الحي خبرا بعد خبر فيفيد الحصر لأن التقدير، الله الحي فالآية تفيد أن الحياة لله محضا إلا ما أفاضه لغيره.
وأما اسم القيوم فهو على ما قيل: فيعول كالقيام فيعال من القيام وصف يدل على المبالغة و- القيام – هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كل ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كل منها.
وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه حيث قال تعالى: “أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت:” الرعد – 33، وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة -: “شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم:” آل عمران – 18، فأفاد أنه قائم على الموجودات بالعدل فلا يعطي ولا يمنع شيئا في الوجود وليس الوجود إلا الإعطاء والمنع إلا بالعدل بإعطاء كل شيء ما يستحقه ثم بين أن هذا القيام بالعدل مقتضى اسميه الكريمين: العزيز الحكيم فبعزته يقوم على كل شيء وبحكمته يعدل فيه.
وبالجملة لما كان تعالى هو المبدئ الذي يبتدئ منه وجود كل شيء وأوصافه وآثاره لا مبدأ سواه إلا وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كل شيء من كل جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل، وليس ذلك لغيره قط إلا بإذنه بوجه، فليس له تعالى إلا القيام من غير ضعف وفتور، وليس لغيره إلا أن يقوم به، فهناك حصران: حصر القيام عليه، وحصره على القيام، وأول الحصرين هو الذي يدل عليه كون القيوم في الآية خبرا بعد خبر لله الله القيوم، والحصر الثاني هو الذي تدل عليه الجملة التالية أعني قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم.
وقد ظهر من هذا البيان أن اسم القيوم أم الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى جميعا وهي الأسماء التي تدل على معان خارجة عن الذات بوجه كالخالق والرازق والمبدئ والمعيد والمحيي والمميت والغفور والرحيم والودود وغيرها.
قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة بكسر السين الفتور الذي يأخذ الحيوان في أول النوم، والنوم هو الركود الذي يأخذ حواس الحيوان لعوامل طبيعية تحدث في بدنه، والرؤيا غيره وهي ما يشاهده النائم في منامه.
وقد أورد على قوله: سنة ولا نوم إنه على خلاف الترتيب الذي تقتضيه البلاغة فإن المقام مقام الترقي، والترقي في الإثبات إنما هومن الأضعف إلى الأقوى كقولنا: فلان يقدر على حمل عشرة أمنان بل عشرين، وفلان يجود بالمئات بل بالألوف وفي النفي بالعكس كما نقول: لا يقدر فلان على حمل عشرين ولا عشرة، ولا يجود بالألوف ولا بالمئات، فكان ينبغي أن يقال: لا تأخذه نوم ولا سنة.
والجواب: أن الترتيب المذكور لا يدور مدار الإثبات والنفي دائما كما يقال: فلان يجهده حمل عشرين بل عشرة ولا يصح العكس، بل المراد هو صحة الترقي وهي مختلفة بحسب الموارد، ولما كان أخذ النوم أقوى تأثيرا وأضر على القيومية من السنة كان مقتضى ذلك أن ينفي تأثير السنة وأخذها أولا ثم يترقى إلى نفي تأثير ما هو أقوى منه تأثيرا، ويعود معنى لا تأخذه سنة ولا نوم إلى مثل قولنا: لا يؤثر فيه هذا العامل الضعيف بالفتور في أمره ولا ما هو أقوى منه.
قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لما كانت القيومية التامة التي له تعالى لا تتم إلا بأن يملك السماوات والأرض وما فيهما بحقيقة الملك ذكره بعدهما، كما أن التوحيد التام في الألوهية لا يتم إلا بالقيومية، ولذلك ألحقها بها أيضا.
وهاتان جملتان كل واحدة منهما مقيدة أو كالمقيدة بقيد في معنى دفع الدخل، أعني قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، مع قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، مع قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
فأما قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، فقد عرفت معنى ملكه تعالى بالكسر للموجودات وملكه تعالى بالضم لها، والملك بكسر الميم وهو قيام ذوات الموجودات وما يتبعها من الأوصاف والآثار بالله سبحانه هو الذي يدل عليه قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، فالجملة تدل على ملك الذات وما يتبع الذات من نظام الآثار.
وقد تم بقوله: القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض إن السلطان المطلق في الوجود لله سبحانه لا تصرف إلا وهوله ومنه، فيقع من ذلك في الوهم أنه إذا كان الأمر على ذلك فهذه الأسباب والعلل الموجودة في العالم ما شأنها؟ وكيف يتصور فيها ومنها التأثير ولا تأثير إلا لله سبحانه؟ فأجيب بأن تصرف هذه العلل والأسباب في هذه الموجودات المعلولة توسط في التصرف، وبعبارة أخرى شفاعة في موارد المسببات بإذن الله سبحانه، فإنما هي شفعاء، والشفاعة – وهي بنحو توسط في إيصال الخير أو دفع الشر، وتصرف ما من الشفيع في أمر المستشفع – إنما تنافي السلطان الإلهي والتصرف الربوبي المطلق إذا لم ينته إلى إذن الله، ولم يعتمد على مشية الله تعالى بل كانت مستقلة غير مرتبطة وما من سبب من الأسباب ولا علة من العلل إلا وتأثيره بالله ونحو تصرفه بإذن الله، فتأثيره وتصرفه نحو من تأثيره وتصرفه تعالى فلا سلطان في الوجود إلا سلطانه ولا قيومية إلا قيوميته المطلقة عز سلطانه.
وعلى ما بيناه فالشفاعة هي التوسط المطلق في عالم الأسباب والوسائط أعم من الشفاعة التكوينية وهي توسط الأسباب في التكوين، والشفاعة التشريعية أعني التوسط في مرحلة المجازاة التي تثبتها الكتاب والسنة في يوم القيامة على ما تقدم البحث عنها في قوله تعالى: “واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا:” البقرة – 48، وذلك أن الجملة أعني قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، مسبوقة بحديث القيومية والملك المطلق الشاملين للتكوين والتشريع معا، بل المتماسين بالتكوين ظاهرا فلا موجب لتقييدهما بالقيومية والسلطنة التشريعيتين حتى يستقيم تذييل الكلام بالشفاعة المخصوصة بيوم القيامة.
فمساق هذه الآية في عموم الشفاعة مساق قوله تعالى: “إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه”: يونس – 3، وقوله تعالى: “الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع:” الم السجدة – 4، وقد عرفت في البحث عن الشفاعة أن حدها كما ينطبق على الشفاعة التشريعية كذلك ينطبق على السببية التكوينية، فكل سبب من الأسباب يشفع عند الله لمسببه بالتمسك بصفات فضله وجوده ورحمته لإيصال نعمة الوجود إلى مسببه، فنظام السببية بعينه ينطبق على نظام الشفاعة كما ينطبق على نظام الدعاء والمسألة، قال تعالى: “يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن:” الرحمن – 29، وقال تعالى: “وآتيكم من كل ما سألتموه:” إبراهيم – 34، وقد مر بيانه في تفسير قوله تعالى: “وإذا سألك عبادي عني”: البقرة – 186.
قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سياق الجملة مع مسبوقيتها بأمر الشفاعة يقرب من سياق قوله تعالى: “بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون:” الأنبياء – 28، فالظاهر أن ضمير الجمع الغائب راجع إلى الشفعاء الذي تدل عليه الجملة السابقة معنى فعلمه تعالى بما بين أيديهم وما خلفهم كناية عن كمال إحاطته بهم، فلا يقدرون بواسطة هذه الشفاعة والتوسط المأذون فيه على إنفاذ أمر لا يريده الله سبحانه ولا يرضى به في ملكه، ولا يقدر غيرهم أيضا أن يستفيد سوءا من شفاعتهم ووساطتهم فيداخل في ملكه تعالى فيفعل فيه ما لم يقدره.
وإلى نظير هذا المعنى يدل قوله تعالى: “وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا:” مريم – 64، وقوله تعالى: “عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا”: الجن – 28، فإن الآيات تبين إحاطته تعالى بالملائكة والأنبياء لئلا يقع منهم ما لم يرده، ولا يتنزلوا إلا بأمره، ولا يبلغوا إلا ما يشاؤه.
وعلى ما بيناه فالمراد بما بين أيديهم: ما هو حاضر مشهود معهم، وبما خلفهم: ما هو غائب عنهم بعيد منهم كالمستقبل من حالهم، ويؤول المعنى إلى الشهادة والغيب.
وبالجملة قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كناية عن إحاطته تعالى بما هو حاضر معهم موجود عندهم وبما هو غائب عنهم آت خلفهم، ولذلك عقبه بقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، تبيينا لتمام الإحاطة الربوبية والسلطة الإلهية أي أنه تعالى عالم محيط بهم وبعلمهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
ولا ينافي إرجاع ضمير الجمع المذكر العاقل وهو قوله “هم” في المواضع الثلاث إلى الشفعاء ما قدمناه من أن الشفاعة أعم من السببية التكوينية والتشريعية، وأن الشفعاء هم مطلق العلل والأسباب، وذلك لأن الشفاعة والوساطة والتسبيح والتحميد لما كان المعهود من حالها أنها من أعمال أرباب الشعور والعقل شاع التعبير عنها بما يخص أولي العقل من العبارة.
وعلى ذلك جرى ديدن القرآن في بياناته كقوله تعالى: “وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم:” الإسراء – 44، وقوله تعالى: “ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين”: فصلت – 11، إلى غير ذلك من الآيات.
وبالجملة قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يفيد معنى تمام التدبير وكماله، فإن من كمال التدبير أن يجهل المدبر بالفتح بما يريده المدبر بالكسر من شأنه ومستقبل أمره لئلا يحتال في التخلص عما يكرهه من أمر التدبير فيفسد على المدبر بالكسر تدبيره، كجماعة مسيرين على خلاف مشتهاهم ومرادهم فيبالغ في التعمية عليهم حتى لا يدروا من أين سيروا، وفي أين نزلوا، وإلى أين يقصد بهم.
فيبين تعالى بهذه الجملة أن التدبير له وبعلمه بروابط الأشياء التي هو الجاعل لها، وبقية الأسباب والعلل وخاصة أولوا العلم منها وإن كان لها تصرف وعلم لكن ما عندهم من العلم الذي ينتفعون به ويستفيدون منه فإنما هومن علمه تعالى وبمشيته وإرادته، فهومن شئون العلم الإلهي، وما تصرفوا به فهومن شئون التصرف الإلهي وأنحاء تدبيره، فلا يسع لمقدم منهم أن يقدم على خلاف ما يريده الله سبحانه من التدبير الجاري في مملكته إلا وهو بعض التدبير.
وفي قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، على تقدير أن يراد بالعلم المعنى المصدري أو معنى اسم المصدر لا المعلوم دلالة على أن العلم كله لله ولا يوجد من العلم عند عالم إلا وهو شيء من علمه تعالى، ونظيره ما يظهر من كلامه تعالى من اختصاص القدرة والعزة والحياة بالله تعالى، قال تعالى: “ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا:” البقرة – 165، وقال تعالى: “أ يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا:” النساء – 139، وقال تعالى: “هو الحي لا إله إلا هو“: المؤمن – 65، ويمكن أن يستدل على ما ذكرناه من انحصار العلم بالله تعالى بقوله: “إنه هو العليم الحكيم:” يوسف – 83، وقوله تعالى: “والله يعلم وأنتم لا تعلمون:” آل عمران – 66، إلى غير ذلك من الآيات، وفي تبديل العلم بالإحاطة في قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه، لطف ظاهر.
قوله تعالى: وسع كرسيه السموات والأرض، الكرسي معروف وسمي به لتراكم بعض أجزائه بالصناعة على بعض، وربما كني بالكرسي عن الملك فيقال كرسي الملك، ويراد منطقة نفوذه ومتسع قدرته.
وكيف كان فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله: له ما في السموات وما في الأرض “إلخ”، تفيد أن المراد بسعة الكرسي إحاطة مقام السلطنة الإلهية، فيتعين للكرسي من المعنى: أنه المقام الربوبي الذي يقوم به ما في السماوات والأرض من حيث إنها مملوكة مدبرة معلومة، فهومن مراتب العلم، ويتعين للسعة من المعنى: أنها حفظ كل شيء مما في السماوات والأرض بذاته وآثاره، ولذلك ذيله بقوله: ولا يؤوده حفظهما.
قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يقال: آده يؤوده أودا إذا ثقل عليه وأجهده وأتعبه، والظاهر أن مرجع الضمير في يؤوده، هو الكرسي وإن جاز رجوعه إليه تعالى، ونفي الأود والتعب عن حفظ السماوات والأرض في ذيل الكلام ليناسب ما افتتح به من نفي السنة والنوم في القيومية على ما في السماوات والأرض.
ومحصل ما تفيده الآية من المعنى: أن الله لا إله إلا هوله كل الحياة وله القيومية المطلقة من غير ضعف ولا فتور، ولذلك وقع التعليل بالاسمين الكريمين: العلي العظيم فإنه تعالى لعلوه لا تناله أيدي المخلوقات فيوجبوا بذلك ضعفا في وجوده وفتورا في أمره، ولعظمته لا يجهده كثرة الخلق ولا يطيقه عظمة السماوات والأرض، وجملة: وهو العلي العظيم، لا تخلو عن الدلالة على الحصر، وهذا الحصر إما حقيقي كما هو الحق، فإن العلو والعظمة من الكمال وحقيقة كل كمال له تعالى، وأما دعوى لمسيس الحاجة إليه في مقام التعليل ليختص العلو والعظمة به تعالى دعوى، فيسقط السماوات والأرض عن العلو والعظمة في قبال علوه وعظمته تعالى.
بحث روائي
في تفسير العياشي، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أبو ذر: يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ثم قال: وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة: أقول: وروى صدر الرواية السيوطي في الدر المنثور، عن ابن راهويه في مسنده عن عوف بن مالك عن أبي ذر، ورواه أيضا عن أحمد وابن الضريس والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي ذر.
وفي الدر المنثور، أخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة، قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي: أقول: وروي فيه هذا المعنى أيضا عن الخطيب البغدادي في تاريخه عن أنس عنه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وفيه، أيضا عن الدارمي عن أيفع بن عبد الله الكلاغي، قال: قال رجل: يا رسول الله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحديث.
أقول: تسمية هذه الآية بآية الكرسي مما قد اشتهرت في صدر الإسلام حتى في زمان حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى في لسانه كما تفيده الروايات المنقولة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) وعن الصحابة.
وليس إلا للاعتناء التام بها وتعظيم أمرها، وليس إلا لشرافة ما تدل عليه من المعنى ورقته ولطفه، وهو التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله: الله لا إله إلا هو، ومعنى القيومية المطلقة التي يرجع إليه جميع الأسماء الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مر بيانه، وتفصيل جريان القيومية في ما دق وجل من الموجودات من صدرها إلى ذيلها ببيان أن ما خرج منها من السلطنة الإلهية فهومن حيث إنه خارج منها داخل فيها، ولذلك ورد فيها أنها أعظم آية في كتاب الله، وهو كذلك من حيث اشتمالها على تفصيل البيان، فإن مثل قوله تعالى: “الله لا إله إلا هوله الأسماء الحسنى:” طه – 8، وإن اشتملت على ما تشتمل عليه آية الكرسي غير أنها مشتملة على إجمال المعنى دون تفصيله، ولذا ورد في بعض الأخبار: أن آية الكرسي سيدة آي القرآن: رواها في الدر المنثور، عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وورد في بعضها: أن لكل شيء ذروة وذروة القرآن آية الكرسي:، رواها العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام).
وفي أمالي الشيخ، بإسناده عن أبي أمامة الباهلي: أنه سمع علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أوولد في الإسلام يبيت ليلة سوادها. قلت: وما سوادها؟ قال: جميعها حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو- الحي القيوم فقرأ الآية إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما – وهو العلي العظيم. قال: فلو تعلمون ما هي أوقال: ما فيها ما تركتموها على حال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، ولم يؤتها نبي كان قبلي، قال علي فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها، الحديث.
أقول: وروي هذا المعنى في الدر المنثور، عن عبيد وابن أبي شيبة والدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس عنه (عليه السلام)، ورواه أيضا عن الديلمي عنه (عليه السلام)، والروايات من طرق الشيعة وأهل السنة في فضلها كثيرة، وقوله (عليه السلام): إن رسول الله قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش، روي في هذا المعنى أيضا في الدر المنثور، عن البخاري في تاريخه، وابن الضريس عن أنس أن النبي قال: أعطيت آية الكرسي من تحت العرش، فيه إشارة إلى كون الكرسي تحت العرش ومحاطا له وسيأتي الكلام في بيانه.
وفي الكافي، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السموات والأرض، السماوات والأرض وسعن الكرسي أو الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال (عليه السلام): إن كل شيء في الكرسي.
أقول: وهذا المعنى مروي عنهم في عدة روايات بما يقرب من هذا السؤال والجواب وهو بظاهره غريب، إذ لم يرو قراءة كرسيه بالنصب والسماوات والأرض بالرفع حتى يستصح بها هذا السؤال، والظاهر أنه مبني على ما يتوهمه الأفهام العامية أن الكرسي جسم مخصوص موضوع فوق السماوات أو السماء السابعة أعني فوق عالم الأجسام منه يصدر أحكام العالم الجسماني، فيكون السماوات والأرض وسعته إذ كان موضوعا عليها كهيئة الكرسي على الأرض، فيكون معنى السؤال أن الأنسب أن السماوات والأرض وسعت الكرسي فما معنى سعته لها؟، وقد قيل بنظير ذلك في خصوص العرش فأجيب بأن الوسعة من غير سنخ سعة بعض الأجسام لبعض… وفي المعاني، عن حفص بن الغياث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السموات والأرض، قال: علمه.
وفيه، أيضا عنه (عليه السلام): في الآية: السموات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره.
أقول: ويظهر من الروايتين: أن الكرسي من مراتب علمه تعالى كما مر استظهاره، وفي معناهما روايات أخرى.
وكذا يظهر منهما ومما سيجيء: أن في الوجود مرتبة من العلم غير محدودة أعني أن فوق هذا العالم الذي نحن من أجزائها عالما آخر موجوداتها أمور غير محدودة في وجودها بهذه الحدود الجسمانية، والتعينات الوجودية التي لوجوداتنا، وهي في عين أنها غير محدودة معلومة لله سبحانه أي أن وجودها عين العلم، كما أن الموجودات المحدودة التي في الوجود معلومة لله سبحانه في مرتبة وجودها أي أن وجودها نفس علمه تعالى بها وحضورها عنده، ولعلنا نوفق لبيان هذا العلم المسمى بالعلم الفعلي فيما سيأتي من قوله تعالى: “وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض:” يونس – 61.
وما ذكرناه من علم غير محدود هو الذي يرشد إليه قوله (عليه السلام) في الرواية، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره، ومن المعلوم أن عدم التقدير والتحديد ليس من حيث كثرة معلومات هذا العلم عددا، لاستحالة وجود عدد غير متناه، وكل عدد يدخل الوجود فهو متناه، لكونه أقل مما يزيد عليه بواحد، ولوكان عدم تناهي العلم أعني العرش لعدم تناهي معلوماته كثرة لكان الكرسي بعض العرش لكونه أيضا علما وإن كان محدودا، بل عدم التناهي والتقدير إنما هومن جهة كمال الوجود أي إن الحدود والقيود الوجودية يوجب التكثر والتميز والتمايز بين موجودات عالمنا المادي، فتوجب انقسام الأنواع بالأصناف والأفراد، والأفراد بالحالات، والإضافات غير موجودة فينطبق على قوله تعالى: “وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم:” الحجر – 21، وسيجيء تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وهذه الموجودات كما أنها معلومة بعلم غير مقدر أي موجودة في ظرف العلم وجودا غير مقدر كذلك هي معلومة بحدودها، موجودة في ظرف العلم بأقدارها وهذا هو الكرسي على ما يستظهر.
وربما لوح إليه أيضا قوله تعالى فيها: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، حيث جعل المعلوم: ما بين أيديهم وما خلفهم، وهما أعني ما بين الأيدي وما هو خلف غير مجتمع الوجود في هذا العالم المادي، فهناك مقام يجتمع فيه جميع المتفرقات الزمانية ونحوها، وليست هذه الوجودات وجودات غير متناهية الكمال غير محدودة ولا مقدرة وإلا لم يصح الاستثناء من الإحاطة في قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فلا محالة هو مقام يمكن لهم الإحاطة ببعض ما فيه، فهو مرحلة العلم بالمحدودات والمقدرات من حيث هي محدودة مقدرة والله أعلم.
وفي التوحيد، عن حنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العرش والكرسي فقال (عليه السلام) إن للعرش صفات كثيرة مختلفة له في كل سبب وصنع في القرآن صفة على حدة، فقوله: رب العرش العظيم يقول: رب الملك العظيم، وقوله: الرحمن على العرش استوى، يقول: على الملك احتوى، وهذا علم الكيفوفية في الأشياء، ثم العرش في الوصل مفرد عن الكرسي، لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعا غيبان، وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلها، والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر والحد والمشية وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات والترك وعلم العود والبدء، فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، وعلمه أغيب من علم الكرسي، فمن ذلك قال: رب العرش العظيم، أي صفته أعظم من صفة الكرسي، وهما في ذلك مقرونان: قلت: جعلت فداك فلم صار في الفضل جار الكرسي، قال (عليه السلام): إنه صار جارها لأن علم الكيفوفية فيه وفيه، الظاهر من أبواب البداء وإنيتها وحد رتقها وفتقها، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه في الظرف، وبمثل صرف العلماء، وليستدلوا على صدق دعواهما لأنه يختص برحمته من يشاء وهو القوي العزيز.
أقول: قوله (عليه السلام): لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب، قد عرفت الوجه فيه إجمالا، فمرتبة العلم المقدر المحدود أقرب إلى عالمنا الجسماني المقدر المحدود مما لا قدر له ولا حد، وسيجيء شرح فقرات الرواية في الكلام على قوله تعالى: “إن ربكم الله الذي خلق السموات:” الأعراف – 54، وقوله (عليه السلام): وبمثل صرف العلماء، إشارة إلى أن هذه الألفاظ من العرش والكرسي ونظائرها أمثال مصرفة مضروبة للناس وما يعقلها إلا العالمون.
وفي الاحتجاج، عن الامام الصادق (عليه السلام): في حديث: كل شيء خلق الله في جوف الكرسي خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به الكرسي.
أقول: وقد تقدم توضيح معناه، وهو الموافق لسائر الروايات، فما وقع في بعض الأخبار أن العرش هو العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله، والكرسي هو العلم الذي لم يطلع عليه أحدا كما رواه الصدوق عن المفضل عن الصادق (عليه السلام) كأنه من وهم الراوي بتبديل موضعي اللفظين أعني العرش والكرسي، أو أنه مطروح كالرواية المنسوبة إلى زينب العطارة.
وفي تفسير العياشي، عن الامام علي (عليه السلام) قال: إن السماء والأرض وما بينهما من خلق مخلوق في جوف الكرسي، وله أربعة أملاك يحملونه بأمر الله، أقول: ورواه الصدوق عن الأصبغ بن نباتة عنه (عليه السلام)، ولم يروعنهم (عليهم السلام) للكرسي حملة إلا في هذه الرواية، بل الأخبار إنما تثبت الحملة للعرش وفقا لكتاب الله تعالى كما قال: “الذين يحملون العرش ومن حوله الآية:” المؤمن – 7، وقال تعالى، “ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية:” الحاقة – 17، ويمكن أن يصحح الخبر بأن الكرسي – كما سيجيء بيانه – يتحد مع العرش بوجه اتحاد ظاهر الشيء بباطنه.
وبذلك يصح عد حملة أحدهما حملة للآخر.
وفي تفسير العياشي، أيضا عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال: نحن أولئك الشافعون.
أقول: ورواه البرقي أيضا في المحاسن، وقد عرفت أن الشفاعة في الآية مطلقة تشمل الشفاعة التكوينية والتشريعية معا، فتشمل شفاعتهم (عليهم السلام)، فالرواية من باب الجري.