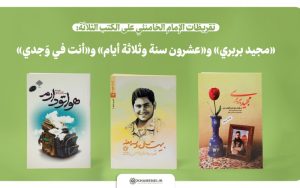الأمل في الثواب الإلهي والأمن من غضب الباري، عزّ وجل
بسم الله الرحمن الرحيم،
«يَا مَنْ أَرْجُوهُ لِكُلِّ خَيْرٍ»، أي يا من أعقد الأمل عليه إذا صدر عنّي عملٌ خيّر، أي إنّني آمل في ثوابه. مهما كان عمل الخير الذي تفعلونه، فأنتم تأملون أن يثيبكم الله المتعالي عليه. لكن في المقابل: «وَآمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ»، أي ترون أنفسكم في مأمن من غضب الله رغم أعمال الشرّ التي تصدر عنكم. إذا وجد الإنسان نفسه غير آمن من غضب الله، فلن يقدم على العمل السيّئ.
أيْ مثلاً: يستغيب ويتكلّم بسوء ويكذب لكنّه يرى نفسه في مأمن من غضب الله. «وَآمَنُ سَخَطَهُ»، أي أشعر بالأمان. «آمَنُ» أي أشعر بالأمان من سخطه وغضبه. «عِنْدَ كُلِّ شَرٍّ»، عند ارتكاب أيّ عمل سيّئ وقبيح.
أي عند كلّ عمل سوء أفعله وكلّ قبيح يصدر عنّي. لاحظوا! هكذا الحال: نحن نأمل أن يساعدنا الله في أيّ عمل خير نفعله وأن يتقبّله منّا ويثيبنا عليه ويحتسبه لنا. [مثلاً] عندما نصلّي ركعتين ونعتكف ونصوم ونتصدّق بمال، نأمل عند كلّ هذه الأعمال أن يمنّ الله علينا بفضله. حسناً، أنتم الذين تتأمّلون وتتوقّعون وترجون اللطف والمحبّة من الله بسبب أعمالكم الحسنة فلتشعروا بالخوف من غضبه أيضاً بسبب أعمالكم السيئة! لكنّكم لا تشعرون به. التفتوا! هذا يثبت كم أنّ علاقتنا مع الله المتعالي علاقة عبد يتدلل ويتغنج أمامه!
إذ نتوقّع منه أن ينظر إلى أعمالنا الحسنة. التفتوا! [لكننا] نرغب في ألّا يرى الأعمال السيئة وأن يغض الطرف عنها. إنّ علاقتنا مع الله هي علاقة مع مولى كريم ومتفضل وجواد، وبثّت في قلوبنا مثل هذا الأمل من أجل أعمالنا الحسنة، وكوّنت مثل هذا الأمان حيال أعمالنا السيئة، أي لكثرة الأعمال السيّئة التي ارتكبناها ولم يغضب علينا، بتنا مطمئنّين إلى أنّنا سنكون في مأمن من غضبه [لو] عملنا عملاً سيّئاً. علاقتنا بالله هي علاقة الكرم الوفير واللطف الغزير من الله المتعالي في حقّنا. هذا المقطع الأول.
الثواب الإلهيّ العظيم مقابل الأعمال الصغيرة للعباد
«يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ»، هذه أيضاً توحي بالمضمون نفسه، [أي] يا من تُعطي الثواب العظيم على العمل الصغير! خذوا مثالاً ما نفعله في سبيل الله، وبذلنا وسعينا. حسناً، هذه كلّها ليس لها أهميّة. ما أهميّتها مقابل النعم الإلهيّة؟ لكن، ما الذي يُعطينا الله إيّاه مقابلها؟ الجنّة ورضاه، أي النّعم الأخرويّة، وهي كبيرة جدّاً. هذا ما ينطوي على أهميّة كُبرى. «يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِيلِ»، عطاؤه كثيرٌ مقابل عملنا القليل. هذا المقطع الثاني.
الكرم والعطاء الإلهيّ تجاه سؤال الإنسان
ينطوي المقطع الثالث على هذا المضمون ومرة أخرى يشير إلى المولى اللطيف فيُظهر الربوبيّة المصحوبة بالكرم. «يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأَلَهُ»، [أي] يُعطي كلّ مَن يطلب منه شيئاً. هذه حقيقة، فلتعلموا أنّ الإنسان [لو] طلب شيئاً من الله، فإنّ الله سيمنحه إيّاه. وعندما ترون أنّ الدعاء لا يُستجاب، فإمّا أنكم لم تطلبوا بطريقة صحيحة، وإما أن هناك مصلحة أو عائقاً كبيراً، وإما أنّه يتعارض مع سنن الخلق [لأنّها] لا تجعل أيّ دعاء مستجاباً ولا تسمح بتلبية أيّ رغبة لدى الإنسان. لكن لو لم تكن هذه العوائق، فإنّ الله المتعالي سوف يلبّي أيّ طلب لكم. هذا في ما يرتبط بالمقطع الثالث: الله يُعطيكم كلّ ما تطلبونه.
العطاء الإلهي دون أن يطلب الإنسان أو أن يكون على معرفة بالباري
الرابع في مرتبة أعلى من سابقاته: «يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ»، فالله يُعطي أيضاً من لم يسأله. مثل مَن؟ مثلكم حين كنتم أطفالاً. ما الذي طلبتموه من الله؟ هل طلبتم النَفَس؟ هل طلبتم الرّوح؟ هل طلبتم البنية؟ هل طلبتم معدة قويّة ورئة نشيطة؟ لقد منّ الله عليكم بهذه [كلّها]. هل أنتم طلبتموها من الله، أو هو أعطاكم إياها دون أن تطلبوها؟ أنتم لم تطلبوا واحداً بالألف ممّا لديكم. لم تطلبوا من الله واحداً بالمليون مما لديكم. لكنّ الله منّ به عليكم. إذاً، [هذه هي] «يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ لَمْ يَسْأَلْهُ». «وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ»، حتّى أنّه يُعطي مَن لم يعرف الله أصلاً، لأنّ هذه النعم كلّها في حياتنا ملكٌ لله.
حسناً من أين ينشأ هذا التفضّل والألطاف والعطف كلّه من الله المتعالي؟ من هنا: «تَحَنُّناً مِنْهُ»، والتحنّن يعني الشعور بالرعاية، والحنان يعني اللطف والقرب والاعتناء بشيء أو شخص ما بسبب لطفه بكم واهتمامه بكم. «وَرَحْمَةً»[1]، للرحمة التي يودّ أن يشملكم بها. خلق الله المتعالي البشر جميعاً من أجل هذا الأمر، {وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} (هود، 119). خلقة البشر هي من أجل أن يعطيهم الرّحمة.
حسناً، هذا توصيف لما بيننا وبين الله. لاحظوا كيف أنّ ذاك الذي يَنْظم الدعاء – هو إمامٌ ويجيد كيفيّة التحدّث إلى الله – يَنْظمه بذكاء. إلى هذا المقطع، يجري الحديث عن علاقتنا بالله. نحن [من هذه الناحية] تائهون ومشوّشون وجاهلون وعديمو إرادة ومروءة ومراعاة، وهو من الناحية المقابلة أهل الرحمة والتفضّل والعطف والعطاء.
طلب إعطاء الخيرات جميعها ودفع الباري شرور الدنيا والآخرة
حسناً، الآن بما أن الأمور صارت على هذا النحو، نطلب درجة أعلى من ذلك. ولأنّ الله المتعالي كريمٌ إلى هذا الحدّ لا بدّ أن نطلب منه. ما الذي نطلبه؟ «أَعْطِنِي»، إلهي أعطني لأنّني لم أعد ممن لا يطلبون منك. [طبعاً] أنت أعطيتني الكثير دون أن أطلب لكنّني الآن أطلب منك. «أَعْطِنِي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ»، أي أعطني من أجل السؤال والطلب الذي أطلبه منك. «جَمِيعَ خَيْرِ الدُّنْيَا، وَجَمِيعَ خَيْرِ الْآخِرَةِ»، أعطني الخيرات كلّها في الدنيا والآخرة. نحن نطلب هذا من الله ونأمل أن يمنّ به علينا. لماذا؟ لأنّنا وصّفنا الله بهذا النحو في بداية الدعاء.
ولا نكتفي بذاك أيضاً، بل نقول: «وَاصْرِفْ عَنِّي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ»، مرّة أخرى من أجل سؤالي منك – السؤال يعني الطلب ويأتي هنا بهذا المعنى –، من أجل الطلب الذي أطلبه منك، أبعد واصرف عنّي، أيّ شيء؟ «جَمِيعَ شَرِّ الدُّنْيَا وَشَرِّ الْآخِرَةِ»، أي الشرور كلّها في الدنيا والآخرة. لماذا نطلب من الله ما هو بهذه السعة واللامحدوديّة؟ حسناً، «الحجارة والعصافير كلاهما بالمجان»![2] ونحن نريد الآن، والله المتعالي سوف يعطينا كلّ شيء من هذا لا يكون متعارضاً مع مصلحتنا بل متوافقاً مع المصلحة الإلهيّة.
الكمال في العطاء الإلهي
لماذا نطلب من الله بهذه السَعة كلّها؟ «فإنه غير منقوص ما أعطيت»، لأنّه لا يوجد نقصٌ في ما تُعطيه. فهذه العوالم كلّها هي في نظر خالقِها والمؤثّر فيها مثل حبّة حصاة، وفي نظري ونظركم يبدو ألف تومان أكثر من مئة مثلاً – نحن كذلك – لكن افترضوا أن ذاك يملك المليارات من الأموال وهو يصنع المليارات. أصلاً لا يعود هناك فرقٌ بالنسبة إليه بين الألف والمئة. لا فرق بين مئة تومان وألف وعشرة آلاف؛ «فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ».
الابتعاد عن نيران جهنّم أهمّ طلب
حسناً، وصل دعاؤكم هنا، ثمّ يصل إلى ذلك المقطع الأكثر روحانيّة وروحيّة وهو ما كان المعتدّ به في غالبية أدعيتنا والأهمّ في كثير منها، أي النجاة من نار جهنّم. يقول الإمام الحسين (ع) في آخر «دعاء عرفة» [ما مضمونه] أن يا إلهي لديّ حاجة إذا قضيتها لي، فسأكون منتفعاً حتى إن لم تعطني هذه الحاجات كلّها التي طلبتها من أوّل الدعاء إلى الآن، وإذا منحتني تلك الحاجات كلّها ومنعت عنّي هذه.
فسأكون كأنّي لم أحصل على أيّ شيء.[3] ما هي؟ أن تشملني مغفرتك ولا يمسّني عذابك. الحال هنا كذلك، فالآن بما أنّنا طلبنا منك الخيرات كلّها وأعطيتنا إيّاها حتى دون أن نطلب، «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا ذَا النَّعْمَاءِ وَالْجُودِ، يَا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ، حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ»، يا صاحب الجلال والإكرام والمنّ – ليس بمعنى التفضّل بل يعني ذاك الشيء الذي يُمكن أن يصير مدعاة للمنّة أي النعمة واللطف، و«الطَّوْلِ»
أيضاً يعني الكرم وَجُود الكريم على إنسان ما – أي يا من تملك النعمة والجود والكرم، «حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ». الدعاء المهمّ هو أن تحرّم شيبتي – لحيتي البيضاء – هذه على النار. حسناً، أنتم لِحاكم ليست بيضاء، والسيّدات لا لحى لهنّ، ويمكنكم القول: حَرِّم وَجهي عَلَى النّار. فلتعلموا أن لا مشكلة في هذا الأمر. لأنّ الإمام [الصادق (ع)] حين كان يقول لذاك الشخص [هذا الدعاء] أمسك بلحيته وكانت بيضاء وقال لله المتعالي: «حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ». «الشيبة» هي اللحية البيضاء، أي لحانا. وليقل ذوو اللحى البيضاء: «حَرِّمْ شَيْبَتِي» فلا مشكلة في ذلك.
أهميّة التضرّع وإبراز المسكنة في الدعاء
أنتم ذوو اللحى السوداء، أو النساء اللواتي لا لحية لهنّ، يمكنكم القول: حَرِّم وَجهي عَلَى النّار. فليمسكوا بمحاسنهم أو ذقونهم لأنّ هذا الإمساك بالذقن أو اللحية نوعٌ من أنواع الطلب، وأنتم تقولون أحياناً بالفارسيّة: «افعل لي كذا» [ثمّ] يمسك المرء بذقنه؛ هذا تعبيرٌ عن الطلب.
هو رائج لدى المشهديّين ولا أعلم هل هو في مكان آخر أم لا. يقولون: «بنخوتك يا سيد»، فيمسك ذقنه من أجل رغبته في أمر معيّن أو العكس أو عندما يريد أن يترجّى. هذا هو العمل نفسه: حين تُمسكون بلحاكم تفعلون العمل نفسه، أي تقولون: إلهي، أرجوك، «حَرِّمْ شَيْبَتِي عَلَى النَّارِ»[4]. إذاً، أنتم ذوو اللحى السوداء تعبّرون بالقول: لحيتي هذه السوداء، أو السيّدات ممن ليست لديهنّ لحى يعبّرن بالقول: حرّم وجهي هذا على النار، أي لا تُلقني في النار.
إذن، هل من الأفضل أن يقرأ الإنسان الدعاء على هذا النحو، أو العكس، أي دون أن يفهمه؟ يصير الأمر كأنّما يكرّر كلمات بلا معنى، وهذا [بلا فائدة]. طبعاً إذا كان عندئذ ملتفتاً إلى أنّه يخاطب الله.
فلن يكون الأمر بلا فائدة، لكن تختلف الحال كثيراً حين يدرك الإنسان المعنى. حركة إصبع السبّابة تلك هي أيضاً في مقام التضرّع فهذا [العمل] كان رائجاً في ذلك الزمان، وإذا لم تحرّكوها، فلا مشكلة ولا ضير، لأنّ هذا العمل ليس رائجاً عندنا. في ذلك الزمان، كان هذا ناشئاً من إظهار الحبّ والتودد والمسكنة.
[1] بحار الأنوار، ج. 95، ص. 390.
[2] يعني سماحته أنها ضربة ربما تصيب وربما لا لكنها دون خسارة.
[3] بحار الأنوار، ج. 95، ص. 232.
[4] بحار الأنوار، ج. 95، ص. 390.