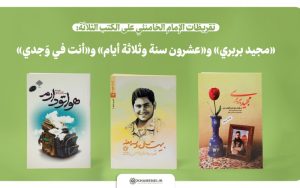الحسين أحمد كريمو
18 / 2 / 2023م، و 27 رجب الأصب 1444ه
في شهر رجب الأصب في تلك السنة الخيِّرة وبعد أن أكمل الحبيب المصطفى الأربعين من عمره الشريف. وحيث كان يتحنَّف في غار حِراء في أعلى جبل حِراء. ولم يكن معه إلا فتاه علي بن أبي طالب (ع) يتبعه ويقتفي أثره ويفعل ما يراه يفعله تماماً دون زيادة أو نقصان. فهو الذي يصف لنا حالهما في قاصعته المشهورة حيث يقول: (وَلَقَدْ قَرَنَ اَللَّهُ بِهِ (صلى الله عليه وآله) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ اَلْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخْلاَقِ اَلْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ، وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ اِتِّبَاعَ اَلْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلاَقِهِ، عَلَماً وَيَأْمُرُنِي بِالاِقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ وَلاَ يَرَاهُ غَيْرِي وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي اَلْإِسْلاَمِ غَيْرَ رَسُولِ اَللَّهِ (صلى الله عليه وآله) وَخَدِيجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا أَرَى نُورَ اَلْوَحْيِ وَاَلرِّسَالَةِ وَأَشُمُّ رِيحَ اَلنُّبُوَّةِ). (نهج البلاغة: خ 192)
رسول الله (ص) عظيم
فرسول الله (ص) عظيم منذ أن ولد لأن الله سبحانه كان يُربيه على عينه. كما صنع موسى بن عمران على عينه، ولم يتركه للجاهلية القرشية وما فيها من أهواء، وشهوات، ورذائل. بل قرن به منذ أن كان فطيماً أعظم ملك من ملائكة الرحمن ليسلك به طريق المكارم. ويعلمه الفضائل، ومحاسن أخلاق الأمم في ليله ونهاره، ولم يغادره إلى أن كمَل واستحكمت به تلك الخِصال وصارت فيه طبيعة، وسجية، وملكة، تصدر منه صدور الشعاع من الشمس. أو الماء من الينبوع الزلال ليروي بها البشر وكان أول المتلقِين لذلك كله تلميذه، وربيبه، وأخاه، ووصيه. الإمام علي بن أبي طالب (ع)، فجاء آية من آيات الله البشرية المتجسدة، ومعجزة من معاجز التربية النبوية للبشر.
الرسول ليس كما يصفونه
ولذلك لا تنظر – أرجوك – إلى تلك الأحاديث المختلقة، والروايات المخترعة، وأكثرها من الإسرائيليات. والأمويات التي شوَّهت وجه التاريخ. بل شوهت أنقى، وأرقى، وأجمل صورة في الإنسانية وهي صورة الحبيب المصطفى (ص) حيث وصفته بتلك الأوصاف التي لا يقبلون أن يصفوا بها آباءهم وصبيانهم. كالتي تقول: أنه كان خائفاً وجلاً وحتى فؤاده يرتجف من الخوف والفزع حتى طمأنته السيدة خديجة (ع)، أو التي ثبَّتته: بأنه كان مراراً يُريد أن يرمي نفسه من شاهق أو حالق لينتحر، أو أنه كان متزلزلاً في نفسه. ومضطرباً في حاله. أو أنه شاكاً بمَنْ نزل عليه. حتى سكَّنه ورقة بن نوفل النَّصراني. وكأنه لا يعرف مَنْ نزل عليه. ولا النَّازل (جبرائيل) يعرف إلى مَنْ أتى ونزل.
فهذه كلها ترَّهات وأكاذيب اخترعها صبيان قريش الزبيريون. ونشرها الأمويون لتشويه الصورة الناصعة لرسول الله (ص) وأعانهم على ذلك الذين منعوا تدوين الأحاديث. بل ومنعوا الحديث بفضائل أهل البيت الأطهار (ع) الذين هم عِدل القرآن، كما في نصِّ حديث الثقلين المتواتر في الأمة.
مبعث النور والقيم
ولذا في هذا اليوم العظيم 27 رجب الأصب الذي هو مبعث النور في الظلام الجاهلي، ومنطلق القيم والفضائل في البشر لأن فيه نزلت طلائع القرآن الحكيم، وهو الذي جمع العقائد، والأحكام، والقيم. وكان رسول الله (ص) قرآن ناطق ومتجسِّد يمشي على قدمين. والقرآن رسول صامت مجموع ما بين الدَّفتين. ولذا وصف القرآن أخلاق الرسول بقوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم: 4). ووصفوا أخلاقه (ص): (بِأَنَّهُ كَانَ خُلُقُهُ اَلْقُرْآنَ). (مجموعة ورّام: ج۱ ص۸۹)
والعجيب أن أول سورة نزلت من القرآن في ذلك اليوم العظيم هي سورة (إقرأ) فبدأت المسيرة الحضارية بالقراءة في قوم لم تكن القراءة عندهم إلا حلماً من الأحلام. وربما أن الذين يُجيدون القراءة فيهم لا يتجاوزون أصابع اليدين، فجاء القرآن الحكيم ليبدأ رحلته بالقراءة، ثم كانت السورة الثانية هي (القلم)، وفيها يصف ربنا سبحانه أخلاق رسوله الكريم (ص) بالعظمة، وليس في نهاية البعثة كما يظن البعض. فالرِّسالة لم تنزل على الرَّسول لتكمله. بل نزلت عليه وهو في قمَّة الكمال. لأن الرسالة لا تنزل إلا على الكامل ليكون لها أهلاً ومحلاً. ولكن بها بدأت رحلة الكمال البشري على يديه الكريمتين.
فالمبعث الشَّريف يجب أن ننظر إليه بهذا المنظار القِيمي وأنه كما يقول سماحة السيد القائد علي الخامنئي (دام عزه): (أكبر عيد للبشرية). وذلك لأنه مبعث النور في الظلام. ومنطلق القيم والفضائل في الأنام، فما أحوجنا وأحوج الشعوب والأمم لمعرفة عظمة هذا اليوم والخير الذي انطلق من ذلك الغار من أعلى ذلك الجبل في أطراف مكة المكرمة.