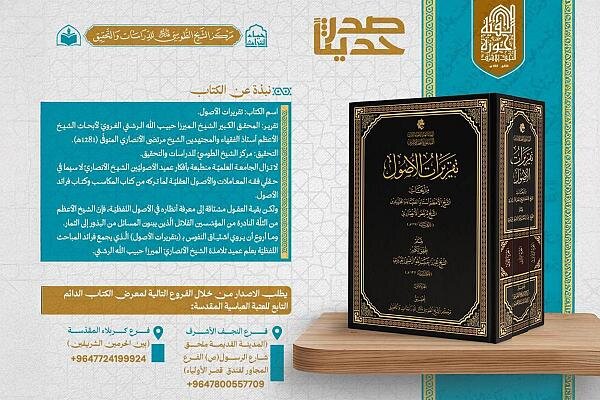إن غاية الخلق هي إفاضة الوجود عليه من ذات الله التي هي مصدر الفيض الدائم الذي لا ينتهي، ولتقريب الفكرة أضرب المثل التالي، وإن كانت كل الأمثلة لا تُقاس على الله، لأنها محدودة مهما بلغت، فأما الله فلا يحدّه شيء، ولا يحويه شيء، وهو غني عن كل شيء.
ورُوِيَ عن الإمام علِيَّ (ع) أنه قال: “لَمْ يَخْلُقِ اللهُ سُبْحانَهُ الْخَلْقَ لِوَحْشَتِهِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُمْ لِمَنْفَعَتِهِ”.
تحمل هذه الجوهرة الكريمة معاني عميقة تتعلق بغاية الخلق وفلسفة العلاقة بين الخالق والمخلوق من منظور إسلامي، وتبيِّن بشكل واضح غِنى الله تعالى عن جميع خلقه، وافتقار جميع خلقه إليه، واستمداد حاجاتهم منه لا من سواه، فوجودهم جميعاً قائم به، وهو القيُّوم عليهم جميعاً، وكل ما يحتاجون إليه في سيرهم الوجودي عطاء منه حصراً، لا يشاركه غيره فيه، قال سبحانه: “يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ”﴿29/ الرحمن﴾.
إن وجودهم جميعاً بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة مفتقر إليه، وبذلك يكون السؤال من خلال التعبير الحسي تارة، ومن خلال الحاجة الوجودية الطبيعية تارة أخرى، والله تعالى هو مناط السؤال، وغيره لا يُسْألُ لأنه فَانٍ فقير لا يتعلق به سؤال، يسألونه وهو وحده الذي يستجيب، وقاصِدُه وحده هو الذي لا يخيب، وما يتَّجِهُ أحدٌ إلى سِواه إلا حين يَضِلُّ عن مَناط السؤال ومَعقِد الرجاء ومظنة الجواب، وماذا يملك الفقير الفاني للفقير للفاني، وماذا يملك المحتاج للمحتاج؟
وهو سبحانه كل يوم هو في شأن، فهذا الوجود الذي لا تُعْرَف له حدود، كله مَنوط بقَدَرِه، مُتعلِّق بمشيئته، وهو قائم بتدبيره. هذا التدبير الذي يتناول الوجود كله جملة، ويتناول كل فرد فيه على حدة، ويتناول كلَّ عضو وكلَّ خَلِيَّة وكلَّ ذرة، ويعطي كل شيء خلقه، كما يعطيه وظيفته، ثم يلحظه وهو يؤدي وظيفته، وصاحب التدبير وهو الله لا يشغله شأن عن شأن، و لا يغيب عن علمه ظاهر ولا خافٍ.
التوحيد قارئي الكريم أساس العقيدة ، وهذا يشمل الاعتقاد بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص أو حاجة، فهو الغني المطلق، ولأنه كذلك فإنه لم يخلق الخلق لحاجته إليهم، لم يخلقهم من وحشة ليأنَسَ بهم، وليس لتعويض نقص أو حاجة في ذاته سبحانه، فالله هو الكامل الذي لا يحتاج إلى شيء، وبالتالي لا يحتاج إلى الخلق ليُكمِل أو يسدّ فراغًا في ذاته، فالخلق لا يضيف شيئًا إلى الله ولا ينقص منه شيئًا.
وعليه فإن غاية الخلق هي إفاضة الوجود عليه من ذات الله التي هي مصدر الفيض الدائم الذي لا ينتهي، ولتقريب الفكرة أضرب المثل التالي، وإن كانت كل الأمثلة لا تُقاس على الله، لأنها محدودة مهما بلغت، فأما الله فلا يحدّه شيء، ولا يحويه شيء، وهو غني عن كل شيء، ألا ترى قارئي الكريم أن الشمس طبيعتها الضِّياء؟! إنها تفيض النور على الموجودات التي في منظومتها، كذلك الله تعالى ذاته فَيَّاضة، تفيض الوجود والعطاء والرزق وكل خير، ومن فيضه تعالى إيجاد الخلق، والغاية تكاملهم في سيرهم الوجودي، وإظهار رحمته تعالى بهم، وإتاحة الفرصة ليعرفوه من خلال آياته وخلقه فإذا عرفوه عبدوه، قال تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿56﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ ﴿57﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿58/ الذاريات﴾.
ورُوِيَ عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: “إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْرِفوهُ، فَإِذا عَرَفوهُ عَبَدوهُ، فَإِذا عَبَدوهُ اسْتَغْنوا بِعِبادَتِهِ عَنْ عِبادَةِ مَنْ سِواهُ”، ولا شَكَّ في أن الإنسان إذا ما وحَّد اللهُ استقَرَّ واطمأنَ واستقامت حياته، أما إذا عبد غير الله فالعكس صحيح.
وكما أن الله سبحانه لم يخلق الخلق لوَحشَة كذلك لم يستخدمهم لمنفعته، إنه عندما يأمرهم بعبادته فمردود عبادتهم يرجع إليهم تكاملاً في وجودهم ولا يرجع إليه أبداً لأنه الغَنِيُّ الحميد، الأعمال التي يقوم بها البشر لا تفيد الله بشيء، بل الإنسان هو الذي يحتاج إلى عبادة الله لتحقيق كماله الأخلاقي والروحي والمادي.
بقلم الكاتب والباحث اللبناني في الدراسات القرآنية السيد بلال وهبي