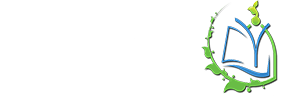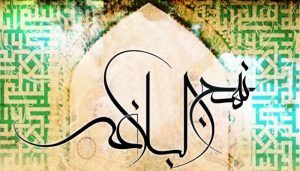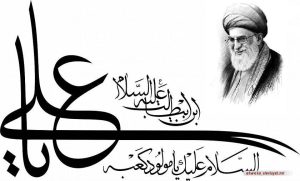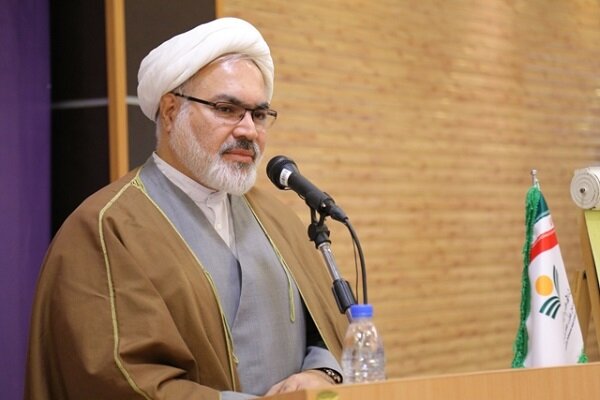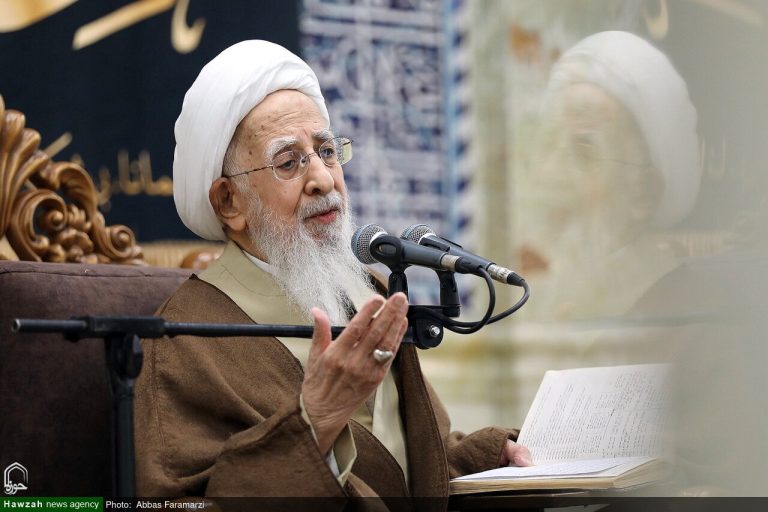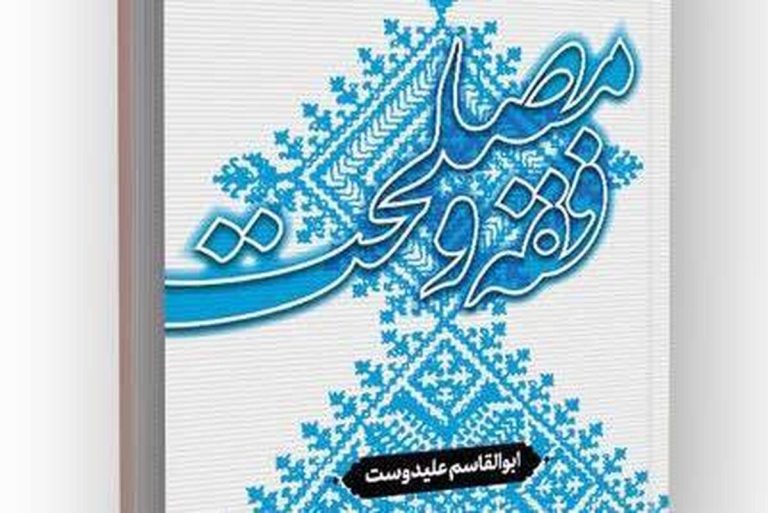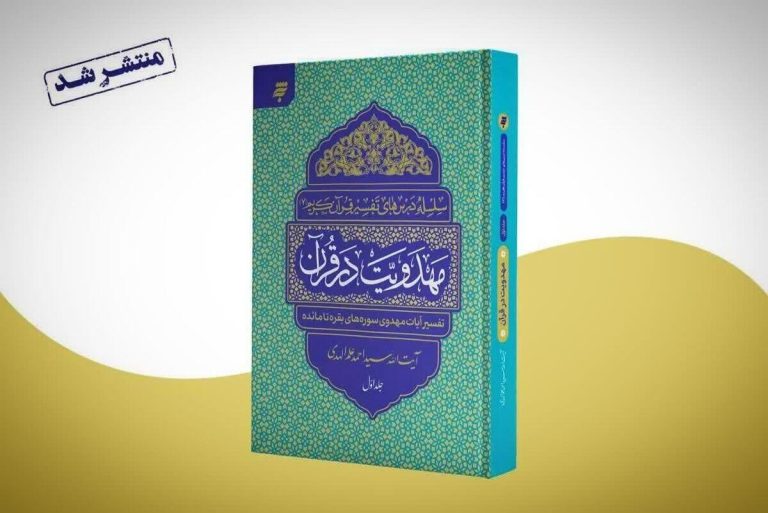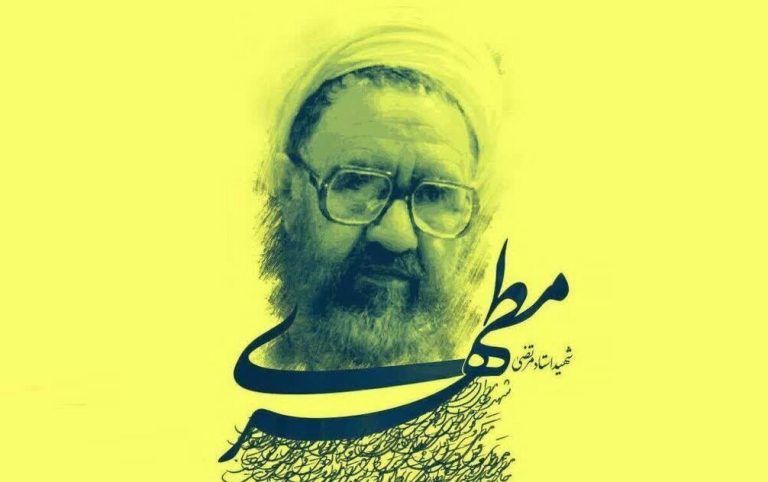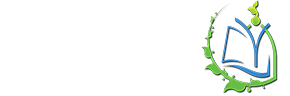إن الاستسلام للشكوك والشبهات يؤدي إلى تراجع الإيمان بالحقائق الثابتة، مما يفقد الشخص هويته الإيمانية والدينية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتجاوز إلى اضطراب سلوكه وقيمه، مما يؤدي إلى انتقال هذه الأعراض إلى الآخرين، فيصبح ضالاً ومُضللاً.
ورُوِيَ عن الإمام علِيَّ (ع) أنه قال: “مَنْ كَثُرَ شَكُّهُ فَسَدَ دينُهُ”.
معادلة تقوم على الربط بين كثرة شك الشخص وفساد دينه، وفيها تحذير من الانجراف وراء الشكوك والشُّبُهات، وضرورة المسارعة إلى تفنيدها والبحث عن حلول لها، كي لا تبقى في القلب فتؤثر فيها، وتنقله تدريجياً من الإيمان إلى الإلحاد، وفي مفهومها دعوة لأن يحرص المَرء على أن يكون تَدَيُّنه يقينياً مرتكزاً على البراهين والحُجُج القاطعة.
“مَنْ كَثُرَ شَكُّهُ فَسَدَ دينُهُ” هذه الجوهرة الكريمة ليست إخباراً وحسب عمَّا تفعله الشكوك والأوهام والشُّبُهات بدين الإنسان، بل فيها دعوة إلى وجوب إلى التمسك بالحقائق الثابتة واليقينية، في مواجهة حملات التشكيك والتلاعب الفكري التي يمارسها أعداء الدين بشكل دائم، والذين يحرصون في كتاباتهم ومنصَّاتهم ومناهجهم الدراسية وأساليبهم الدعائية على إثارة الشُّبُهات في وجه الشباب المتدين، وطرح إشكالات يحسبون أن الدين عاجز عن ردِّها وتفنيدها، ويحرصون على بناء أجيال مُشَكِّكة تُشكِّك في كل شيء ولا تؤمن إلا بما تٌثبته التجربة الحِسِّية، وإنكارهم ما وراءها، على الرغم من أن العلم الحديث يعجز عن إنكار ما وراء المادة.
من حيث المبدأ لا مشكلة في الشَّكِّ، ولا خوف منه، بل دائماً ما يكون مقدمة لبلوغ اليقين في إثبات أمر أو نفيه، المشكلة تكمن في الشك الذي لا ينتهي، الشك الذي لا يدعو صاحبه إلى البحث عن إجابات له، الشك الذي يجلب الشُّبُهات إلى عقل الإنسان ويراكمها فيه دون أن يسعى لتفنيدها وتحليلها والبحث عن صحتها أو خطئها، الشَّكِّ الذي يسيطر على عقل المرء وقلبه فيدفعه إلى التشكيك في الدين كله، إن هذا اللون من الشك لا يُفسِد دين المرء وحسب، بل يُفسد دنياه أيضاً، لأنك حين تبني شخصاً شكاكاً فإنك تنزع منه الحياة المستقرة الوادعة، لأن الحياة لا يمكن أن تستقيم مع الشَّك الدائم، بل تحتاج إلى تعامل قائم على اليقين مع معادلاتها وقوانينها وحقائقها، والعلاقات بين الفرد وبين الآخرين لا يمكنها أن تقوم على الشكوك المتواصلة، الشيء الذي يوجِب على الشخص العاقل أن يحذر من استمرار الشكوك في عقله وقلبه، وأن يسارع إلى البحث عن إجابات شافية وافية لها، كما يوجِب عليه أن يكون على حذر شديد من الأبواب والمنافذ التي تنفذ منها الشكوك إليه وأهمها:
أولاً: المعرفة السطحية بالدين، فحينما يفتقر الفرد إلى المعرفة العميقة بالدين ومعرفة الأسس العقائدية له، فإنه يكون أكثر عرضة للتشكيك في مفاهيمه، وغالباً ما يكون سبب ذلك تلقيه الدين كموروث اجتماعي، وانتمائه إليه كما ينتمي إلى العادات والتقاليد التي آمن بها الآباء والأجداد دون دراسة جادَّة للدين، وفهم عميق لأركانه ومنظومَتَيه العَقَدية والشرعية.
ثانياً: التأثُّر بالتيارات الفكرية الحديثة: فإن الكثير منها تقوم على الترويج للشك كمنهج في البحث العلمي والفلسفي، وبهذا تُسهم بلا شك في تفكيك العقيدة إذا لم تُراعي الحقائق الدينية التي أثبتتها البراهين العقلية القاطعة.
ثالثاً: الاكتفاء بالإيمان النظري وعدم تحويله إلى إيمان عملي، أي: يؤمن بالله نظرياً ولكنه لا يمارس إيمانه بالاتصال بالله تعالى، ومعلوم أن الالتزام بالتكاليف الشرعية، وأداء العبادات المنصوصة تبلغ بالعابد درجة اليقين وتُعَمِّقه في قلبه، قال تعالى: “وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ”﴿الحِجْر: 99﴾.
إن الاستسلام للشكوك والشُّبهات يؤدي إلى ضعف الإيمان بالحقائق الثابتة، ومعه يفقد الشخص هويته الإيمانية بل والدينية، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتخطّاه إلى اضطراب سلوكه وقِيَمه، ثم تنتقل هذه الأعراض منه إلى غيره فيصبح ضالاً مُضِلاً.
انطلاقاً مِمّا سبق نرى الإمام أمير المؤمنين (ع) يدعونا إلى الثبات على اليقين، وعدم الانجراف وراء الشكوك والاستسلام لها لأنها ستجُّر إلى المزيد، مِمَّا ينتهي بفساد دين المرء، فالواجب العقلي يقتضي أن يسارع المرء إلى معالجة شكوكه إن وُجدت، وعم التساهل أو التأجيل في ذلك.
بقلم الكاتب والباحث اللبناني في الشؤون الدينية السيد بلال وهبي