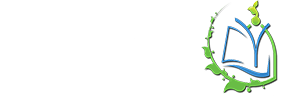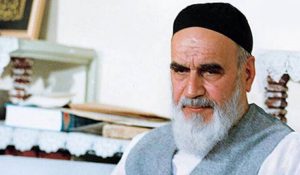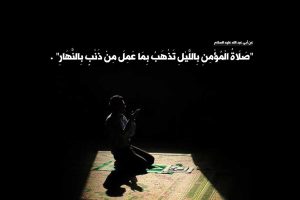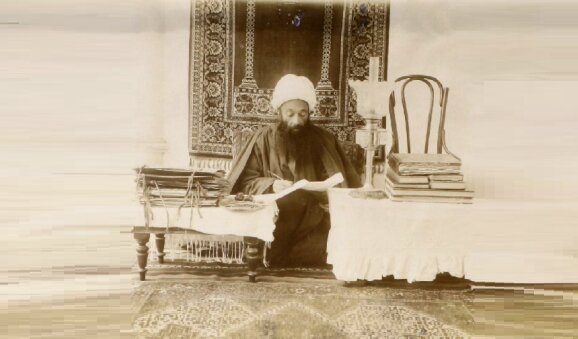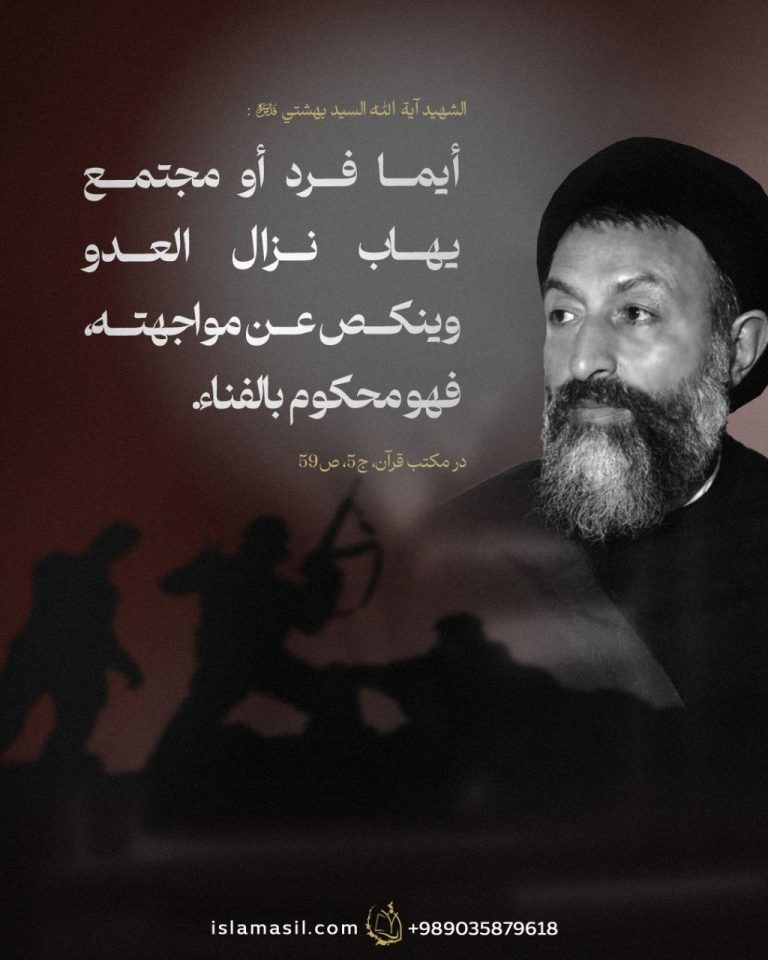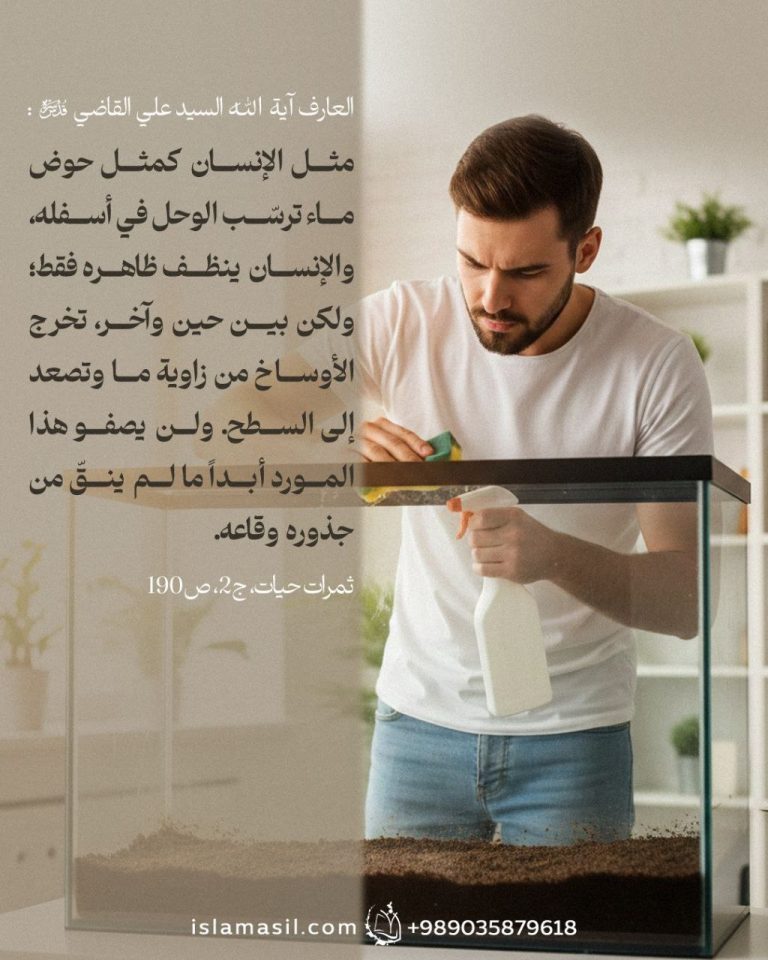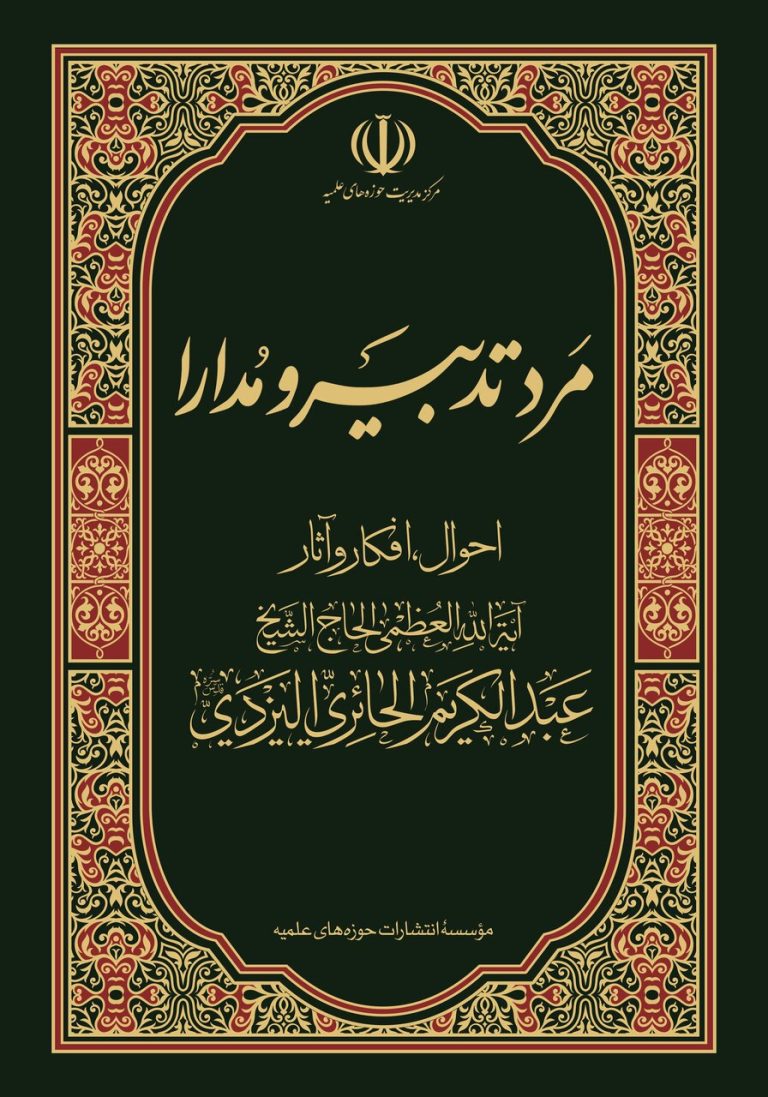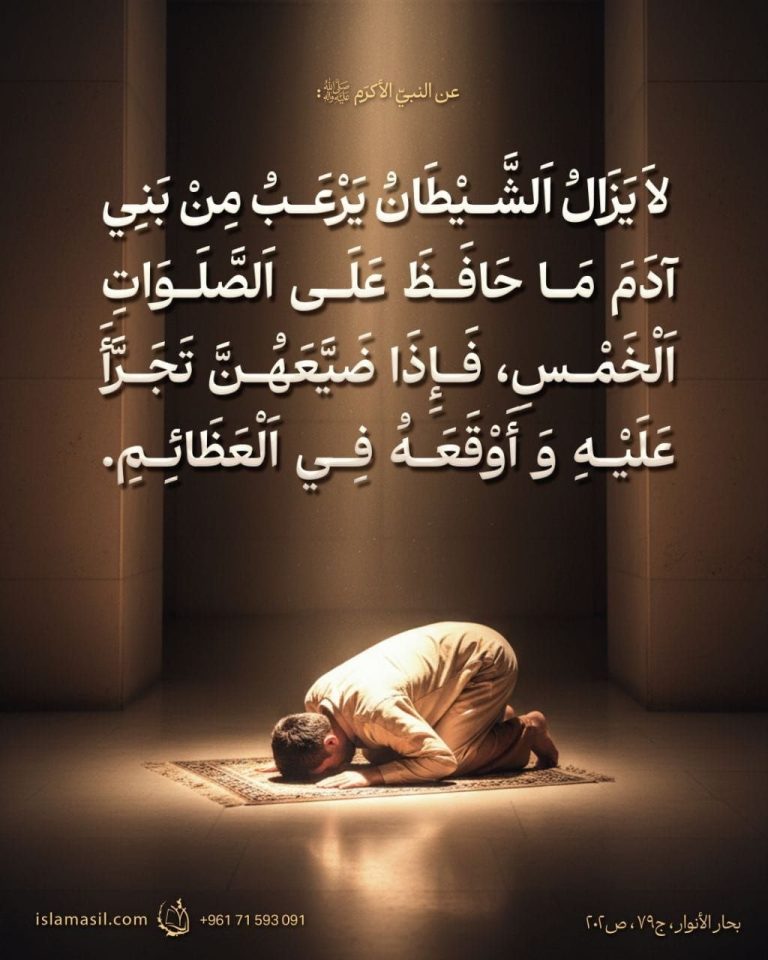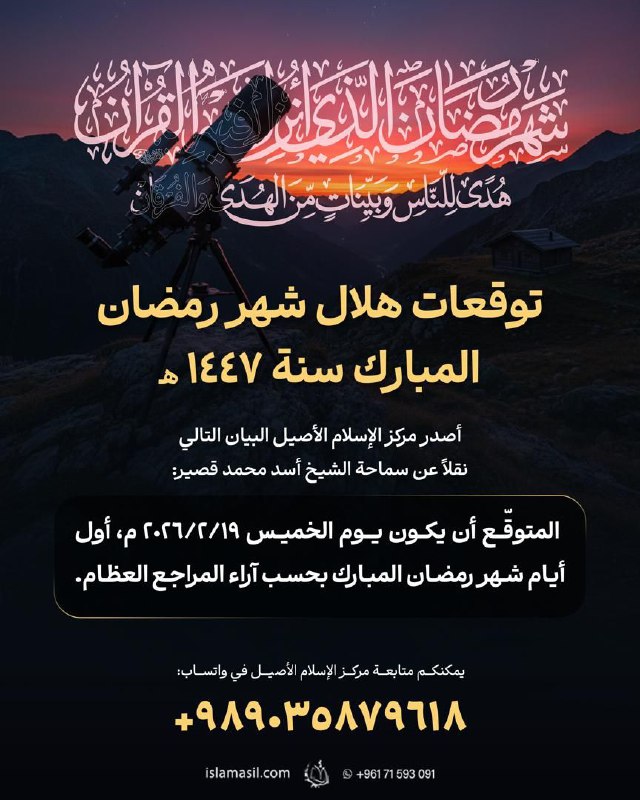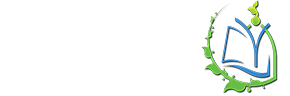قال عالم الدين اللبناني والأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف “السيد محمدرضا شرف الدين” إن لباب قيام الإمام الحسين (ع) مع كونه قياماً دينياً وإجتماعياً ولا ينفكّ عن المنظومة التشريعية برمتها، ألا أنه كان دينياً أخلاقياً بامتياز”، مصرحاً أنه “لو لا لقاح النهضة الحسينية لم يكن بالإمكان فيما بعد أن تقام دولة إلهية عادلة شاملة على الأرض المتمثلة في الحجة بن الحسن (عج)”.
وأشار إلى ذلك، عالم الدين اللبناني والباحث الاسلامي، والأستاذ في الحوزة العلمية بالنجف “سماحة السيد محمدرضا شرف الدين” في حديث لوكالة “إكنا” للأنباء القرآنية الدولية، قائلاً: “إن الكلام عن قيام الإمام الحسین (ع) ومحورية هذا الحدث بحيث أنه يتصيد من الأدلة أنه جُعل محوراً رسالياً لكافة العصور ما تقدم منها وما تأخر، لا ينفك عن النظر إلى جُنة من أركان هذه الواقعة العظمى، النظر يكون في مقدمات الواقع وفي إرهاصاتها. ثم بعد ذلك في مكوناتها وفي أبطالها، وفي آثارها وارتداداتها. فلا يمكن أن نجتزأ المشهد بخصوص الواقعة وما اكتنفها من ظروف وعوامل وأحداث”.
وأضاف: “النظر أولاً على الخط الرسالي الممتد من بكر خلفاء الله في الأرض سيدنا آدم(ع) ومشروع الرسالة التي واكبته جموع المرسلين إلى خاتم النبيين (ص)؛ كل ذلك، بكل مكوناته وحركاته وآثاره كان يؤدي إلى وقوع مثل تلك الواقعة”.
وأردف مبيناً: “إذا نظرنا إلى مشروع الاستخلاف الإلهي وما قابله توأماً معه من قضية مسألة التمرد الإبليسي ومشروع الغواية وبعد ذلك في هبوط نبي الله آدم على نبينا وآله(الصلاة والسلام) والسير الرسالي الذي قام به الأنبياء (ع) والصلحاء ومعهم الحواريون وقدموا كل غال ونفيس. تلك التضحيات وتلك الإصلاحات وتلك النهضات وما قابلها من مشروع الغواية من عمليات اجهاض وتحريف بعد الاضطهاد، بحيث أنه كادت تخلو هذه الشعلة المنيرة إلى أن جاء الخاتم (ص) ليقوّم المسار برسالة اختزلت كافة الرسالات السماوية، بكتاب مهيمن على كافة الكتب الوحيانية، بمنظومة كاملة مشتملة على كافة الأبعاد”.
واستطرد قائلاً: “كانت التضحيات لأكثر من عقدين من الزمان بمرحلته المكية ثم المدنية، بعد ذلك، ليلي كل ذلك حركة الإنقلاب على الأعقاب التي كادت تودي بكل تلك الانجازات المحمدية والتي هي في الواقع عصارة الانجازات النبوية الرسالیة التي قام بها من سبقه من الأنبياء (ع) والمصلحين الإلهيين”.
وفي معرض مقارنته إلى حركات التمرد السابقة والحالية، قال السيد محمدرضا شرف الدين: “هذه حركات التمرد لم تكتفي هذه المرة بـ ما كانت عليه حركات التمرد الأولى، حركات التمرد عادة كانت تنقض على الشرائع أو على المنظومة العقائدية أو على المنظومة الفكرية أو على المنظومة التشريعية، وتكتفي بذلك، فكان بعد ذلك يأتي الرسول الذي يلي الرسول الماضي، يأتي ليبعث روح الرسالة من جديد مرتكزاً على الأصول الأخلاقية لدى أحد الجماهير”.
وأضاف: “إن الأصول الأخلاقية كانت تبنى عليها بعد ذلك، محاكاة فطر العقول واستنهاض الأصول الاخلاقية واجتذاب الجماهير نحو الرسالة لتقويم المسار.”
وأوضح: “في تلك الحقبة، الخطوة الإضافية التي نشاهدها حالة مسخ الأصول الأخلاقية التي كانت بذورها حتى في زمان الجاهلية مستمرة”.
وأكدّ: “في هذه الحقبة نجد باسم الدين وباسم الله وباسم خلافة رسول الله (ص) عُمل على تقويض كل ذلك، بحيث نرى بأن ما كان يأنفه الجاهليون ويرونه سُبة على أنفسهم فيما لو اغترفوه من الغدر والخيانة ومن عدم حماية الجار والمساومة على الأعراض، من الخداع والكذب وإلى ما هنالك من القضايا التي كانت موجودة في الجاهلية ولكن كانت سُبة على أصحابها ومن ثم نرى مثلاً في قضية حلف الفضول كيف كان حلفاً ممدوحاً ومحبوباً.”
واستطرد قائلاً: “كما نرى في تسمية الرسول (ص) بالصادق الأمين، نرى بأنه انبعثت من فطرهم هذه المدحة على ألسنتهم لرسول الله (ص)، فـالصدق عندهم مدعاة افتخار واعتزاز ومدح وثناء؛ بينما نجد مثلاً وصلت الأمور في مرحلة التمرد الشامي الذي حصل على حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، جُعل الصدق والاستقامة والشفافية والنزاهة عيباً يعيب به من يعيب على شخص أمير المؤمنين (ع) وأنه لا علم له بالحرب والسياسة ولا يستطيع أن يتدبر الأمور وأن الدهاء والشيطنة والمكر والختل والغدر وكل ذلك أدوات سياسية مقبولة لابدّ أن يتحلى بها السلطان.”
وقال: “وصلت القضايا إلى درجة إحلال العُلقة والوشائج حتى القبلية، بحيث أننا نجد في القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة والفروع الواحدة والبيت الواحد هناك من استجار به أو من له عليه حق ومن بينه وبينهم قربى ونحو ذلك”.
وأضاف: “فإذاً القضية وصلت إلى درجة تهديد كيان الأصول الاخلاقية والمُثُل القيمية عند الانسان وهذا يعني حيث نجد في الأحاديث بأن حُسن الخُلُق مثلاً وعاء الدين وأنه عنوان صحيفة المؤمن والذي نجد بأنه تشير الآية الكريمة في قوله تعالى “فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ” المراد الأصول الأخلاقية التي هي أصول جبلية فطرية.”
وأكدّ: “إذا كسرت ونُسخت هذه الأصول فهذا يعني أنه لن تقوم للإنسانية قائمة بعد هذا. وهذا يعني إغلاق باب الإصلاح بالکلیة في وجه كل مصلح یرید أن يأتي ليبعث روح الخير والانسانية في المجتمع البشري”.
وأردف السيد محمدرضا شرف الدين موضحاً: “من ثم ننطلق لنقول، حيث نرى بوضوح أن الدين قوامه وركنه الأساس الأصول الأخلاقية وعملية التدين قوامها الأساس الفعّال العاطفة الدينية، فالدين قوامه الأصول الأخلاقية والتدين أي التفاعل مع المنظومة الدينية في الواقع الحالة العاطفية، هي التي تفعّل المدركات العقلية والفكرية والعقدية وتأخذ بيد الانسان ليعمل بما علم ولينجذب الى ما آمن به واعتقد به”.
واستخلص من ذلك، بأنه “كان قيام الإمام الحسين (ع) مع كونه قياماً دينياً وإجتماعياً ولا ينفكّ عن المنظومة التشريعية برمتها، ألا أنه لباب القيام كان قياماً دينياً أخلاقياً بامتياز”.
وأردف مبيناً: “الحالة الاخلاقية والأصول الاخلاقية التي أفرضت في قالب عاطفي شديد يهزّ الوجدان ويستفزّ الفطرة، كانت كـ صدمة مستمرة في ارتداداتها وستبقى هكذا تأخذ بالفطرة لتكون الفطرة عصية على التجميد أو الإماتة”.
واستطرد قائلاً: “إذا أردنا أن نصف هذا القيام وصفاً مطابقاً للواقع ملائماً وموائماً للنصوص والملامح التي جاءت به النصوص عن طبيعة تحركه (ع) وما تخللها من مواقف وبيانات منه(ع) بالاضافة الى دراسات الظروف الموضوعية، نرى بأن الانصاف أن يقال بأن السمة البارزة في قيامه هي أن قيامه كان قياماً أخلاقياً متشدداً في أخلاقيته بلون صارخ عاطفي.”
وفي وصف ثورة الإمام الحسين (ع) قال السید مرتضى شرف الدين: “قيامه كان كتاباً متجسداً مداده الدماء والدموع”، موضحاً: “إن قيامه (ع) بكل مفرداته كان قياماً قصدياً ترميزياً يعني هناك رموز تحتاج إلى فكّ لرمزيتها واستجلاء لبابها، والوقوف على مقاصدها”.
وربط بين ما حدث في كربلاء من مشاهد عاطفية والتكليف الإلهي، قائلاً: “المعصوم يمتلك الكفاءات الإنسانية بأرقى مستوياتها، فعاطفته الإنسانية هي أرقى العواطف من حيث الفعالية لكنه يكبح جماح العواطف حيث يأتي التكليف بأن يصبر ويكظم”.
وأكدّ الأستاذ في الحوزة العلمية: “في ذلك اليوم كان التكليف يقتضي بأن يرسل عواطفه ويطلقها فكانت تلك الصور العاطفية الصارخة التي كانت جزءأ من مسيرته (ع)، وبالتالي من أراد أن يرى المحصلة في مسألة قيامه (ع) عليه أن يبحث في هذه الجهة”.
وأشار إلى أهداف الثورة الحسينية، قائلاً: “انطلق الإمام الحسين (ع) في إصلاح البنية التحتية الأساسية لشخصية الإنسان ومن ثم نرى بأن هذه الحالة كانت عبارة عن لُقاح إثمارها يكون بيد الحجة (عج)”.
ووصف الأستاذ بالحوزة العلمية في النجف الأشرف، الثورة الحسينية بأنها “لُقاح حسيني والاثمار مهدوي”.
واعتبر الثورة الحسينية مقدمة للحكم المهدوي، مؤكداً: “ولو لا لقاح النهضة الحسينية والقيام الحسيني لم يكن بالإمكان فيما بعد أن تقام دولة إلهية عادلة شاملة على الأرض المتمثلة في الحجة بن الحسن (عج) وهذا عليه الكثير من الشواهد”.
وفي جزء آخر من حديثه، تطرق إلى طبيعة مجتمع الكوفة آنذاك مقارنة بالمجتمع اليمني، قائلاً: “اذا نظرنا نظرة ميدانية آنذاك للخريطة السياسية والتركيبة الاجتماعية فنرى بأن أرض اليمن تشكل مهد الأمن والصخرة الصلبة التي يمكن أن يرتكز عليها حكم في الخطوة الأولى لعملية اسقاط النظام الجائر وتشييد حكومة حسينية لأنه اذا نظرنا الى الكوفة نجد أن هناك نسيجاً غيرمتجانس وهي مدينة مستهدفة وتشتمل على تيارات متناقضة متضادة وفيها جميع الأعراق واتباع التوجهات العقدية وكافة الملل والنحل ولكنه في مشهد آخر مباين تماماً للكوفة، هناك اليمن ذات النسيج المتجانس المتراص بتركيبة قبلية متينة أكيدة غير قابلة للاختراق ولعل إلى يومنا هذا نشاهد هذه النقطة في اليمن إذ أن اختراق ذلك المجتمع ليس أمراً سهلاً، وأهل اليمن تشرفوا بالإسلام على يد أمير المؤمنين (ع) في فتح سلمي ودون قتال إنما كانت بمخاطبتهم وحل مشاكلهم قبل أن يسلموا”.
وأضاف أن “قضية هذا التجانس والتراص في المجتمع اليمني كانت تُصور للناظر والمراقب السياسي أمثال محمد بن الحنفية بأن الحسين (ع) لو أراد حركة تغييرية للنظام تأتي على وجود هذا النظام وتبني نظاماً آخر على أنقاض هذا النظام، من الطبيعي جداً أن يتجه نحو اليمن، إذا توجه نحو اليمن ثم توسع نحو البحرين التي تشبه اليمن من جهات متعددة، يتوسع شيئاً فشيئاً نحو الحجاز وبالتالي يكون قد كوّن سلطة فتية قوية لا يمكن أن تكسر وتهزم مقابل المكر والكيد الأموي”.
وأردف: “تلك النصائح التي وُجهت كانت منطلقة من دراسة ميدانية للواقع النفسي والاجتماعي والسياسي لكن خطأها كان يعود إلى نقطة وهو الجهل بهدف سيد الشهداء (ع) من التحرك، أي أنهم كانوا يتصورون بأن الهدف كان تحركاً سياسياً عسكرياً ومن الطبيعي أن تأتي هذه النصائح.”
واستطرد قائلاً: “لم يخطر ببالهم أن الهدف كان هدفاً أبعد من ذلك يعود إلى قضية محاكاة وإعادة بعث الكيان الداخلي البشري لأصوله الأخلاقية الفطرية التي كانت تؤول إلى الاحتضار ولذا إجابته (ع) كانت مختلفة ومتعددة بحسب السائل وخلفياته وماذا يدرك. للبعض وعده بأنه ينظر في الأمر وللبعض الآخر قال له بأني رأيت جدي رسول الله (ص) كلمني في المُضي إلى العراق”.
وأكدّ السيد محمد رضا شرف الدين قائلاً: “نرصد سبعة عشر موقفاً أن الامام الحسين (ع) يلمّح فيها أو ينص فيها إلى أنه عازم على الشهادة وماضٍ اليها، ماضٍ إلى رسم فتح استشهادي حيث قال(ع): “من لحق بنا منكم أستشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح”.
وتابع مؤكداً: “القضية هو أنه فتح استشهادي، وأنه بصدد القيام بملحمة بطولية غير متعارفة صارخة أخلاقية عاطفية بامتياز، وهذا لا يتنافى مع كونه أتته رسل القوم وبناء على هذه الرسل توجه إليهم.”
وقال: “لم يكن سيد الشهداء (سلام الله عليه) ليقوم بما قام به من مشهدية رائعة ورسالة خالدة. وهذا اطلالة على خلود الرسالة وشمولها وشمول رقعتها زماناً ومكاناً، ومحاكاتها لكافة أبناء الملل والنحل والتوجهات والمشارب والمدارس لأن القضية كانت تعود في الصميم الى قضية الانسانية يعني الى فطرة عامة لاتنحصر بزمان دون زمان.
وأضاف: “إذا سأل سائل بأن الحسين (ع) جاءته الكُتب واستدرج والبعض قد يأخذ انطباعاً بعيداً عمّا نعتقد به بأنه (ع) مطلع على مسار الأمور إخباراً عن جدّه (ص) وإطلاعاً من قبل الله سبحانه وتعالى بتلك السياقات والأدوات الخاصة التي يمنحها الله تعالى لأولياءه، ولكن السؤال هو هل كان دور لتلك الكُتب؟ نعم، كان لها دورٌ كبيرٌ لأن هذه الواقعة، والقتل بهذه المظلومية، أن يلقى الموت بهذه الكيفية، لا يؤثر إلا أن يستجمع الحسين (ع) مجموعة من الأوصاف. هذه الأوصاف يكون مجمعاً لها ثم بعد ذلك، نرى بأنهم يعدون عليه فيقتلوه، أن يُقتل وهو مستجمعٌ لتلك الأوصاف”.
وأردف مبيناً: “الحسين (ع) حينما قُتل بتلك الكيفية المفجعة وبتلك الوحشية التي لا نظير لها والتي لا يمكن أن نتصورها وهي فوق مستوى الخيال كما ورد في الأحاديث، فإن كان المشاهد أو كان من بلغه هذا القتل مؤمناً برسول الله (ص) فالحسين ريحانة رسول الله (ص) وابنه ولا ولده فحسب ولما للكلمة من معنى وهذا ما كان يجسده الحسين (ع) في خطاباته حيث لم يكن في حياة رسول الله (ص) إلا أن يخاطب أمير المؤمنين (ع) بأب إنما كان يخصص رسول الله (ص) بنداء “أبا” وقد ورد ذلك، أما الحسن (ع) كان ينادي أمير المؤمنين بـ أبا الحسين (ع)، والحسين (ع) يخاطب أمير المؤمنين (ع) بـ يا أبا الحسن (ع)، فمن كان مؤمناً بالنبي (ص) وباخباراته وبأوسمته فـ الحسين (ع) هو الأجدر وليس على وجه الأرض في ذلك اليوم من يبقى علياء الحسين (ع) في الأوسمة النبوية ومن كان يؤمن بالمنظومة الإمامية فهذا الحسين (ع) هو ثالث الأئمة وبالتالي له الحق المطلق في أن يُقدم على ما أقدم عليه”.
وأكدّ السيد محمد رضا شرف الدين: “إن كانت القضية من منطلق قبلي فالحسين(ع) هو أقرب لحمة لرسول الله (ص)؛ أي حتى من كان يؤمن بالنظام القبلي أو النظام الوراثي في السلطة فالوريث الشرعي هو الحسين (ع)”.
واستطرد قائلاً: “من كان يؤمن بمنطق الكفاءات فالحسين (ع) هو الأكفأ علماً ونزاهةً ومقبوليةً اجتماعيةً وما نحو ذلك”، وتابع: “من كان يؤمن بالمنطق الجماهيري والديموقراطي فالحسين (ع) هو المطالب به من قبل الجماهير.”
واستلخص من ذلك: “فالرسائل أفضت على قيام الإمام الحسين (ع) قياماً للحجة وقوة في إبلاغ رسالته التي أرادها.”
وأردف مؤكداً: “هذا المقتول طالبت به الجماهير، هذا المقتول لم يُقحم نفسه في هذا الأمر، هذا المقتول هو الذي جاءته آلاف الكُتُب التي تشكو إليه ما تلقاه من عنت وظلم وجور ومحدوديات من قبل السلطة القائمة وترجو منه أن يغيثها، إذاً هو يتجاوب مع الجمهور”.
وقال: “أضف إلى ذلك، بأنه في المنطق القانوني الأموي، الامام الحسين(ع) هو صاحب الحق الوحيد في هذا بناء على الهُدنة الحسنية التي وقّع عليها معاوية وأدرجها. فكانت قانوناً أموياً، بأن المُلك بعد مُضي معاوية هو للحسن (ع) وإن لم يكن لأخيه الحسين (ع)”.
وأضاف: “لذا كانت قد استُجمعت هذه الصفات في الحسين (ع) وإلا لم يكن ليؤثر ذلك الأثر. هذا الذي هو الأحق بالأمر بل هو المُحق الوحيد يلاقى بما لاقاه من جريمة بشعة ويرتكب في حقه وحق أصحابه ما لاقاه”.
وأشار إلى أن هذه الأمور لا يلغي بعضها بعضاً، مؤكداً: “بل تكاملت برمتها واجتمعت فيه (ع) مع كون مقصده لم يكن اسقاط الحكم الأموي، لأنه لا قابلية للإسقاط السريع، أي أن حركته لم تكن حركة آنية والنتائج والثمار الآنية لم تكن هي المنتجة، وإنما وصل إلى هدفه الأسمى من خلال ما قام به من تحرك له ظاهر وله باطن وله تفسير وله تأويل وبالتالي هذا الظاهر لا ينافي ذلك الباطن”.
وأكدّ الأستاذ في الحوزة العلمية: “قيامه في ظاهرة إستجابة لنداء من استغاث به، حكم الطاغية حكم غير شرعي، هتف بعدم شرعيته واستجاب للجماهير التي كانت تعاني ما تعاني. وبذلك سطّر تلك الملحمة الخالدة”.
وقال: “إن الخطاب الحسيني والنداء الحسيني لا ينحصر بين جدران الزمن ولا جدران المكان، وليس أمراً ضيقاً بحيث يمكن أن يُقصر على بُعد دون بُعد، خطابه كان خطاباً شاملاً.”
واختتم سماحة السيد محمد رضا شرف الدين قائلاً: “حركته القصدية الترميزية كانت حركة شاملة وسعة دائرتها وترامي أطرافها يعود إلى أنه(ع) حاكى ما لا يحكم بزمان و لا مكان ولا مسلك ولا مشرب بفضية أخلاقية وأصول أخلاقية والقيم المُثُل العليا الإنسانية”.