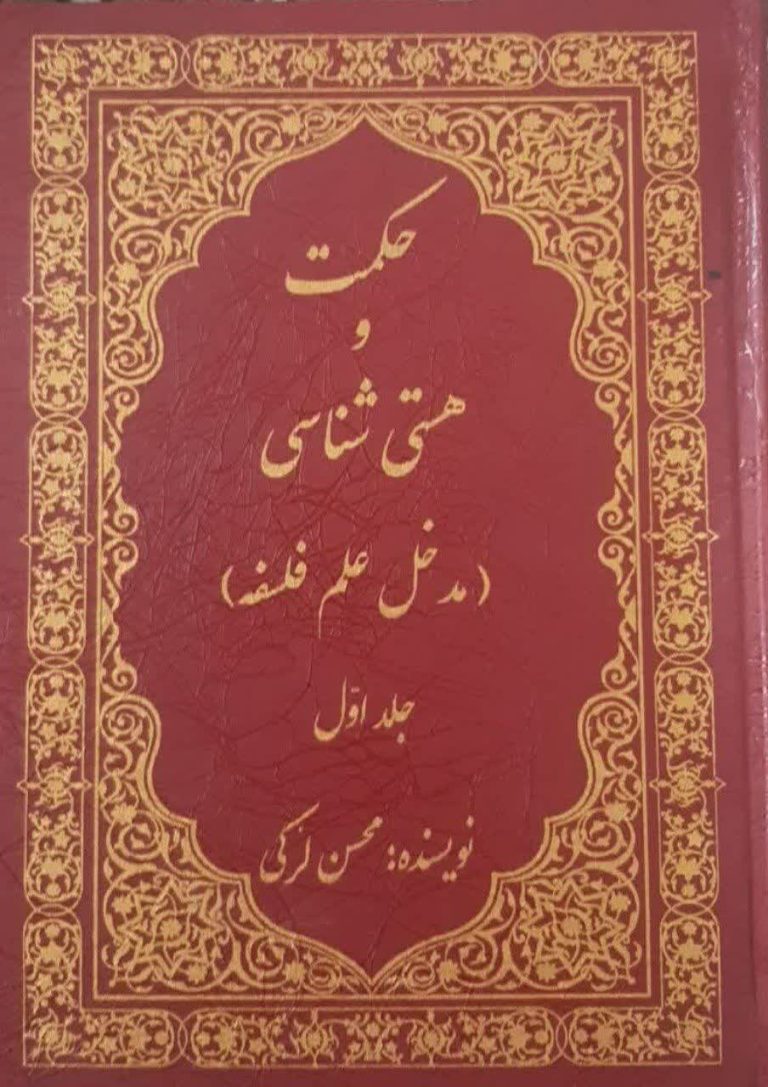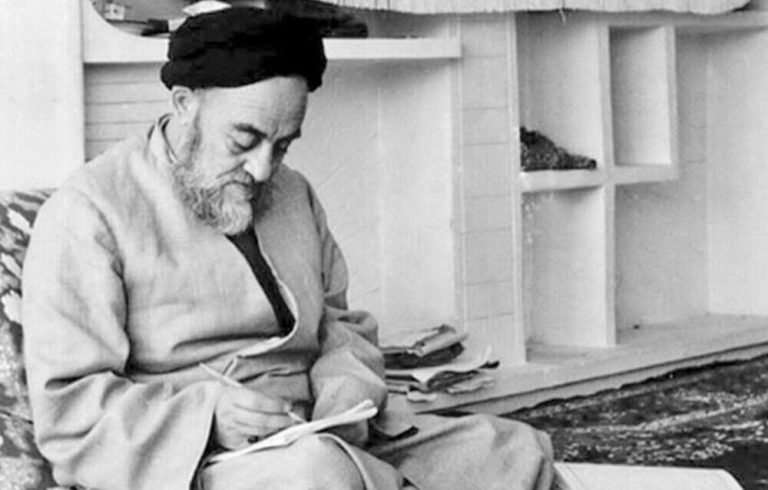إذا نظرنا إلى التراث الإسلامي، في تعاطيه مع النص القرآني، نجد تبايناً منهجياً تكشف عنه بشكل واضح كتب التفسير.
فبين من رآه مصدراً لغوياً فراح يتفنن في إعرابه وبيان صوره الفنية والبلاغية، وبين من رأى فيه كتاباً تاريخياً يتناول قصص الأقدمين وحضارة الماضين وهكذا، كتاب لغز وإشارة. كتاب فقه وأحكام. اجتماع. سياسة. طبيعة – وبالتالي المخزون المعرفي الذي يمتلكه المفسر. هو الذي يحدد نوع تفسيره. يقول دكتور منيع عبد الحليم أستاذ علوم القرآن في الأزهر: «واختلفت أنظار المفسرين وطرقهم ومناهجهم في التفسير تبعاً لاختلاف مشاربهم. فمنهم من غلبت عليه النزعة الفكرية العقائدية فتوسع توسعاً كبيراً في شرح الآيات المتصلة بهذه المعاني. ومنهم من غلبت عليه النزعة الفقهية الشرعية فتوسع توسعاً كبيراً في هذه النواحي وهكذا من توسع في القصص والأخبار ومن توسع في الأخلاق والتصوف والمواعظ وآيات الله في الأنفس والآفاق وغير ذلك». وهذا لا يعني عدم الاعتراف بالجوانب المضيئة التي تكشف عنها هذه التفاسير، ولكننا نبحث عن المعرفة التي تمثل شمولية وصلاحية الفكر الإسلامي.
إن جذر المشكلة يرتكز على الخلط الذي وقع بين معنى التفسير والتأويل. ففي فهم السلف لم يكن هناك تفريق بين المعنيين.
يقول محمد هادي معرفة: «كان التأويل في استعمال السلف مترادفاً مع التفسير. وقد دأب عليه أبو جعفر الطبري في جامع البيان». وهذا المعنى المترادف أهمل آليات التأويل الخاصة. ولم يجعل لها مميزات تجعل من التأويل مكملاً للتفسير، أو حلقة أخرى تؤسس لبناء معرفي اهتم به النص وأهمله التفسير. وبالتالي حصر الاستفادة من القرآن ضمن إطار الفهم الظاهري الذي ينتجه التفسير فوت على الفكر الإسلامي مكتسبات كانت يمكن أن تساهم في حل معضلاته المعرفية.
وأما البعد الآخر للمعنى التراثي للتأويل. فقد أكتسب معنياً سلبياً واعتبر نوعاً من أنواع التفسير بالرأي. وخاصة بعد أن بدأت تتكرس في الأمة سلطة السلف. التي تحصر الاستفادة من النص ضمن المنقول من أقوال الصحابة. وحينها أصبح التأويل سلاحاً يحارب به أصحاب المدارس العقلية. الذين صنفوا بأنهم أصحاب تأويلات
يقول نصر حامد أبو زيد «وليس هذا المسلك في الفكر الديني الرسمي في الحقيقة مغايراً لمسلك الاتجاهات الرجعية في التراث التي وصمت بدورها كل التأويلات المناقضة لتأويلاتهم بأنها تأويلات -فاسدة -أو مستكرهة – وأنها في أحسن الأحوال تفسير بالرأي المذموم والمنهي عنه من الرسول والصحابة. وقد تم تصنيف أصحاب هذه التأويلات بأنهم من أهل البدع وذلك في مقابل أهل السنة والجماعة وهو تصنيف يستهدف مصادرة الفكر النقيض ومحاصرته وحبسه في دائرة الكفر في مقابل الصدق والإيمان الذي يومئ إليه مفهوم أهل السنة». وبهذا المفهوم حوصرت كل العقليات الإسلامية، التي حاولت تفعيل النص بمعطى عقلي، وأعطي في المقابل التفسير حيزاً استوعب فيه الحدود التي يتحرك فيها التأويل. وذلك إما أن يجعلوا للتأويل معنى مرادفاً للتفسير، وإما أن يصنف عملاً بالرأي وخروجاً عن الدين.
وكل ما يمكن تأكيده هنا هو أن القرآن ينطلق من حقائق تمثل للإنسان هدى وبصائر، وتمتاز هذه البصائر بكونها هي القيم الأساسية للدين، ومن المؤكد أيضاً بأن الله فطر الإنسان على هذه القيم. التي هي في الأساس انعكاس لأسماء الله الحسنى في واقع الإنسان، فحقيقة الإنسان وسر وجوده نابعةٌ من أسماء الله الحسنى، وإن قيمته بمقدار ما يحمله من تلك الأسماء كما أشرنا في أجوبة سابقة.
وإذا اتضحت كل هذه الحقائق لابد حينها أن نعرف أن لغة القرآن لابد أن تكون قائمة على إثارة الفطرة وتنبيه الإنسان لواقع تلك القيم التي يجدها في نفسه. ولغة التذكير والتنبيه هي اللغة الميسورة التي يمكن أن تتسرب إلى وجدان كل إنسان وتهزه من الداخل. حتى تتساقط كل الحجب التي تمنعه من رؤية معاني الكمال في نفسه. وبذلك نكتشف أن للقرآن ظهراً وهو عوامل التنبيه للحقائق التي تقع في باطنه. فظهر القرآن حكم وباطنه علم. والعلم ليس شيء آخر غير جوامع الكلمة وأصول الحِكمة، والوصول إليه يكون من خلال العبور من الظاهر إلى الباطن، وهذا ما يحققه التأويل فظاهر القرآن تنزيل وباطنه تأويل، والتدبر في القرآن هي الآلية التي يرتكز عليها التأويل للوصول إلى باطن النص، ولذلك أرى من الضروري تطبيق هذه النتائج على الروايات التي تحدثت عن التأويل والوظيفة التي يقوم بها.
وهنا نشير إلى ملاحظة. وهي أن التأويل الذي أهمل في الفهم القرآني أو استبعد عند البعض. قد تكرر في القرآن سبع عشرة مرة. في حين أن كلمة تفسير لم ترد سوى مرة واحدة. مما قد يفهم منه تجذيراً لهذا المصطلح في نفسية هذه الأمة، أو إشارة لما يمكن أن يحمله من دلالات جديرة بالوقوف والتأمل فيها. كما لا بد أن نفهم التأويل ضمن الإطار الذي وصف فيه القرآن نفسه بمعنى أنه كتاب حكمة وبصائر فلا يتجاوز التأويل هذا الوصف. قال تعالى ﴿ذَلِكَ مِمّآ أَوْحَىَ إِلَيْكَ رَبّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ وقال: ﴿قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلاُبَيّنَ لَكُم بَعْضَ الّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ﴾، فقرآن بصائر لأننا نبصر به الحياة، قال تعالى: ﴿قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِن رّبّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ﴾، وقال: ﴿هَـَذَا بَصَآئِرُ مِن رّبّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾، وقال: ﴿بَصَآئِرَ لِلنّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لّعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ﴾.
إذا رصدنا كلمة التأويل في الآيات والروايات، يمكننا أن نفهم أن للتأويل معنيين:
المعنى الأول: يمثل حركة من الظاهر إلى الباطن.
والمعنى الثاني: من الباطن إلى الواقع وضبط المتغير.
وكلاهما يشكلان حقيقة واحدة وهي فهم النص وتطبيقه، وبالتالي نعتقد أن التأويل هو الطريق الرابط بين ظاهر الحدث والبنية المحركة لهذا الحدث، فكل حركة على مستوى الظواهر الكونية، أو السلوك الإنساني، تتحرك وفق بنية تحتية تكون بمثابة المحرك للظواهر، فالظاهرة الكونية تتحرك وفق سنن الله في الطبيعة، كما أن السلوك الإنساني على مستوى الإرادة والاختيار، يتحرك وفقاً للغايات، والأهداف، والغرائز، والقيم، وكذا النص يحمل بنية تحتية تمثل الحكمة الباعثة لتشكل النص، فالباطن المقصود بالتأويل هو بمعنى السنة أو الأصل أو الحِكمة الذي يرجع إليها الظاهر، وليس مطلق الباطن.
وإذا رجعنا للبنية اللغوية لكلمة (تأويل) نجدها مأخوذة من (الأول) وهو الرجوع والعودة إلى الأصل ومن هنا (أول) الشيء رجع إلى أسبابه وعلله الحقيقية.
والروايات التي جاءت في هذا الصدد يمكننا تقسيمها كالآتي:
1- روايات تبين أن للقرآن ظهراً وبطناً. جاء في الكافي عن الصادق عن آبائه قال: «قال رسول الله في حديث طويل يصف فيه القرآن ويقول: وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم». تبين هذه الرواية بأن علوم القرآن ومعارفه هي مستبطنة في النصوص، وهو ما يعبر عنه بالباطن. كما أن له ظهر وهو الأحكام.
2- روايات تبين أن بطن القرآن هو التأويل. «فقد جاء في تفسير العياشي، عن الفضيل بن يسار. قال سألت أبا جعفر عن هذه الرواية ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن. ماذا يعني بظهر وبطن؟ قال: ظهره تنزيل وبطنه تأويل..» فهذه الرواية تؤكد. أن عملية التأويل هي التحرك نحو الداخل لاكتشاف بطن القرآن.
3- روايات تبين أن التأويل هو معرفة السنن. ففي تكملة الرواية السابقة يقول الإمام: «ظهره تنزيل وبطنه تأويل منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد، يجرى كما تجري الشمس والقمر». فتؤكد هذه الرواية على أن شمولية القرآن واستمراريته تتحقق وفق عملية التأويل. فهي التي تجعل النص يحتمل خاصية الجري والانطباق.
4- روايات تبين أن هذا البطن الذي لا يدرك إلا بالتأويل. هي الحِكم والقيم التي ترتكز عليها الأحكام. فهي الوحيدة التي تعطي النص خاصية الجري والانطباق. فلا يمكن تصور اتساع الأحكام الجزئية إلى أكثر من مصاديقها المشخصة بها. «جاء في المعاني عن حمران بن أعين قال: سألت أبا جعفر عن ظهر القرآن وبطنه فقال: ظهره الذين نزل فيهم القرآن، وبطنه الذين عملوا بأعمالهم يجري فيهم ما نزل في أولئك»
فعالجت هذه الرواية إشكالية حصر النص بزمان نزول الوحي أو أي زمان آخر. وإنما جعلت للنص خاصية يمكن أن يكون مستوعباً بها كل زمان ومكان. وبالتالي يكون التأويل هو الآلية التي تعطي النص استمراريته. باكتشاف العلة والحكمة التي تكون قاسماً مشتركاً لكل الأزمان، وبالتالي نكون قد خلصنا إلى أن التأويل هو حركة إلى باطن النص، وأن الباطن هو العلة والسبب الموجب للظاهر، ثم تأتي الخطوة الثانية وهي رصد العقل للواقع المعاصر ومن ثم ضبط حركه وفقاً لما تم كشفه من القيم القرآنية.
ولكي نفهم كيف نتعاطى مع القرآن لابد من فهم هدف القرآن. وتحديد الهدف هو الذي يرسم الطريق الموصل إليه. والحَكيم لابد أن يرسم أقصر الطرق للوصول للأهداف التي يرتجيها. وإذا كانت هداية الإنسان وإبصاره طريق الحق لا تكون إلا بالكشف عن قيم الكمال والجمال له، وإذا كانت هذه القيم هي حقائق فطرية أودعها الله في وجدان كل إنسان، وإذا كان الإنسان يغفل عن هذه القيم الفطرية ويجهلها بسبب شهوات الغرائز وضغوط الحياة، حينها لابد أن يكون الطريق هو تذكيره وإثارته حتى ينتبه لواقع تلك الحقائق الفطرية، ومن هنا لم يبدع القرآن وسيلة غير التذكير والتنبيه ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ ولغة التذكير لابد ان تكون واضحة جلية لكل إنسان ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾.
أما التعقل والتفكر فهو نتيجة طبيعة عندما يثار عقل الإنسان وتنكشف عنه حجب الجهل والهوى. فينطلق للتعرف على بواطن النص بما فيه من حِكم. وينطلق لمعرفة آيات الوجود بما فيها من سنن. وكل ذلك يتحقق عبر التوحيد الذي يتجلى عبر أسماء الله الحسنى التي تنعكس في الوجود سنناً وفي القرآن قيماً.
وعليه فإن المساحة التي يبدع فيه العقل المسلم. هي مساحة التأويل. وهي الكشف عن حِكم النص وأصول الحِكمة وجوامع العلم. أما التفسير فيتحرك في دائرة ظواهر النص. الذي هو أحكام مترتبة على تلك الحقائق الباطنية. ومهمة التفسير. هي إظهار ظواهر النصوص بالشكل الذي يتجلى فيه النص كتذكرة وتنبيه.