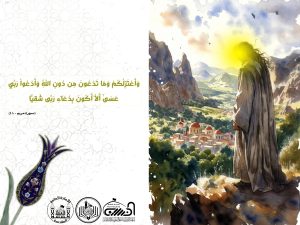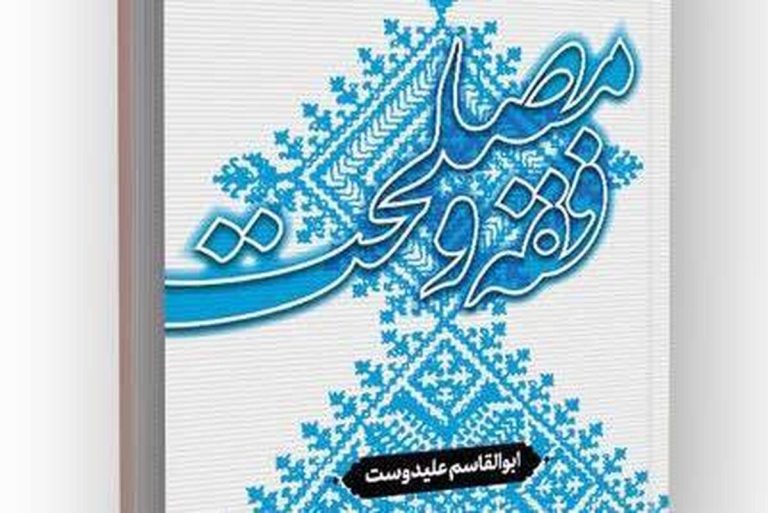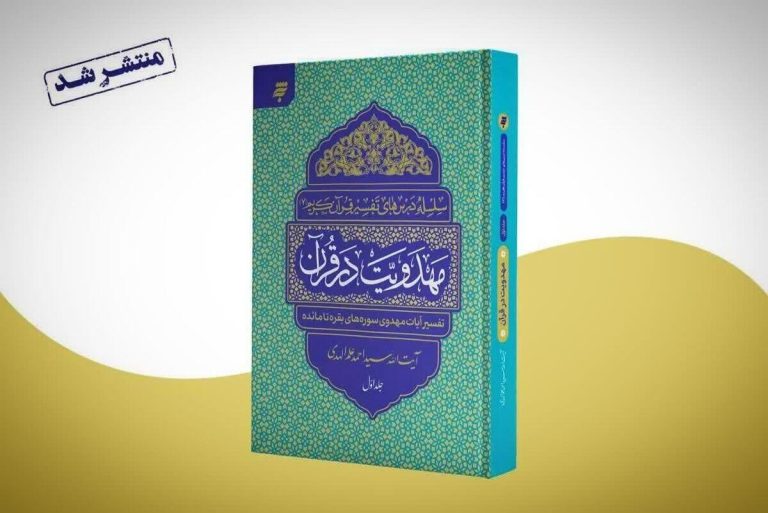من يمكر بالناس ويكيدهم ويحفر لهم الحفائر يرجع مكره إليه، ويرتد إلى نحره، ويقع في ذات الحفيرة التي حفرها لهم، والكشف عن هذه السُّنَّة يُراد منه تحذير الإنسان من الخداع والتآمر والمكر بالآخَرين.
ورُوِيَ عن الإمام علِيَّ (ع) أنه قال: “مَنْ مَكَرَ بِالْنّاسِ رَدَّ اللهُ مَكْرَهُ في عُنُقِه”.
هذه سُنَّة من سُنَنِ الله، والكون كله قائم على السُّنَنِ الربانية، كذلك حركة المجتمع الإنساني، فإنه خاضع لسُنَنٍ ربانية مطَّردة صارمة، لا تتبدّل ولا تتحوَّل، هذه السُّنَّة تُلخِّص عقوبة المكر في الدنيا والآخرة، من يمكر بالناس ويكيدهم ويحفر لهم الحفائر يرجع مكره إليه، ويرتد إلى نحره، ويقع في ذات الحفيرة التي حفرها لهم، والكشف عن هذه السُّنَّة يُراد منه تحذير الإنسان من الخداع والتآمر والمكر بالآخَرين.
المَكر في اللغة: الخِداع والاحتيال وإخفاء الأذى، وفي الاصطلاح: التخطيط السِّري لإيقاع الضَّرر بالآخرين بطرق ملتوية، وهو سيئ لأنه من الغدر، وهو مناف للخلق الكريم، ولا يكون من ذي عقل ونفس شريفة.
ورَدَّ الله مَكْرَهُ فِي عُنُقِهِ: أي جعل عاقبة مكره تعود عليه، فالعنق يُرمز به إلى الحِمل والتَّبِعة، فالماكر يُحمَّل نتائج أفعاله.
لقد ذكر القرآن الكريم هذه السُّنَّة في أكثر موضع فيه، وأكد جريانها في الماكر والماكرين عندما تتكامل أسبابها، من ذلك قوله تعالى: اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿فاطر: 43﴾.
في هذه الاية الكريمة يكشف القرآن الكريم عن جريان هذه السُّنَّة في المستكبرين الماكرين، ويهددهم بمصيرهم المحتوم، فما يصيب مكرهم السَّيئ أحداً إلا أنفسهم، وهو يحيط ويحيق بهم، ويحبط مكرهم وكيدهم، إنهم يحفرون الحفرة التي سيقعون فيها، وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن؟ إنهم لا ينتظرون إلا أن يحِلَّ بهم ما حَلّ بالمكذبين الماكرين من قبلهم، وهو معروف لهم، وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد، فالأمور لا تمضي في الناس جزافاً، والحياة لا تجري في الأرض عبثاً، فهناك سُنَنٌ ثابتة تتحقق، لا تتبدل ولا تتحول، والقرآن يقرر هذه الحقيقة، ويعلِّمها للناس، كي لا يعيشوا الحياة غافلين عن سننها الأصيلة، محصورين في فترة قصيرة من الزمان، وحَيِّز محدود من المكان، فيوجِّههم دائماً إلى ثبات السنن واطّرادها ويوجِّه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع للأجيال قبلهم، ودلالة ذلك الماضي على ثبات السنن واطرادها.
ومنه أيضاً قوله تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿الأنفال: 30﴾.
لقد أجمع المشركون من أهل مكة على الخلاص من رسول الله (ص) واختلفوا في الوسيلة التي يتخلَّصون بها منه، فقال بعضهم: نحبسه ونقيِّده، وقال آخر: بل نُخرجه من مكة، ثم اتفقوا على أن يختاروا من كل قبيلة رجلاً على أن يقتحم الجميع عليه بيته، و هو نائم في فراشه، ويضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل كلها، و يعجز بنو هاشم عن قتال العرب، فأوحى إليه (ص) بذلك، وأمره أن يخرج الى يثرب، و أن يأمر علي بن أبي طالب (ع) بالمبيت في مضجعه، و بات عَليٌ في فراش الرسول، واتشح ببردته، ولما بادر القوم إلى المضجع أبصروا علياً فبُهتوا.
هذا كان مكرهم، وذلك كان كيدهم، وقد أبطل الله هذا المكر، وأفسد هذا الكيد، فجاء أمر رسول الله (ص) على خلاف ما أرادوا وقَدَّروا، لقد حملوه على أن يهاجر من بينهم، ففاتهم بذلك حظهم من نور الله، الذي جعله الله إلى قوم هم أولى به وأحق منهم، وهيّأ الله تعالى لرسوله فرصة كان ينتظرها، بعد أن ضاقت عليه الحال في مكة، فاستقبله أهل يثرب، وبايعوه على السَّمع والطاعة، فأقام فيها دولته المباركة، وتواصل مع ملوك العالم من حوله يدعوهم إلى الإسلام، فدخلت قبائل العرب في الإسلام، وبسط (ص) سيطرته على الجزيرة العربية، وعاد بعد أقلّ من عشر سنين إلى مكة فاتحاً، محطماً أصنام القوم وجبروتهم وكبرياءهم، ولولا مكرهم هذا لما تهيّأ له ذلك، لقد حوَّل الله تهديدهم هذا إلى فرصة، فأصابهم بمكرهم، وردَّه في أعناقهم.
بقلم الكاتب والباحث اللبناني في الدراسات الدينية السيد بلال وهبي