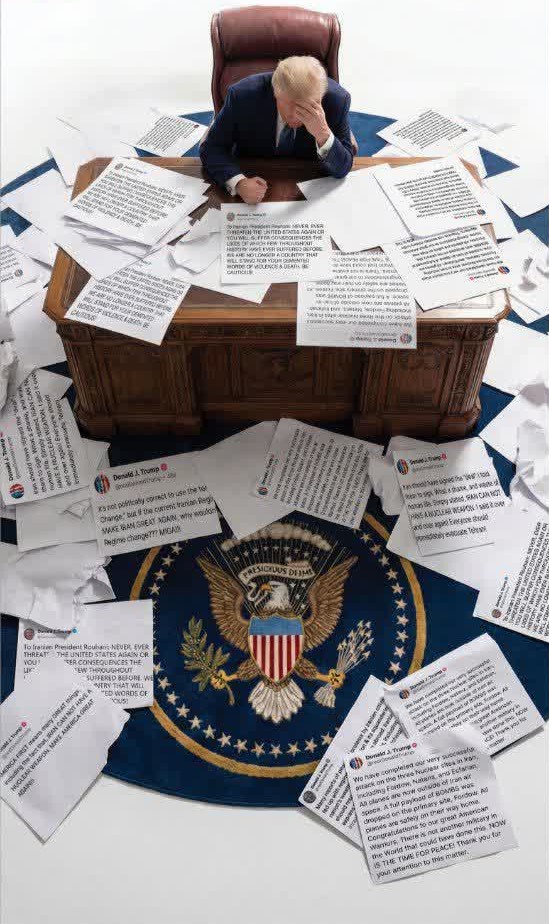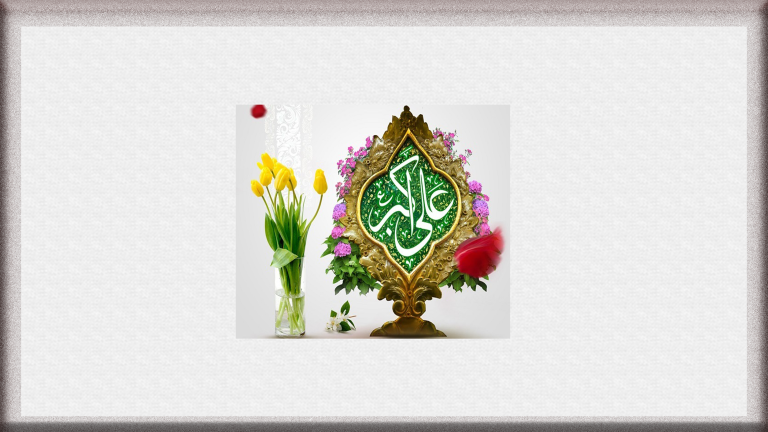من أعظم علاماته الباهرة، جري السُفُن على الماء، كالأبنية العظيمة، إن يرد هبوب الريح تجري بها، وإن يرد سكون الريح فتركد على ظهره، أو يرد إهلاكها بالإغراق بالماء فيهلكهم بسيئات أعمالهم. وفي ذلك آيات للمؤمنين”…
القسم الثاني
آية الله الشيخ جعفر السبحاني
وممّا يدلّ على أنّ القرآن ليس كلام النبي الأعظم هو وجود البون الشاسع بين أسلوب القرآن وأسلوب الحديث النبوي. فمن قارن آية من القرآن الكريم مع الأحاديث القطعية الصادرة منه صلى الله عليه وآله وسلم، أحس مدى التفاوت البعيد بين الأسلوبين، وآمن بأنّ أسلوب التنزيل يغاير أسلوب الحديث. وهذا يدلّ على أنّ القرآن ينزل من عالم آخر على ضمير النبي، بينما الحديث يتكلم به النبي من إنشاء نفسه.
وعلى الجملة، جاء القرآن في ثوب غير الأثواب المعروفة للكلام عند العرب، وفي صورة غير الصور المألوفة، جاء نسيج وحده، وصورة ذاته، لا يشبه غيره، ولا يشبهه غيره. فلا هو شعر، ولا هو نثر، ولا هو من قبيل سجع الحكماء أو العرّافين والكُهّان.
والّذي يمكن أن يقال إنّه قرآن فصّلت آياته، وكل آية لها مقطع تنتهي به، وهو الفاصلة، وهذه هي الظاهرة المحسوسة فيه، يقف عليها من يتصل بالقرآن الكريم، قارئاً كان أو مستمعاً، مؤمناً كان أو غير مؤمن.
وأنت إذا أردت أن تلمس الأسلوب القرآني عن كثب، وتقف عليه وقوف لامس للحقيقة، ومستكشف لها عن قرب. فلاحظ موضوعاً واحداً ورد في القرآن المجيد، وفي كلام النبي الأعظم أو الوصي. فكلاهما يهدفان إلى أمر واحد، ولكن لكل أُسلوبه الخاص لا يختلط أحدهما بالآخر.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وصف الغفلة عن الآخرة: «وكأنّ الموت فيها على غيرنا كُتِب، وكأنّ الحق فيها على غيرنا وَجَب، وكأنّ الّذي نُشَيّع من الأموات سَفَر، عمّا قليل إلينا يرجعون».
وأنت إذا قارنته بما ورد في الذكر الحكيم في هذا المضمار ترى التفاوت بينهما بينا.
يقول سبحانه: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (العنكبوت:64).
فهما قد اتّفقا على وصف معنى واحد، وهو الموت والعود إلى الآخرة، وتصرّم الدنيا وانقضاء أحوالها، وطيّها، والورود إلى الآخرة، ولكن القرآن متميز في تحصيل هذا المعنى وتأديته بأسلوب خاص، تمييزاً لا يدرك بقياس، ولا يعتوره التباس.
وهكذا، لاحظ قول علي عليه السَّلام: «أَمْ هذا الّذي أنشأه في ظُلُمات الأرحام، وشُغُف الأستار، نطفة دهاقاً، وعلقة محاقاً، وجنيناً، ووليداً، ويافعاً» (7).
ثم قارنه إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب ثُمَّ مِنْ نُطْفَة ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ مِنْ مُضْغَة مُخَلَّقَة وَغَيْرِ مُخَلَّقَة لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَل مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُم﴾ (الحج:5).
فإنك ترى الأسلوبين يتغايران جوهراً، ولا يجتمعان في شيء.
نوع آخر من المقارنة: وهناك نوع آخر من المقارنة يتجلى فيها التفاوت بوضوح بين الأسلوبين وهو ملاحظة خطَب الرسول الأعظم وأمير المؤمنين عليهما السَّلام، عندما يخطبان ويعظان الناس بأفصح العبارات وأبلغها، ثم يستشهدان في ثنايا كلامهما بآيٍ من الذكر الحكيم، فعندها يُلمس البون الشاسع بين الأسلوبين، من دون مداخلة شك وريب.
خطَب النبي الأكرم يوم فتح مكة في المسجد الحرام، فقال: «يا معشر قريش إنّ الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم خلق من تراب، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات:13)» (8).
وقال أمير المؤمنين عليه السَّلام، في خطبته المعروفة بالشقشقية: «فما راعني إلاّ والناس كعُرْف الضبع إِليَّ، ينثالون عليّ من كل جانب، حتى لقد وُطئ الحسنان، وشُقّ عِطفاي، مجتمعين حولي كربيضة الغنم. فلما نهضت بالأمر، نكثت طائفة، ومرقت أخرى، وقسط آخرون، كأنّهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص:83).
وقال عليه السَّلام في كلام له لأصحابه في بعض أيام صفين: «وطيبوا عن أنفسكم نفساً، وامشوا إلى الموت مشياً سُجحاً، وعليكم بهذا السواد الأعظم، والرِّواق المُطَنَّب، فاضربوا ثَبَجَه، فإنّ الشيطان كامن في كِسْرِه، قد قدّم للوثبة يداً، وأخر للنكوص رِجلاً، فصَمْداً صَمْداً، حتى ينجلي لكم عمود الحق، ﴿وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾» (محمد:35) (9).
وقال عليه السَّلام في خطبة له عند ذكر المشبهة: لم يعقد غَيْبَ ضَميرِهِ على معرفَتِك، ولم يُباشِر قَلْبِهُ اليقينُ بأنّه لا نِدَّ لك، وكأنّه لم يسمع تَبَرُّؤ التابعين من المتبوعين، إذ يقولون: ﴿تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَل مُبِين * إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الشعراء:97-98).(10)
وقال عليه السَّلام في خطبة له عند ذكر أهل القبور: «وكأن صرتم إلى ما صاروا إليه، وارتهنكم ذلك المضجع، وضمّكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو تناهت بكم الأمور، وبعثرت القبور: ﴿هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْس مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾» (يونس:30) (11)).
وأخيراً، يجب التنبيه على أنّ الأسلوب وحده لا يكفي لجعل الكلام فوق كلام البشر، ما لم ينضم إليه الدعائم الثلاث الأخر، خصوصاً سمو المعاني وعلو المضامين، فإنّ له القسط الأكبر في جعل الأسلوب ممتازاً، تمتدّ إليه الأعناق، وإلاّ فمحاكاة الأسلوب القرآني ملموس في كلام المدّعين للمعارضة مثل مسيلمة وغيره، كما سيوافيك، ولكنه يفقد المضمون الصحيح، والمعنى المتزن، وقد عرفت أن إعجاز القرآن بمعنى كونه خلاباً للعقول، ومبهراً للنفوس رهن أمور أربعة توجب حصول تلك الحالات للإنسان فلا يجد في نفسه أمام القرآن إلاّ السكوت والسكون.
وهناك من خفي عليه دور الأسلوب في رفع شأن القرآن، وزَعَم أنّ إعجاز القرآن ينحصر في الدعائم الثلاث الأُول قال: «إنّ الأسلوب لا يمنع من الإتيان بأسلوب مثله، لأنّ الإتيان بأسلوب يماثله، سهل ويسير على كل واحد، بشهادة أن ما يحكى عن مسيلمة الكذاب من قوله: (إنّا أعطيناك الجواهر، فصلّ لربِّك وجاهر)، يشبه أسلوب القرآن» (12).
ولكنه غفل عن أنّ الأسلوب أحد الدعائم لا الدعامة المنحصرة، حتى أنّ ما ادعاه من أن إعجاز القرآن لأجل الفصاحة، والبلاغة، وجودة النظم وحسن السياق، ليست دعائم كافية لإثبات الإعجاز، إذ في وسع البشر صياغة كلام في غاية الفصاحة والبلاغة مع حسن السياق وجودته، ومع ذلك لا يكون معجزاً لإمكان منافحته ومقابلته والإتيان بمثله، فيلزم على ذلك عدم كون القرآن من تلك الجهة معجزاً. والّذي يقلع الإشكال أنّ الإعجاز رهن هذه القيود الأربعة، وأنّ الإتيان بكلام فصيح غايتها، وبليغ نهايتها، منضماً إلى روعة النظم، في هذا الأسلوب الخاص المعهود من القرآن، أمر معجز. ولذلك لم تجد طيلة هذه القرون حتى يومنا هذا كلام يناضل القرآن في آياته وسوره.
ونضيف، أنّه ليس هنا مقياس ملموس كالأوزان الشعرية لتبيين حقيقة أسلوب القرآن، وإنّما هو أمر وجداني يدركه كل من له إلمام بالعربية.
ولأجل تقريب المطلب نذكر آية، ثم نذكر مضمونها بعبارة أخرى، فترى أنّ العبارة الثانية بشرية، والأولى قرآنية.
قال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالأَعْلاَمِ * إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِكُلِّ صَبَّار شَكُور * أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِير﴾ (الشورى:32-34).
هذا هو الكلام الإلهي.
فلو أراد إنسان أن يصب هذا المعنى بصورة أُخرى، يتغير الأُسلوب، مهما بلغ في الفصاحة والبلاغة من العظمة، فيقال مثلاً:
“ومن أعظم علاماته الباهرة، جري السُفُن على الماء، كالأبنية العظيمة، إن يرد هبوب الريح تجري بها، وإن يرد سكون الريح فتركد على ظهره، أو يرد إهلاكها بالإغراق بالماء فيهلكهم بسيئات أعمالهم. وفي ذلك آيات للمؤمنين”.
فانظر الفرق بين الأُسلوبين، والاختلاف في السبكين، مضافاً إلى افتقاد الثانية بعض النكات الموجودة في الآية.
7-نهج البلاغة، الخطبة 83.
8- السيرة النبوية: لابن هشام، ج 3، ص 273؛ تاريخ الطبري، ج3 ص 120.
9- نهج البلاغة، بتعليق محمد عبده، ص115.
10- نهج البلاغة، بتعليق محمد عبده، ص164.
11- المصدر السابق، ص164.
12- الطراز، ص396