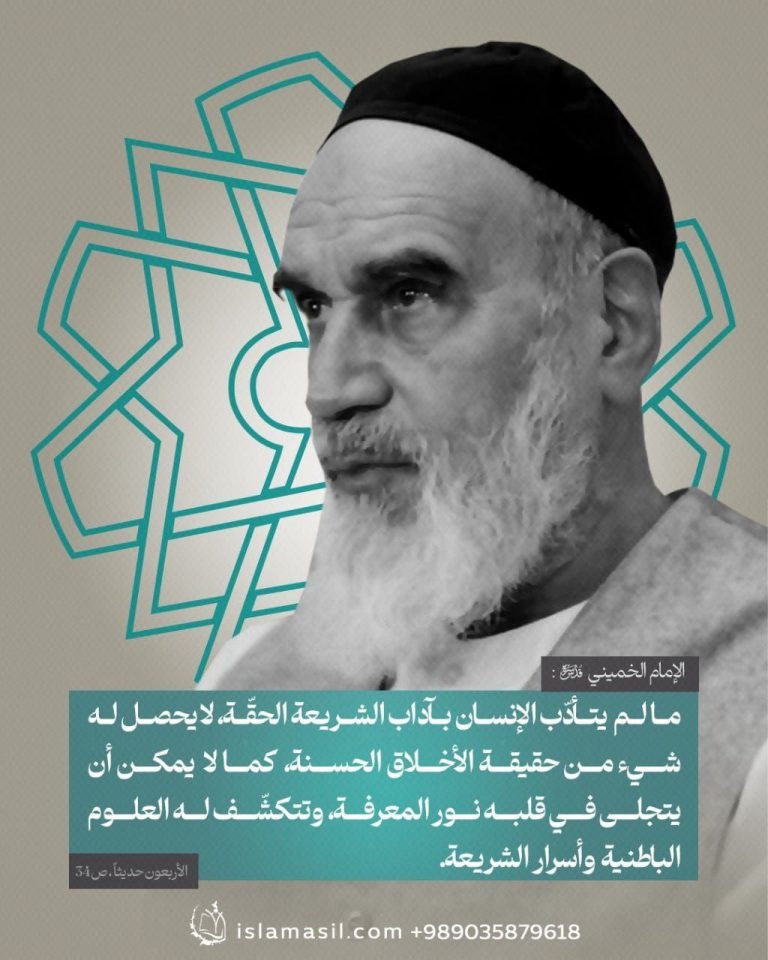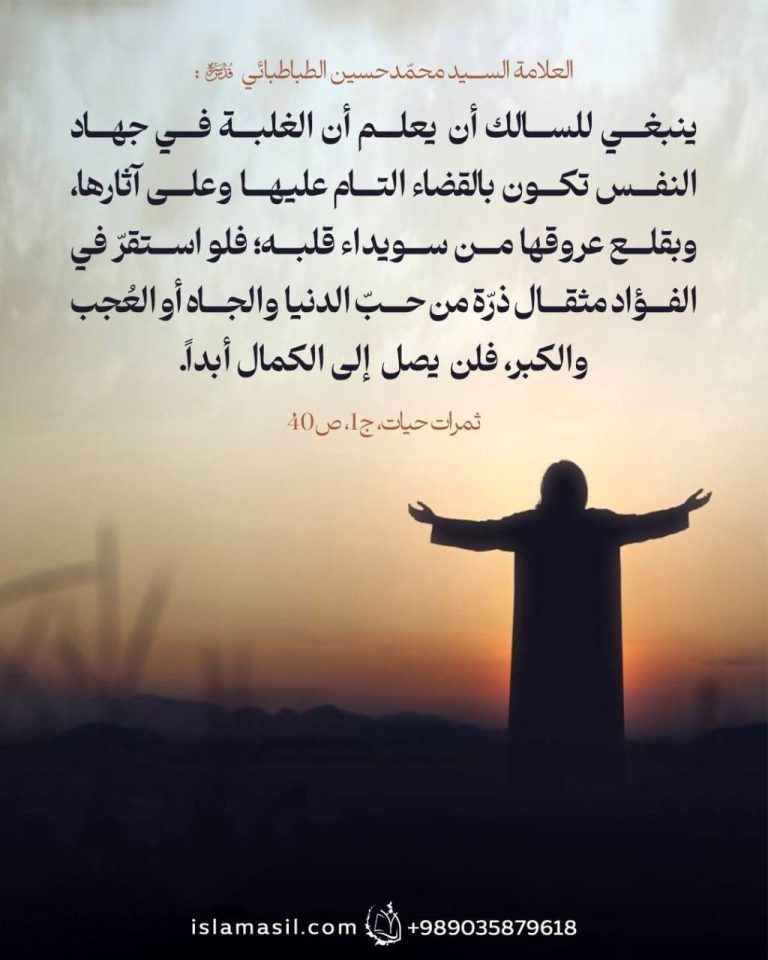الإمام الحسين عليه السلام – مخاطر المرحلة ووسائل المواجهة
الآفات الداخلية والخارجية
لقد تمّ استشراف الأخبار الّتي تهدّد الإسلام كظاهرةٍ عزيزة، قبل ظهور الإسلام أو في بداية ظهوره، من جانب الرّب المتعال. وقد تمّت ملاحظة وسيلة مواجهة تلك الأخطار، وأودعت في نفس الإسلام. وهذه المجموعة كبدنٍ سالمٍ جهّزه الله تعالى بالقدرات الدفاعيّة، وكآلةٍ سالمةٍ يحمل مهندسها وصانعها أدوات إصلاحها معها. فالإسلام ظاهرةٌ، ومثل جميع الظواهر، يهدَّد بأخطار ويحتاج إلى وسائل للمواجهة. وقد جعل الله هذه الوسيلة في الإسلام نفسه. ولكن ما هو هذا الخطر؟ هناك خطران أساسيّان يهدّدان الإسلام، أحدهمّا خطر العدوّ الخارجيّ والآخر هو الاضمحلال الداخليّ.
العدوّ الخارجيّ هو الّذي يستهدف، من خارج الحدود، وجود نظام ما، في فكره وفي جهاز بنيته التحتية العقائدية وقوانينه وكلّ شؤونه، باستخدام جميع أنواع الأسلحة.
فما المقصود من الخارج؟ ليس المقصود من خارج البلد، بل من خارج النظام وإن كان داخل البلد. هناك أعداءٌ يعدّون أنفسهم غرباء عن النظام، ويعارضونه. هؤلاء هم من الخارج غرباء وأجانب. فهؤلاء ومن أجل القضاء على هذا النظام وإزالته، يسعون بالسلاح، والسلاح الناريّ، وباستخدام أكثر الأسلحة المادية تطورّاً، وبالإعلام والمال وكلّ ما في أيديهم. هذا نوعٌ من الأعداء.
العدوّ والآفة الثانية هي آفة الاضمحلال الداخليّ، أي من داخل النظام، وهذا ليس من الغرباء بل من أصحابه وأهله. فمن الممكن لأهل النظام، على أثر التعب أو الخطأ في فهم الطريق الصحيح، أو على أثر تغلّب المشاعر النفسانية، أو على أثر النظر إلى المظاهر المادّية وتعظيمها، أن يصابوا فجأةً بهذه الآفة من الداخل. وبالطبع، إنّ خطر هذا أكبر من الخطر الأوّل.
هذان النوعان من الأعداء – الآفة الخارجية والآفة الداخلية – يكونان بالنسبة لأيّ نظام ولأيّة تشكيلات، ولأيّة ظاهرة. والإسلام وضع علاجاً من أجل مواجهة كلّ من هاتين الآفتين، ووضع الجهاد. الجهاد لا يختصّ بالأعداء الخارجيين، ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾1، فالمنافق هو من داخل النظام. لذلك يجب مجاهدة كلّ هؤلاء. الجهاد هو مقابل العدوّ الّذي يريد أن يهاجم هذا النظام انطلاقاً من رفضه العقائديّ وعدائه له. وكذلك ومن أجل مواجهة ذلك التفكّك الداخليّ، توجد تعاليم أخلاقية مهمّة جداً تفهم الإنسان حقيقة هذه الدنيا، ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾2… أي أنّ هذه الزخارف وهذه المظاهر وهذه اللذائذ الدنيوية، وإن كانت ضروريّة لكم، وإن كنتم مضطرّين لأن تستفيدوا منها وإن كانت حياتكم مرتبطة بها، فلا شكّ في ذلك، ويجب أن تؤمّنوها بأنفسكم، ولكن اعلموا أنّ إطلاقها والتحرّك نحوها بعينٍ مغمضة ونسيان الأهداف هو أمرٌ خطرٌ جدّاً.
أمير المؤمنين عليه السلام هو أسد ميدان مواجهة العدوّ، وعندما يتحدّث فإنّ المرء يتوقّع أن يكون نصف خطبه أو أكثرها راجعاً إلى الجهاد، والحرب، والبطولات. لكن عندما ننظر في روايات وخطب نهج البلاغة نجد أنّ أغلب خطبه ووصاياه راجعة إلى الزهد والتقوى والأخلاق ورفض الدنيا وتحقيرها، وتعظيم القيم المعنويّة والإنسانية الرفيعة. لقد كانت واقعة الإمام الحسين عليه السلام تلفيقاً لهذين القسمين؛ أي أنّ الجهاد مع العدوّ والجهاد مع النفس قد تجلّى في أعلى مراتبه هناك، في واقعة عاشوراء. أي أنّ الله تعالى يعلم أنّ هذه الحادثة ستقع ويجب أن تُظهر المثل الأعلى ليكون قدوةً. كما يحدث في البلاد مع الأبطال عندما يبرزون في مجالٍ ما، ويكون البطل محفّزاً لغيره في ذلك المجال من الرياضة. بالطبع، هذا مثالٌ صغيرٌ من أجل التقريب إلى الأذهان. إنّ واقعة عاشوراء هي عبارة عن حركة عظيمة مجاهدة في كلا الجبهتين. سواء في جبهة المواجهة مع العدوّ الخارجيّ – الّذي هو عبارة عن جهاز الخلافة الفاسد وطلّاب الدنيا، المرتبطين والتّابعين لجهاز السلطة، الّذين أرادوا جعل تلك القدرة الّتي استخدمها النبيّ من أجل نجاة البشر، من أجل تلك الحركة المقابلة لمسيرة الإسلام ونبيّه المكرّم صلى الله عليه وآله وسلم – أم في الجبهة الداخلية حيث كان المجتمع في ذلك الوقت قد تحرّك بشكلٍ عامّ نحو ذلك الفساد الداخليّ.
النقطة الثانية وهي الأهمّ؛ أنّه مرّ مقطعٌ من الزمن، حيث انقضى عهد المصاعب الأساسية للعمل. فالفتوحات قد تحقّقت، وتمّ الحصول على الغنائم، واتّسع نطاق الدولة، وتمّ قمع الأعداء الخارجيّين من هنا وهناك. وتدفقت الغنائم الوفيرة إلى داخل الدولة. وأضحى هناك مجموعة من أصحاب المال الأثرياء، وصار هناك طبقة جديدة من الأشراف؛ أي أنّه بعد أن قلع الإسلام هذه الطبقة وقمعها تشكّلت طبقة جديدة منها في العالم الإسلاميّ. هناك أفرادٌ وتحت اسم الإسلام وبعناوين إسلامية – ابن الصحابيّ الفلاني وابن هذا التابع وهذا المقرّب للنبيّ – دخلوا في أعمال غير لائقة وغير مناسبة. وقد سجّل التاريخ أسماء بعض هؤلاء. كانوا يجعلون مهر بناتهم مليون مثقال من الذهب الخالص أي مليون دينار، بدل أن يكون مهر السنّة، الّذي جعله النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومسلمو الصدر الأوّل من الإسلام، وهو 480 درهماً. من هم هؤلاء؟ هم أولاد صحابة أجلّاء كمصعب بن الزبير وغيره.(06/11/1371)
لقد بدأت القضايا قبل مرور أقلّ من عقدٍ من الزمان على رحيل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية تمتّع أصحاب السابقة في الإسلام – بمن فيهم من صحابة وتابعين وأشخاص قد شاركوا في حروب النبيّ – بالامتيازات. وكان الحصول على عطاءات مالية إضافية من بيت المال أحد هذه الامتيازات. وأضحى هناك عنوانٌ يجعل مساواتهم مع الآخرين غير صحيح، وأنه لا يجوز أن يساوى بهم غيرهم. كانت هذه هي اللبنة الأولى. إنّ التحرّكات الّتي تنجرّ إلى الانحراف تبدأ من هذه النقطة الصغيرة، ومع كلّ خطوة تزداد سرعتها. والانحرافات بدأت من هذه النقطة حتّى وصلت إلى أواسط عهد عثمان. ففي عهد الخليفة الثالث وصل الوضع إلى حدّ أنّ كبار صحابة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أضحوا من أكبر الرأسماليين في زمانهم! إنّهم من الصحابة، أصحاب الشأن الرفيع، المعروفين – كطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وغيرهم – هؤلاء الكبار والوجهاء الّذين كان لكلّ واحدٍ منهم سجلّ ضخم في سابقة المفاخر في بدرٍ وحنين وأُحد، صاروا من الرأسماليين الكبار في الإسلام. عندما توفّي أحدهم وترك الجواهر والذهب، وأرادوا تقسيمها بين ورثته، في البداية جاؤوا بسبائكها وقطعها وأرادوا أن يقسّموها ويقطّعوها بالفؤوس؛ وكأنّها قطعات حطب تحتاج إلى فأس ليقطعها. فالذهب عادةً يتم حسابه وقياسه بالمثاقيل، فانظروا كم كان يمتلك من الذهب حتّى احتاجوا إلى الفأس لتقسيمه. لقد ذُكرت هذه الأمور في التاريخ، وليست من القضايا الّتي ذكرها الشيعة في كتبهم، إنّها حقائق، كان يسعى الجميع لضبطها وتسجيلها. لقد تركوا من الدراهم والدنانير ما يبلغ حدّ الأساطير.(20/03/1375)
عندما نذكر فساد الجهاز من الداخل، فهذا هو معناه: يظهر أفرادٌ في المجتمع يبدأون بالتدريج بنقل أمراضهم الأخلاقيّة المعدية – حبّ الدنيا والشهوات – والّتي هي للأسف أمراضٌ مهلكة إلى باقي أفراد المجتمع. في مثل هذه الحالة، هل سيكون هناك من يجرؤ أو يمتلك الهمّة للمضيّ قدماً في مخالفة جهاز يزيد بن معاوية؟! هل سيحدث مثل هذا الأمر حينها؟ فمن هو الّذي كان يفكّر بمواجهة جهاز الظلم والفساد ليزيد في ذلك الزمان؟ في مثل تلك الأوضاع حدثت النهضة الحسينية العظيمة، الّتي كانت تجاهد العدوّ مثلما تواجه روحيّة السعي للراحة المهلكة المنتشرة بين المسلمين العاديين وعامّتهم. وهذا أمرٌ مهمٌّ.(06/11/1371)
أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام
لو دقّقنا النظر في هذه الحادثة، لعلّه يمكن القول: إنّ الإنسان يستطيع أن يعدّ أكثر من مائة درس مهمّ في هذا التحرّك الّذي قام به الإمام أبو عبد الله عليه السلام في بضعة أشهر، من اليوم الّذي خرج فيه من المدينة نحو مكّة وإلى اليوم الّذي شرب فيه كأس الشهادة العذب في كربلاء. ويمكن القول آلاف الدروس، حيث تُعتبر كلّ إشارة من ذلك الإمام العظيم درساً. لكن عندما نقول أكثر من مائة درس، نعني بذلك أنّه لو أردنا أن ندقّق في هذه الأعمال لأمكننا استقصاء مائة عنوان وفصل، وكلّ فصل يُعتبر درساً لأمّة وتاريخ وبلد ولتربية النفس وإدارة المجتمع وللتقرّب إلى الله. هكذا هو الحسين بن عليّ (أرواحنا فداه وفداء اسمه وذكره) كالشمس الساطعة بين القدّيسين، أي إن كان الأنبياء والأئمّة والشهداء والصالحين كالأقمار والأنجم، فالحسين عليه السلام كالشمس الطالعة بينهم، كلّ ذلك لأجل هذه الأمور.
وإلى جانب المائة درس، هناك درس رئيس في هذا التحرّك والنهضة الّتي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، سأسعى لتوضيحه لكم، وتكون كلّ تلك الدروس بمنزلة الهوامش أمام هذا الّذي هو بمنزلة النصّ الأصليّ، وهو لماذا ثار الحسين عليه السلام ؟ هذا هو الدرس، لماذا ثرت يا حسين رغم كونك شخصية لها احترامها في المدينة ومكّة، ولك شيعتك في اليمن؟ اذهب إلى مكان لا شأن لك فيه بيزيد ولا ليزيد شأنٌ بك، تعيش وتعبد الله وتبلّغ. هذا هو السؤال والدرس الرئيس، ولا نقول إنّ أحداً لم يشر إلى هذا الأمر من قبل، فقد حقّقوا وتحدّثوا كثيراً في هذه القضية. وللإنصاف، ما نودّ قوله اليوم وهو برأينا استنتاج جامع ورؤية جديدة للقضية هو أنّ بعض الناس يودّ أن يقول: إنّ هدف ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام هو إسقاط حكومة يزيد الفاسدة وإقامة حكومة بديلة. هذا القول شبه صحيح وليس بخطأ، لأنّه لو كان القصد من هذا الكلام هو أنّ الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة حكومة بحيث إنّه لو رأى أنّه لن يصل إلى نتيجة لقال لقد قمنا بما علينا فلنرجع، وهذا خطأٌ. فلو كان الهدف إقامة الحكومة فإنّه يجوز للإنسان أن يمضي قدماً ما دام هناك إمكانية. ولهذا عليه أن يرجع مع فقدانها. فلو قال قائل: إن هدف الإمام من هذه الثورة هو إقامة الحكومة العلويّة الحقّة، فهذا غير صحيح، لأنّ مجموع التحرّك لا يدلّ على ذلك.
وبعضٌ على العكس من ذلك، قالوا: ما الحكومة؟ إنّ الحسين عليه السلام كان يعلم بعدم تمكّنه من إقامة الحكومة، إنّه جاء لأجل أن يُقتل ويستشهد. لقد شاع هذا الكلام على الألسن كثيراً لمدّة من الزمن، وكان بعضٌ يبيّن ذلك بعبارات شاعرية جميلة، حتّى أنّني رأيت بعض علمائنا الأجلّاء قد قالوا ذلك أيضاً. فالقول إنّ الإمام عليه السلام ثار لأجل أن يستشهد، لأنّه رأى أنّه لا يمكنه عمل شيء بالبقاء، فقال: يجب أن أعمل شيئاً بالشهادة، لم يكن كلاماً جديداً. وبالنسبة لهذا الكلام أيضاً، ليس لدينا في المصادر والأسانيد الإسلاميّة ما يجوّز للإنسان إلقاء نفسه في القتل، ليس لدينا مثل هذا الشيء. إنّ الشهادة، الّتي نعرفها في الشرع المقدّس والآيات والروايات، معناها أن يتحرّك الإنسان ويستقبل الموت لأجل هدف مقدّس واجب أو راجح. هذه هي الشهادة الإسلامية الصحيحة. أمّا أن يتحرّك الإنسان لأجل أن يُقتل، أو بحسب التعبير الشاعريّ أن يجعل دمه وسيلةً لزلل الظالم وإيقاعه أرضاً، فمثل هذه الأمور لا علاقة لها بواقعةٍ بتلك العظمة. إذاً هذا الأمر وإن كان فيه جانب من الحقيقة لكن لم يكن هدف الحسين عليه السلام. وباختصار لا يمكننا القول إنّ الحسين عليه السلام ثار لأجل إقامة الحكومة، ولا القول: إنّه ثار لأجل أن يستشهد، بل يوجد شيءٌ آخر في البين. أتصوّر أنّ القائلين إنّ الهدف هو الحكومة أو الهدف هو الشهادة قد خلطوا بين الهدف والنتيجة. فقد كان للإمام الحسين عليه السلام هدف آخر، والوصول إليه يتطلّب طريقاً وحركة تنتهي بإحدى النتيجتين: الحكومة أو الشهادة، وكان الإمام مستعدّاً لكلتا النتيجتين، فقد أعدّ مقدّمات الحكم وكذا مقدّمات الشهادة، ووطّن نفسه على هذا وذاك، فإذا تحقّق أيّ منهما، كان صحيحاً، لكن لم يكن أيّ منهما هدفاً، بل كانا نتيجتين، وأمّا الهدف فهو شيءٌ آخر.
بشكل مختصر لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين، ينبغي أن نقول التالي: إنّ هدف ذلك العظيم كان عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤدّه أحد قبله، لا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمير المؤمنين عليه السلام ولا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، واجب يحتلّ مكاناً هامّاً في البناء العام للنظام الفكريّ والقيميّ والعمليّ للإسلام. ورغم أنّ هذا الواجب مهمُّ وأساس، فلماذا لم يؤدَّ حتّى عهد الإمام الحسين عليه السلام ؟ كان يجب على الإمام الحسين عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درساً على مرّ التاريخ، مثلما أنّ تأسيس النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للحكومة الإسلامية أصبح درساً على مرّ تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله درساً على مرّ تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد. كان ينبغي أن يؤدّي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درساً عملياً للمسلمين وعلى مرّ التاريخ.
وأمّا أنّ الإمام الحسين عليه السلام هو الّذي قام بهذا الواجب فلأنّ أرضيّة هذا العمل قد مُهّدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تُمهّد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين عليه السلام، كأن مُهّدت – وعلى سبيل المثال – في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، ولصار هو ذبيح الإسلام العظيم؛ ولو صادف أن حدث ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام لكان على أحدهما أن يعمل به. لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئمّة حتّى عصر الغيبة إلّا في عصر الإمام الحسين عليه السلام. إذاً كان الهدف أداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة أداء الواجب أحد الأمرين، إمّا الوصول إلى الحكم والسلطة والإمام الحسين عليه السلام مستعدّ لذلك، ليعود المجتمع كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وإمّا الوصول إلى الشهادة وهو عليه السلام مستعدّ لها أيضاً. فإنّ الله قد خلق الحسين والأئمّة بحيث يتحمّلون مثل هذه الشهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحمّل الإمام الحسين عليه السلام ذلك.
إنّ النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم – وكذا أيّ نبيّ – عندما بُعث، أتى بمجموعة من الأحكام، بعضها فرديّ من أجل إصلاح الفرد، وبعضها اجتماعيّ من أجل بناء المجتمعات البشرية وإدارة الحياة البشرية. هذه المجموعة من الأحكام يقال لها النظام الإسلاميّ. لقد نزل الإسلام على القلب المقدّس للنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالصلاة والصوم والزكاة والانفاقات والحجّ والأحكام الأسرية والعلاقات الفردية، ثمّ جاء بالجهاد في سبيل الله وإقامة الحكومة والاقتصاد الإسلاميّ، وعلاقة الحاكم بالرعيّة ووظائف الرعيّة تجاه الحكومة. هذه المجموعة من الأحكام عرضها الإسلام على البشر، وبيّنها النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: “يا أيّها الناس والله ما من شيء يقرّبكم إلى الجنّة ويباعدكم من النار إلّا وقد أمرتكم به”3. ولم يبيّن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنساني فحسب، بل طبّقه وعمل به.
فقد أقام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلاميّ، وطبّق الاقتصاد الإسلاميّ، وأقيم الجهاد واستُحصلت الزكاة، فشيّد نظاماً إسلامياً وأصبح النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وخليفته من بعده، مهندس النظام وقائد هذا القطار في هذا الخطّ. كان الطريق واضحاً وبيّناً، فوجب على الفرد وعلى المجتمع الإسلاميّ أن يسير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فإن كان كذلك بلغ الناس الكمال، وأصبحوا صالحين كالملائكة، ولزال الظلم والشرّ والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين الناس، ووصلوا إلى السعادة الكاملة ليصبحوا عباد الله الكمّل. لقد جاء الإسلام بهذا النظام بواسطة النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وطُبّق في مجتمع ذلك اليوم، فأين حدث ذلك؟ في بقعةٍ تُسمّى المدينة واتّسع بعد ذلك ليشمل مكّة وما حولها. وهنا يطرح سؤال وهو: ما هو التكليف لو أنّه جاءت يدٌ أو حادثة وأخرجت هذا القطار الّذي وضعه النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكّة؟ ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإسلاميّ وبلغ الانحراف درجة بحيث خيف من انحراف أصل الإسلام والمبادئ الإسلامية؟
لدينا نوعان من الانحراف. فتارةً يفسد الناس، وهذا ما يقع كثيراً، لكن تبقى أحكام الإسلام سليمة، وتارة ينحرف الناس ويفسد الحكّام والعلماء ومبلّغو الدين – ففي الأساس لا يصدر الدين الصحيح عن قومٍ فاسدين – فيحرّفون القرآن والحقائق، وتبدّل الحسنات سيئات والسيئات حسنات، ويصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، ويحرّف الإسلام 180 درجة عن الاتّجاه الّذي رُسم له. فما هو التكليف لو ابتُلي النظام والمجتمع الإسلاميّ بمثل هذا الأمر؟ لقد بيّن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وحدّد القرآن التكليف ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾4، إضافة إلى آيات وروايات كثيرة أخرى. وأنقل منها هذه الرواية عن الإمام الحسين. لقد ذكر الإمام الحسين عليه السلام هذه الرواية النبويّة للناس، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد حدّث بها، لكن هل كان النبيّ ليقدر على العمل بهذا الحكم الإلهيّ؟ كلّا، لأنّ هذا الحكم الإسلاميّ يُطبّق في عصر ينحرف فيه المجتمع الإسلاميّ ويبلغ حدّاً يُخاف فيه من ضياع أصل الإسلام. والمجتمع الإسلاميّ لم ينحرف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينحرف في عهد أمير المؤمنين عليه السلام بتلك الصورة، وكذا في عهد الإمام الحسن عليه السلام عندما كان معاوية على رأس السلطة، وإن ظهر الكثير من علائم ذلك الانحراف، لكنّه لم يبلغ الحدّ الّذي يُخاف فيه على أصل الإسلام. نعم، يمكن أن يُقال إنّه بلغ الحدّ في برهة من الزمن، لكن في تلك الفترة لم تُتح الفرصة ولم يكن الوقت مناسباً للقيام بهذا الأمر. إنّ هذا الحكم الّذي يُعتبر من الأحكام الإسلامية لا يقلّ أهميّة عن الحكومة ذاتها، لأنّ الحكومة تعني إدارة المجتمع. فلو خرج المجتمع بالتدريج عن مساره وخرُب وفسد، وتبدّل حكم الله، ولم يوجد عندنا حكم وجوب تغيير الوضع وتجديد الحياة أو بتعبير اليوم (الثورة)، فما الفائدة من الحكومة عندها؟ فالحكم الّذي يرتبط بإرجاع المجتمع المنحرف إلى الخطّ الصحيح لا يقلّ أهميّة عن الحكومة ذاتها، ويمكن أن يُقال إنّه أكثر أهميّة من جهاد الكفّار ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العاديين في المجتمع الإسلاميّ، بل وحتّى من العبادات الإلهيّة العظيمة كالحجّ. لماذا؟ لأنّ هذا الحكم – في الحقيقة – يضمن إحياء الإسلام بعد أن أشرف على الموت أو مات وانتهى.
منطلقات الثورة وثمارها الأرضية الممهدة للثورة
إنّه خليفة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الّذي يقع في عصره هذا الانحراف بشرط أن يكون الوقت مناسباً للقيام بذلك، لأنّ الله لا يكلّف بشيء لا فائدة فيه. طبعاً، ليس معنى (أن يكون الوقت مناسباً) هو عدم وجود الخطر، كلّا، ليس هذا هو المقصود. فمعنى هذه العبارة، هو أن يعلم الإنسان أنّ هذا العمل الّذي يقوم به تترتّب عليه نتيجة، أي إبلاغ النداء إلى الناس وإفهامهم وعدم بقائهم على خطئهم. وربّما أنّ الإسلام قد انحرف في عصر الإمام الحسين عليه السلام وكان الوقت مناسباً والأرضية ممهّدة، لذا وجب على الحسين عليه السلام أن يثور. فالشخص الّذي تولّى السلطة بعد معاوية لم يراعِ حتّى ظواهر الإسلام. وكان منغمساً في الخمر والمجون والتهكّم على القرآن، وترويج الشعر المخالف للقرآن والّذي يتهجّم على الدين، ويجاهر بمخالفة الإسلام. غاية الأمر، لأنّ اسمه رئيس المسلمين لم يُرد أن يحذف اسم الإسلام. لم يكن عاملاً بالإسلام ولا محبّاً له، وكان بعمله هذا كنبع الماء الآسن الّذي يفسد ما حوله ويعمّ المجتمع الإسلاميّ. هكذا يكون الحاكم الفاسد، فبما أنّه يتربّع على قمّة المرتفع، فما يصدر عنه لا يبقى في مكانه، بل ينتشر ليملأ ما حوله، خلافاً للناس العاديّين حيث يبقى فسادهم لأنفسهم أو لبعضٍ ممّن حولهم. وكلّ من شغل مقاماً ومنصباً أرفع في المجتمع الإسلاميّ كان ضرره وفساده أكبر. لكن لو فسد من يقع على رأس السلطة لانتشر فساده وشمل كلّ الأرض، كما أنّه لو كان صالحاً، لامتدّ الصلاح إلى كلّ مكان. فشخصٌ مفسدٌ كهذا أصبح خليفة المسلمين بعد معاوية، وخليفة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ! فهل هناك انحراف أكبر من هذا؟
هل أنّ معناه عدم وجود الخطر؟ كلّا، فالخطر موجود. فلا معنى أن يبقى من هو على رأس السلطة ساكتاً أمام معارضيه ولا يخلق لهم المخاطر، بل من البديهيّ أن يوجّه لهم الضربات، فعندما نقول الوقت المناسب، فمعناه أنّ الظروف في المجتمع الإسلاميّ مؤاتية لأن يبلّغ الإمام الحسين عليه السلام نداءه إلى الناس في ذلك العصر وعلى مرّ التاريخ.
فلو أراد الإمام الحسين عليه السلام الثورة في عصر معاوية لدُفن نداؤه، وذلك لأنّ وضع الحكم في زمن معاوية والسياسات كانت بشكل لا يمكن للناس فيه سماع قول الحقّ، لذلك فإنّ الإمام الحسين عليه السلام لم يقل شيئاً طيلة السنوات العشر الّتي كان فيها إماماً في زمن معاوية. لم يفعل شيئاً، لم يُقدم ولم يثُر، لأنّ الظروف لم تكن مؤاتية. الإمام الحسن عليه السلام كان قبله ولم يثر، لأنّ الظروف لم تكن مؤاتية أيضاً. لا أنّ الإمام الحسن عليه السلام لم يكن أهلاً لذلك، فلا فرق بين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجّاد عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام علي النقيّ عليه السلام أو الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام. طبعاً منزلة الإمام الحسين عليه السلام – الّذي أدّى هذا الجهاد – أرفع من الّذين لم يؤدّوه، لكنّهم سواء في منصب الإمامة. ولو وقع في عصر أيّ منهم هذا الأمر لثار ذلك الإمام ونال تلك المنزلة. فالإمام الحسين عليه السلام واجه مثل هذا الانحراف، والظروف كانت مؤاتية، فلا محيص للإمام عليه السلام من تأدية هذا التكليف. فلم يبقَ هناك أيّ عذر. لهذا فعندما قال له عبد الله بن جعفر، ومحمد ابن الحنفية، وعبد الله بن عباس – الّذين كانوا من العلماء والعارفين بأحكام الدين، ولم يكونوا من عامّة الناس – إنّ تحرّكك فيه خطر فلا تذهب، أرادوا أن يقولوا: إنّ التكليف قد سقط عنك لوجود الخطر. لكنّهم لم يدركوا أنّ هذا التكليف ليس بالتكليف الّذي يسقط بوجود الخطر، لأنّ مثل هذا التكليف فيه خطر دوماً، فهل يمكن لإنسان أن يثور ضدّ سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواجه خطراً؟!
إنّ العمل الّذي جرى في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت نسخته المصغّرة في عصر إمامنا الخميني قدس سره. غاية الأمر أنّه هناك انتهى إلى الشهادة وهنا انتهى إلى الحكم، فهما أمرٌ واحد ولا فرق بينهما. فقد كان هدف الإمام الحسين عليه السلام وهدف إمامنا الجليل واحداً، وهذا الأمر يشكّل أساس معارف الإمام الحسين عليه السلام، وإنّ المعارف الحسينيّة تمثّل قسماً عظيماً من معارف الشيعة. فهذا أصلٌ مهمّ وهو نفسه من أركان الإسلام.
فالهدف كان عبارة عن إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلاميّ إلى الصراط المستقيم والخطّ الصحيح. ففي أيّ زمان؟ في الوقت الّذي تبدّل الطريق، وانحرف المسلمون نتيجة جهل وظلم واستبداد وخيانة بعض القوم. بالطبع، يمرّ التاريخ بمراحل مختلفة. فأحياناً تكون الظروف مؤاتية وأحياناً لا تكون. في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت الظروف مؤاتية وكذلك في زمننا. فأقدم الإمام على نفس العمل. كان الهدف واحداً. غاية الأمر، عندما يكون الإنسان متّجهاً نحو هذا الهدف ويريد الثورة على الحكومة ومركز الباطل من أجل إرجاع الإسلام والمجتمع والنظام الإسلاميّ إلى موقعه الصحيح، تارةً يصل إلى الحكومة وتارةً لا يصل إلى الحكومة بل يصل إلى الشهادة. أفلا يكون في هذه الحالة واجباً؟ لو وصل إلى الشهادة لكان واجباً أيضاً. ولا يعني في هذه الحالة أنّه لا يكون مفيداً. فلا فرق هنا إذاً، فهذا القيام وهذا التحرّك مفيدٌ في كلا الحالتين، سواءٌ وصل إلى الشهادة أم وصل إلى الحكومة. غاية الأمر أنّ لكلّ منهما نوعاً خاصّاً من الفوائد. ويجب القيام به والتحرّك نحوه.
وهذا هو العمل الّذي قام به الإمام الحسين عليه السلام. غاية الأمر، أنّ الإمام الحسين عليه السلام هو أوّل من قام بهذا التحرّك، ولم يقم به أحدٌ قبله، لأنّه في زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ما كانت مثل هذه الأرضيّة والانحراف موجودين، أو إذا كان هناك انحراف في بعض الموارد فلم تكن الأرضية مناسبة ولا المقتضي موجوداً(للثورة)، ولقد وُجد كلا الأمرين في زمن الإمام الحسين عليه السلام. وكان هذا هو أساس القضيّة في مورد نهضته عليه السلام.
الثورة تكليف وواجب
ويمكننا أن نلخّص القضية بهذه الصورة: إنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت لتأدية واجب عظيم وهو إعادة الإسلام والمجتمع الإسلاميّ إلى الخطّ الصحيح أو الثورة ضدّ الانحرافات الخطيرة في المجتمع الإسلاميّ. وهذا ما يتمّ عن طريق الثورة وعن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو مصداق عظيم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالطبع، فقد تكون نتيجتها إقامة الحكومة، وقد تكون الشهادة، وقد كان الإمام الحسين عليه السلام مستعدّاً لكلتي النتيجتين. والدليل على ذلك هو ما يستنتج من أقوال الإمام الحسين عليه السلام. وهذه بعض أقوال أبي عبد الله عليه السلام وكلّها تشير إلى هذا المعنى:
أ – عندما طلب الوليد، والي المدينة، الإمام الحسين عليه السلام ليلاً وقال له: إنّ معاوية قد مات وعليك بمبايعة يزيد، ردّ عليه الإمام عليه السلام: “نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالبيعة والخلافة”. وعند الصباح عندما لقي مروان أبا عبد الله عليه السلام طلب منه مبايعة يزيد وعدم تعريض نفسه للقتل، فأجابه الإمام عليه السلام: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمّة براعٍ مثل يزيد”5. فالقضية ليست شخص يزيد، بل أي شخص مثل يزيد، ويريد الإمام الحسين عليه السلام أن يقول: لقد تحمّلنا كلّ ما مضى، أمّا الآن فإنّ أصل الدين والإسلام والنظام الإسلاميّ في خطر، إشارة إلى أنّ الانحراف خطر جدّي، فالقضية هي الخطر على أصل الإسلام.
ب – إنّ أبا عبد الله عليه السلام قد أوصى أخاه محمّد ابن الحنفية، مرّتين: الأولى عند خروجه من المدينة، والثانية عند خروجه من مكّة. ولعلّ هذه الوصية كانت عند خروجه من مكّة في شهر ذي الحجّة – فبعد الشهادة بوحدانية الله ورسالة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإمام عليه السلام: “وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي محمد صلى الله عليه وآله وسلم “6، أي أريد الثورة لأجل الإصلاح لا للوصول إلى الحكم حتماً أو للشهادة حتماً. والإصلاح ليس بالأمر الهيّن، فقد تكون الظروف بحيث يصل الإنسان إلى سدّة الحكم ويمسك بزمام السلطة وقد لا يمكنه ذلك، ويستشهد، وفي كلتي الحالتين تكون الثورة لأجل الإصلاح. ثمّ يقول عليه السلام: “أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾…”7. والإصلاح يتّم عن هذا الطريق، وهو ما قلنا إنّه مصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ج – عندما كان الإمام عليه السلام في مكّة، بعث بكتابين، الأوّل إلى رؤساء البصرة، والثاني إلى رؤساء الكوفة، جاء في كتابه إلى رؤساء البصرة: “وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه، فإنّ السنّة قد أميتت والبدعة قد أحييت، فإن تسمعوا قولي وتجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد”8. أي يريد الإمام الحسين عليه السلام تأدية ذلك التكليف العظيم وهو إحياء الإسلام وسنّة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والنظام الإسلاميّ. وجاء في كتابه إلى أهل الكوفة: “فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائر بالحقّ والحابس نفسه عن ذات الله، والسلام”9. الإمام ورئيس المجتمع الإسلاميّ لا يمكن أن يكون فاسقاً فاجراً خائناً مفسداً بعيداً عن الله، بل يجب أن يكون عاملاً بكتاب الله، وذلك بالطبع على مستوى المجتمع، لا أن يحبس نفسه في غرفة الخلوة للصلاة، بل أن يحيي العمل بالكتاب على مستوى المجتمع، ويأخذ بالقسط والعدل ويجعل الحقّ قانون المجتمع. ولعلّ معنى الجملة الأخيرة هو أنّه يثبّت نفسه على الصراط الإلهيّ المستقيم بأيّ نحوٍ حتّى لا يقع أسير الإغراءات الشيطانية والمادية. أي أنّ الإمام عليه السلام قد بيّن هدفه من الخروج.
د – كان الإمام عليه السلام يخاطب الناس في كلّ منزل ينزل فيه بعد خروجه من مكّة؛ عندما (واجه الحسين عليه السلام جيش الحرّ) وسار بأصحابه في ناحية والحرّ ومن معه في ناحية حتّى بلغ “البيضة” خاطب الإمام عليه السلام أصحاب الحرّ، فقال: “أيّها الناس إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطاناً جائراً مستحلّاً لحُرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعل ولا بقول كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله”10. فالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ما يجب عمله إذا انحرف النظام الإسلاميّ، وقد استند الإمام الحسين عليه السلام إلى قول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا.
فالتكليف هو أن “يُغيِّر بفعل أو قول”، فإذا واجه الإنسان مثل هذه الظروف – وكان الظرف مؤاتياً كما تقدّم – وجب عليه أن يثور ضدّ هذا الأمر ولو بلغ ما بلغ، يُقتل، يبقى حيّاً، ينجح في الظاهر أو لا ينجح. يجب على كلّ مسلم أن يثور أمام هذا الوضع، وهذا تكليف قال به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. ثمّ قال عليه السلام: “وإنّي أحقّ بهذا”11، لأنّي سبط النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المسلمين فرداً فرداً هذا الأمر، كان سبط النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ووارث علمه وحكمته الحسين بن علي عليه السلام أحقّ أن يثور، فإنّي خرجت لهذا الأمر. فيعلن عن سبب وهدف ثورته وهو لأجل “التغيير” أي الثورة ضدّ هذا الوضع السائد.
هـ – كان للإمام الحسين في منزل عُذيب، -حيث التحق به أربعة نفر-: بيانٌ آخر، قال لهم الإمام عليه السلام: “أمّا والله إني لأرجو أن يكون خيراً ما أراد الله بنا قُتلنا أم ظفرنا”12. وهذا دليل على ما تقدّم أنّه لا فرق سواء انتصر أم قُتل، يجب أداء التكليف.
وفي أوّل خطبة له عليه السلام عند نزوله كربلاء، يقول عليه السلام: “وقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون” إلى أن يقول: “ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقّاً…”13 إلى آخر الخطبة. إذاً إنّ ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت تأديةً لواجب، وهذا الواجب يتوجّه إلى كلّ فرد من المسلمين عبر التاريخ، وهو أنّه على كلّ مسلم لزوم الثورة حال رؤية تفشّي الفساد في جذور المجتمع الإسلاميّ بحيث يُخاف من تغييرٍ كلّي في أحكام الإسلام، بالطبع إذا كانت الظروف مؤاتية، وعلم بأنّ لهذه الثورة نتيجة. وليس من الشروط البقاء على قيد الحياة وعدم القتل وعدم التعرّض للتعذيب والأذى والمعاناة. فالحسين عليه السلام قد ثار وأدّى هذا الواجب عملياً ليكون درساً للجميع.(19/03/1374)
لقد قام الإمام الحسين بن عليّ عليه السلام وأيقظ وجدان الناس. لهذا ظهرت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، تلك النهضات الإسلامية الّتي بدأت واحدة تلو الأخرى، والّتي حتماً جرى قمعها. ولكن ليس المهمّ أن يجري قمع التحرّك من قبل العدوّ وإن كان بالطبع مرّاً، ولكن ما هو أمرّ هو أن يصل المجتمع إلى حيث لا يظهر أيّة ردّة فعل مقابل العدوّ، هذا هو الخطر الأكبر.
الثمار الطيبة للثورة الحسينية
لقد قام الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعملٍ، أدّى إلى ظهور أشخاصٍ في جميع عهود الحكومات الطاغوتية، مع أنّهم كانوا أبعد عن عصر صدر الإسلام، لكن كانت إرادتهم للقتال والجهاد ضدّ جهاز الظلم والفساد أكبر من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كان يُقضى عليهم جميعاً. بدءاً من قضية قيام أهل المدينة المعروفة بالحرّة، إلى الأحداث اللاحقة وقضايا التوّابين والمختار الثقفي إلى عصر بني العبّاس، فهناك دائماً في الداخل شعوبٌ تثور. فمن هو الّذي أوجد مثل هذه الثورات؟ إنّه الحسين بن علي عليه السلام. فلو لم يثر الإمام الحسين عليه السلام هل كانت لتتبدّل هذه الروحية الكسولة والمتهرّبة من المسؤولية إلى روحيّة مواجهةٍ للظلم وتحمّل المسؤولية؟ لماذا نقول إنّ روحيّة تحمل المسؤولية كانت ميّتة؟ إنّه بسبب أنّ الإمام الحسين عليه السلام ذهب من المدينة، الّتي كانت مهد الرجال العظام في الإسلام، إلى مكّة. فأبناء العبّاس والزبير وعمر وأبناء خلفاء صدر الإسلام كانوا قد اجتمعوا كلّهم في المدينة، ولم يكن أيّ منهم حاضراً أو مستعدّاً لمساعدة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الثورة الدمويّة والتاريخيّة. إذاً وإلى ما قبل بدء ثورة الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن الخواصّ مستعدّين ليخطوا خطوة واحدة. أمّا بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام فقد أحييت هذه الروحيّة. وهذا هو درسٌ كبير ينبغي أن نضيفه إلى الدروس الأخرى في واقعة عاشوراء. عظمة هذه الواقعة هي هذه. هذا الّذي يُقال: “الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، (هذا الّذي) بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها”14 قبل ولادته، إنّه الحسين بن عليّ عليه السلام الّذي له ذلك العزاء الكبير ونحن نعظّمه. وبحسب هذا الدعاء أو الزيارة البكاء عليه من أجل ذلك. لهذا، عندما ننظر اليوم نرى أنّ الإسلام قد أحياه الحسين بن علي عليه السلام وهو يعدّ حافظ الإسلام.(06/11/1371)
1- سورة التوبة، الآية: 73.
2- سورة الحديد، الآية: 20.
3- الكافي، ج2، ص74.
4- سورة المائدة، الآية: 54.
5- بحار الأنوار، ج 44، ص325-326.
6- بحار الأنوار، ج44، ص329.
7- م. ن.
8- م. ن، ص340.
9- م. ن، ص334.
10- تاريخ الطبري، ج4، ص304.
11- بحار الأنوار، ج 44، ص 382.
12- أعيان الشيعة، ج 1، ص 597.
13- بحار الأنوار، ج 44، ص 381.
14- بحار الأنوار، ج 44، ص 347