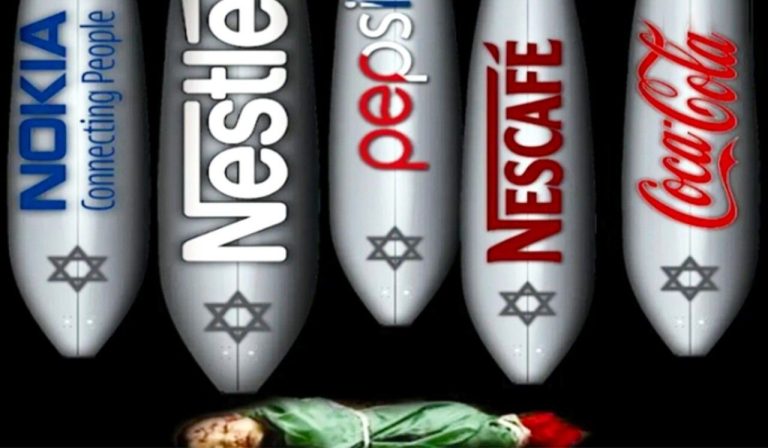المراد بالعلم
المراد بالعلم هو معرفة الإنسان بالكون والكائنات واطلاعه عليها واكتناهه لها وتبصّره في شأنها.
ويشمل العلم طيفاً واسعاً من المعلومات المختلفة الموزعة على علوم مختلفة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: العلوم الفكرية كالفلسفة والرياضيات والهندسة.
الثاني: العلوم الإنسانية مثل علم النفس والإجتماع والتاريخ والأدب وغيرها.
والثالث: العلوم الطبيعية مثل علم الكونيات والأحياء والفيزياء والكيمياء والجغرافيا.
وللإنسان حاجتان إلى العلم…
أ- حاجة ذاتية نفسية، منشأها أن من جملة الغرائز العامة الفطرية للإنسان هو حب الإطلاع على الأشياء واكتناهها ومعرفة أسرارها.
ب- وحاجة عملية لأجل تسيير أموره من خلال العلم على وجه يسعد بها ويراعي مقتضيات الصلاح والحكمة.
ما هو موقف الدين من العلم؟
وعليه يقع الكلام عن علاقة العلم والدين: والموقف الصحيح أن العلم الصائب هو منطلق الدين في مجال اهتمامه، وإعانته عليه، ومن ثمّ يجد الناظر في النص الديني – من خلال القرآن الكريم – أن فيه ثناء كبيراً على العلم، وتشويقاً نحو الإستزادة منه ورفع الجهل، وتقديراً للعالم، قال عزّ من قائل[1]: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ﴾[، وقال الإمام علي عليه السلام[2]: “والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة”، ممّا يعطي انطباعاً عن تكامل الدين والعلم في دورهما في حياة الإنسان، وإعانة كل منهما للآخر في الحقل الذي يهتم به.
بل تؤكد النصوص الدينية على أن الإنسان إنما خُلق لمكان امتيازه في القدرة على التعلم والتفكير والإطلاع، فهو الغاية المنظورة من خلق هذا العالم المادي كما جاء ذلك في قصة خلق آدم في القرآن الكريم حيث أبان الله سبحانه للملائكة سر خلق آدم حيث قال[3]: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾[، ومن ثم اعتبر الإنسان خليفة الله سبحانه على الأرض في هذه الحياة كما قال تعالى[4]: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[.
وعلى ذلك فإن الدين ليس معنياً ببيان الحقائق العلمية في العلوم المختلفة لذاتها، مثل قواعد الأحياء أو الكيمياء أو الفيزياء، لأن ذلك ليس من شأنه، فإن الإنسان زوّد بالرغبات المحفزة له على السعي لإكتشاف سنن الكون واستثمارها في توفير رغباته، كما زوّد بحب الإستطلاع والفهم والتفسير بنحو عام حتى يبحث عن كل شيء غامض في الكون فيطلع عليه. وإنما شأن الدين أن يبلغ الإنسان بالحقائق الكبرى للحياة، وينبهه على شواهد ذلك ومظاهره، ويقوي العقلانية العامة لإعانته في هذا السياق.
طروح أُخر عن علاقة الدين والعلم
وهناك طروح أُخر متفاوتة في العلاقة التفصيلية بينهما..
1- فهناك طرح يرى أنه لا علاقة بين الدين والعلم، ولا انتفاع لأحدهما بالآخر، ولا شأن له به، لأن الدين يتحدث عما وراء الطبيعة، وهو خارج عن حدود العلم والبحث العلمي. نعم، كان الدين من قبل يفسّر وجود الكون والكائنات والظواهر الكونية ولكن العلم الحديث تمكّن من تفسير ذلك كله واستغنى عن التفسير الديني.
2- ويرى طرح آخر أن الدين يجافي العلم من جهات عدّة، منها أنه يدعو إلى الإيمان بأمور وردت فيه مخالفة للمعطيات العلمية.
3- ويرى طرح ثالث أن العلم جزء من رسالة الدين، وقد تضمن الدين بيان كثير من الحقائق العلمية في العلوم المختلفة، بل قيل: إن للقرآن الكريم باطناً يحتوي على جميع العلوم الإنسانية وغيرها، وإن الواقفين على أسرارها يطّلعون من خلاله عليها.
وهذه الطروح الثلاثة كلها مجافية للصواب بالتأمل الجامع في علاقة الدين والعلم.
ولنوضح أولاً الموقف الصحيح المتقدم ثم نتعرض لمناشئ الطروح الثلاثة الأخرى ونوضح الإلتباس الموجب لها.
توضيح تكامل الدين والعلم
فالموقف الصحيح –كما قلنا- تكامل الدين والعلم، بمعنى الإنتفاع المتبادل بينهما من النواحي المختلفة.
بيان ذلك: أن للعلاقة بين الدين والعلم جانبان: (أحدهما): نفع الدين للعلم.
(والآخر): انتفاع الدين بالعلم.
نفع الدين للعلم بتحفيز العقلانية العامة
أما الجانب الأول من نفع الدين للعلم فإن الدين نافع له من وجهين..
(الوجه الأول): عنايته بتحفيز العقلانية العامة في الإنسان، حيث إن الدين – كما نلاحظ من خلال القرآن الكريم – يعتمد على المنطق الفكري الصافي والسليم ويحاجج به، فهو يلقن المرء الإعتماد على البرهان والحجة المقنعة للعقل، ويوجهه إلى التأمل في الكائنات والأشياء، ونبذ الخرافات التي لا برهان عليها، ويشوّق إلى أدوات العلم من الملاحظة والإستقراء والتفكير.
وهذا الأمر من شأنه – بطبيعة الحال – أن يؤدي إلى تقوية المنطق العلمي وتقدّم العلم في الحقول المختلفة. وقد وقع ذلك بالفعل، حيث لوحظ ما تحقق بفضل الإسلام – وما تضمّنه من توجيه إلى العقل والمعرفة – من النهضة العلمية في المجتمع العربي والإسلامي، حتّى صار الرائد في العلوم في وقت كانت البلاد الأوروبية تعاني إنحطاطاً علمياً. ويكفي في الوقوف على أبعاد هذه النهضة ملاحظة التفاوت في حال المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده في مستويات العلم والمعرفة والفلسفة والقانون وما إلى ذلك.
ومن الأبعاد الظريفة لإهتمام الدين بالحفاظ على العقلانية وما يستوجبها من الإهتمام بالعلم أمران…
عدم اعتبار الدين الإيمان بدلاً عن العلم:
(الأمر الأول): أنه لم يعتبر الإيمان بديلاً للعلم في أي حال، فلا بد للمؤمن –في التوصل إلى المقاصد الصحيحة في هذه الحياة – من التوسل بأسبابها، فإن لم يفعل – تكاسلاً – لم يسعفه إيمانه، ولكن في حدود ما تسمح به مقادير الحياة، ولا يكون حاله كحال العالم، فإذا مرض وجب عليه أن يتعالج، وإن لم يفعل بقي مريضاً، وإن ظن ما ليس بعلاج علاجاً خطأ فقد يسعفه الله سحانه – لا سيما إذا رجاه وأمل فيه – بما تتسع له قواعد الحياة وسننها.
وهذا جارٍ حتى فيما كان المقصود نصرة الدين، ومن هنا فقد أوصى سبحانه الناس بالإستعداد للعدو والحذر منه، قال تعالى[5]: ﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾[، وقال[6]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِيعً﴾[، ودعا إلى استخدام أدوات العلم وسننه – من التثبت – قال تعالى [7]: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[، وقال[8]: ﴿فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾[، وأوجب على المؤمنين التمسك بأدوات المعرفة، قال[9]: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾[، كما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمشورة ووعده بالنصرة مع بذل جهده في ما يتأتى له من الأسباب، قال تعالى[10]: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ﴾[. وقد استشار صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوم الأحزاب، فأشار عليه سلمان (رضوان الله عليه) بحفر الخندق.
تفريق الدين بين من أصاب الحقيقة ومن أخطأها ولو عن باعث إيماني
(الأمر الثاني): أن الدين فرّق – بالنسبة إلى الجانب الأخروي – بين من أصاب الحقيقة في مسعاه إلى السلوك الحكيم والفاضل ومن لم يصبها، سواء في جانب المعصية أم في جانب الطاعة..
1. أما في جانب المعصية فإذا ارتكب شخصان عملاً بداعي المعصية، فاتفقت المعصية من أحدهما دون الآخر، فإنه يعاقب العاصي دون الآخر، وهذا في الجزاء الدنيوي واضح، لأنه لم يرتكب مخالفة قانونية. إلا أنه قد يُتوقع تماثل حالهما بالنسبة إلى الجزاء الأخروي، من جهة توقع أن يكون ملاك الجزاء الأخروي هو النية والجهد، وأما الإصابة فهي خارجة عن حدوده.
ولكن لا شك في أن الجزاء الأخروي إنما يكون للعاصي دون الآخر، لعدم تطابق ما اعتقده مع الواقع، فكان اعتقاده جهلاً، وإن كان ما سعى إليه من الإثم ممّا يستوجب نقصان درجته، ولا ينال ما ناله السالم عن مثل هذا المسعى بطبيعة الحال.
2. وأما في جانب الطاعة فإذا ارتكب شخصان عملاً بداعي الطاعة، فأصاب أحدهما دون الآخر لم يتساوَ تقدير الله لعملهما ومكافأته لهما، بالرغم من أنه قد يتوقع الإنسان التسوية بينهما من جهة تساويهما في النية والجهد، وأما إصابة الواقع فخارجة عن حدود اختيارهما، ولكن الشارع ميّز المصيب عن المخطئ ونزّل كلاًّ منزلته، فلم يكن ليسعف هذا مساواته للأول في نيته وجهده، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم[11]: “إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد”.
والمقصود بالإجتهاد في الحديث – عن تقدير صدوره – هو الإجتهاد الصادق الذي يُتحرّى به الوصول إلى الواقع تحرّياً تاماً، دون تساهل، كما في حالات القول بغير علم والاعتداء، ومن ثم ورد في الحديث[12]: “لا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة”، على أنه إنما يكون الأجر على الإجتهاد الخاطئ إذا كان قد بذل جهداً لم يتضرر به أحد، وأما إذا تضرر به أحد – كما لو قتل إنساناً خطأ – فقد جهل جهلاً قبيحاً وكان عليه كفارة. فمن اعتقد – مثلاً – أنه إذا قتل جماعة من الناس لله خطأً واشتباهاً فهو مأجور فقد ارتكب خطأً عظيماً وكان واهماً.
إثراء الدين للعلوم الإنسانية الممتعلقة بمجال اهتمام الدين
(الوجه الثاني) – من وجوه نفع الدين للعلم -: أن العلاقة الوثيقة بين مجال اهتمام الدين – وهو معرفة الحقائق الكبرى والسلوك الفاضل – واهتمامات جملة من العلوم أدى إلى إثراء تلك العلوم الإنسانية في نقاط مهمّة..
السيد محمد باقر السيستاني – يتبع
[1] – سورة الزمر:9.
[2] – نهج البلاغة ص: 496.
لكن ينبغي الإلتفات إلى أن مدح العلم في النصوص عموماً إنما كان النظر فيه إلى العلم الأهم للإنسان، وهو العلم بآفاق هذه الحياة والتبصر فيها من خلال فهم الحقائق الكبرى في الحياة واستحقاقاتها، وتهذيب السلوك الإنساني بالأساليب التربوية الحكيمة.
على أنه ليس المقصود به مجرد معلومات ذهنية يذعن لمرء بها، بل وقع هذه المعلومات في قلب الإنسان ومشاعره بما يتجلى به في إنتظام السلوك العملي للإنسان، كما قال تعالى: ﴿﴾[ (سورة فاطر:28)، وهذا العلم هو الذي يجب على كل إنسان تحصيله والإتبار به في هذه الحياة من المنطلق الفطري – الذي سيأتي شرحه في القسم الثالث من سلسلة (منج التثبت في الدين)-.
نعم بعض هذه النصوص – بالرغم من النظر فيها إلى هذا العلم – قد تضمنت بهذه المناسبة مدح العلم مطلقاً، ولفتت النظر إلى الفرق بين العالم بالشيء والجاهل به فيما يترتب في شأنهما من الآثار، فالعالم بالطب يضمن صحته وينقذ حياته وكذلك يفعل مع الآخرين، ولكن الجاهل به لا يتمكن أن يفعل ذلك، ولو خلي وحده لمرض ومات بعلة كان علاجها يسيراً. فكذلك يكون الحال في سائر ميادين الحياة.
[3] – سورة البقرة: 31.
[4] – سورة البقرة: 30.
[5] – سورة الأنفال: 60.
[6] – سورة النساء:71.
[7] – سورة الحجرات: 6.
[8] – سورة الفتح: 25.
[9] – سورة الشورى: 38.
[10] – سورة آل عمران: 159.
[11] – كنز العمال ج:6 ص:7.
[12] – الكافي ج:1 ص:90.