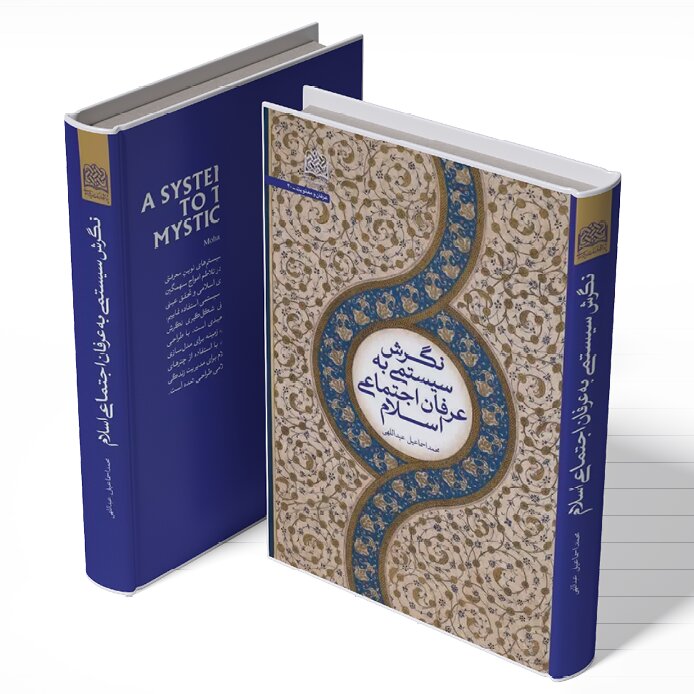موانع العبوديّة لله (2) (العقائد الباطلة)
مقدمة
إنَّ أعظم الكمالات الإنسانيّة هي أن يصل الإنسان إلى الدرجة التي يصبح فيها الحقّ تعالى حاضرًا دائمًا في حياته، فلا يغفل عنه طرفة عين أبدًا، وهذا هو مقام اللقاء والشهادة، وأصحابه هم الشهداء، الذين وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم بأنّهم أحياء عنده يرزقون، ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾1.
ولكن ما يحول بين الإنسان وبين بلوغه هذه المرتبة الإنسانيّة الرّفيعة، موانع ثلاثة هي: الغفلة عن الحقّ، والعقائد الباطلة التي يحملها الإنسان، والرضا بالحياة الدنيا.
تحدّثنا في الدرس السابق عن الغفلة، وسوف نتناول في هذا الدرس المانعَ الثاني، وهو العقائد الباطلة.
معنى العقيدة
العقيدة لغةً مشتقّة من المصدر “عَقْد” الذي يعني الإحكام والشدَّ والربط، وربْطَ الشيءِ بشيءٍ آخرَ أو شَدَّه.
والعقيدة في معناها الاصطلاحي هي مجموعة من المسائل التي تشكّل الرؤية الكونيّة للإنسان، والتي تُشكّل مجموعة من المعتقَدات والنظريّات الكونيّة المتناسقة حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عامّة.
ويمكننا تقسيم الرؤى الكونيّة، على أساس الإيمان بالغيب وإنكاره، إلى قسمين: الرؤية الكونيّة الإلهيّة، والرؤية الكونيّة المادّيّة.
والعقائد الباطلة منشأُها الرؤية الكونيّة غير الإلهيّة، أو تطرُّقُ البِدع إلى الأديان بسبب الانحراف والجهل والعمل بالأهواء والمطامع.
ومن نماذج فساد العقيدة وبطلانها: الشرك بالله تعالى، وعدم الإيمان بيوم الحساب، وإنكار بعثة الرسل، وإنكار الرسالات الإلهيّة…
أهمّيّة العقيدة ودورها في تحديد المصير
إنَّ العقيدة التي يحملها الإنسان تؤثّر تأثيرًا مباشرًا على مصيره، وعلى مقامه عند الله، وعلى درجة قربه منه عزّ وجلّ، وذلك بسبب ارتباطها بسلوك الإنسان وحركته في الخارج، وبأسلوب تعامله مع الآخرين، وتفاعله مع الأحداث التي تجري من حوله. فهي تحثّ الإنسان وتدفعه للتصرّف والعمل بناءً على الخلفيّة الاعتقاديّة التي يحملها ويعتقد بها.. فكلّ إنسان في هذه الحياة إنّما يسير بحسب ما يعتقده. يقول تعالى في كتابه الكريم: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾2.
فمن كان يؤمن بالآخرة وأنّه لا محالة راحل عن هذا العالم، فسوف يسعى لها سعيها، وستكون الدار الآخرة نصب عينيه دومًا، ﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا﴾3.
ومن كان يؤمن بأنّ الله تعالى هو المؤثّر الحقيقيّ في هذا العالم، ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾4، وأنّه الرّازق الحقيقيّ، والمالك لكلّ شيء، والمدبّر لكلّ شيء، ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ﴾5، فسوف يُسْلم وجهَه إليه، ويتوكّل عليه في كلّ أموره، ولن يخشى شيئًا على الإطلاق، لأنّه على يقين أنّه بين يدي ربّ رحيم، لا يريد إلّا الخير والصلاح لعباده.
ومن كان يؤمن بأنّ الله تعالى معه دائمًا أينما يمّم وجهه، ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾6، وأنّه تعالى أقرب إليه من مصدر حياته، ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾7، وأنّه شاهد على كلّ أعماله وحركاته وسكناته، ﴿وَاللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ﴾8، فسوف يستحيي من ربّه، ولن يتجرّأ عليه، ولن يعصيه أو يخالف له أمرًا أبدًا.
ومن يعتقد بأنّه لا محالة راجع إلى ربّه، ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا﴾9، وأنّه كادح إليه كدحًا، ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾10، فإنّه لن يغفل عنه أبدًا، ولن يهدأ له بال أو يسكن له قرار قبل أن يعدّ العدّة اللّازمة لهذا السفر الطويل، ويحضّر كلّ مستلزمات اللقاء بالمحبوب.
من هنا، كان صلاح الإنسان منوطًا في المرحلة الأولى بإصلاح معتقداته ونظرته إلى الخالق والعالم، ورؤيته التي يحملها فيما يتعلّق بالحياة والمصير والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، لأنّ للعقيدة التي يحملها الإنسان الدورَ الأساس في تحديد مصيره ومدى قربه وبعده عن الحقّ تعالى، وعن حقائق الإسلام ومعانيه الراقية.
آثار الاعتقادات الباطلة
للعقيدة التي يحملها الإنسان تأثير على أفعاله وسلوكه في هذه الدنيا، وبالتالي على مصيره في الآخرة، كما أسلفنا. ولو حاولنا الآن أن نعكس الصورة قليلًا، وأتينا بشخص لا يحمل هذه المعتقدات والمبادئ الإسلاميّة الأصيلة، التي ذكرنا بعضًا منها آنفًا، فماذا ستكون النتيجة؟
فالذي لا يؤمن بالله تعالى، ولا يعتقد بأنبيائه ورسله، ولا بالدار الآخرة، والذي لا يرى نفسه في سفر، وأنّه راحل عن هذا العالم إلى عالم الجزاء والحساب، فكيف ستكون عاقبته؟!
هذا الإنسان الذي لا يعتقد بالمعتَقدات الحقَّة، كالحساب الأخرويّ، والكمالات والنّعم التي وُعد بها في الدار الآخرة، سيتصرّف بطريقة يهمِل معها العقاب الإلهيّ، ولا يعطي أيّ أهمّيّة للحياة الآخرة، وللقائه تعالى فيها، وهذا الأمر لا يؤدّي إلى الجهل والفراغ فقط، بل يسمح أيضًا بدخول الآراء الفاسدة والمعتقدات الباطلة، ذلك أنّ النّفس لا تقبل الجهل أبدًا، ولا تستأنس به، وهي ترفض أن لا يكون لديها العلم بما تواجهه من مسائل وقضايا، فإذا لم تحصل على الأجوبة الصّحيحة عن تساؤلاتها، أسرعت إلى تعبئة الفراغ بما لديها من أهواء، وبما يزوّدها به أصحاب الشّبهات. ولا شكّ أنّ الأفكار الخاطئة ستكون سببًا للحرمان ولارتكاب الأخطاء واجتراح المعاصي.
ولهذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: “الجهل أصل كلّ شرّ”11، وهو ما يكون سببًا في الابتعاد عن الله، والحرمان من فيضه العميم.
والله عزّ وجلّ، في ذكره الحكيم، يكشف لنا بعض ما سيؤول إليه حال أصحاب هذه الاعتقادات الخاطئة، ويحذّر من عواقبها الوخيمة، وهي:
1- العذاب الأليم، ﴿وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾12.
2- الخسران والندامة، ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ﴾13.
3- بطلان أعمالهم، ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾14.
4- النسيان، ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾15.
5- العقاب الإلهيّ في الدنيا، ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾16.
6- الحرمان من المغفرة، ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلاَلاً بَعِيدًا﴾17.
وما ينبغي التنبّه إليه جيّدًا أيضًا، أنّ العقائد الباطلة، مع ما لها من عواقب وخيمة على الإنسان المعتقد بها، إلّا أنّ آثارها السلبيّة ليست محصورة فيه، بل إنّ ضررها وتأثيرها السلبيّ قد يصل إلى الآخرين أيضًا، وذلك عندما تدفع هذه المعتقدات الخاطئة بصاحبها، من حيث يقصد أو لا يقصد، إلى الصدّ عن سبيل الحقّ وعن صراطه المستقيم. فعندما يعتقد شخص ما أنّ تهذيب النفس وتزكيتها من الأهواء والأمراض الباطنيّة ليس أمرًا ضروريًّا، أو ينكر، والعياذ بالله، مسألة لقاء الله والرجوع إليه، أو يعتقد بأنّ عبادة الله والعبوديّة له تعالى ليست أمرًا أساسيًّا، وأنّ الإيمان بأيّ دين أمرٌ صحيح ومقبول، وغيرها من الاعتقادات الخاطئة، فمثل هذه الاعتقادات إذا كان صاحبها ذا شأن أو تأثير في محيطه، فمن الممكن أن يكون سببًا في دفع الآخرين إلى الاعتقاد بمثل هذه المبادئ، وبالتالي الانحراف عن جادّة الصواب، والصدّ عن سبيل الله، ومنع الخير عن عباده، ﴿مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾18، وهو يحسب نفسه من المهتدين، ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾19, والحقّ أنّه من الضالّين، ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ﴾20. والله عزّ وجلّ قد نهى عن الصدّ عن سبيله ﴿وَلاَ تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾21، بل ولعن الذين يصدّون عن صراطه، ووصفهم بأنّهم ظالمون، ﴿لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾22.
علاج العقائد الباطلة
بعد معرفة دَور العقائد الفاسدة، وتأثيرها على سلوك الإنسان في الحياة الدنيا، وبالتالي على مصيره في الحياة الآخرة، على اللبيب أن يفكّر مليًّا في كيفيّة التخلّص من هذه الشبهات العقائديّة التي تحول دون ارتباطه بالله عزّ وجلّ، وتحرمه من لقائه، ولا يوجد طريق للتخلّص من هذا المانع والعائق الخطير سوى وسيلة واحدة، هي التعرّف على مبادئ هذا الدين الحنيف وعقائده وتعلّمها. فالعلم والمعرفة بأسس هذا الدين ومعتقداته الأصيلة هو الذي يهدي الإنسان إلى صراط الله المستقيم، وينجيه ويعصمه من الوقوع في المهالك والمزلّات. ومن الطبيعيّ أنّ العلم وحده لا يكفي، بل لا بدّ أن يصحبه العمل بهذه المبادئ والمعتقدات الإسلاميّة، حتّى لا يغدو مصداقًا لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾23, ولأنّ العلم لا يثبت ولا يمكن أن يستقرّ في النفس إلّا بالعمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلّا ارتحل عنه”24. كما أنّ هناك بعض الآداب والأمور التي ينبغي للإنسان المتعلّم التنبّهُ إليها ومراعاتها، وهي:
1- أن يعلم أنَّ ما يعلمه فيما لا يعلمه قليل، لذا عليه أن لا يجيز لنفسه إنكار كلّ ما لا يرقى إلى مستوى فهمه وعقله، بل عليه أن يذره في بقعة الإمكان، فعسى أن يأتي عليه يوم يفتح الله عليه باب العلم به.
2- الاعتراف المسبق باحتمال وجود الأفكار الخاطئة، والآراء الفاسدة لديه، لأنّ الثّقة المطلقة بالنفس تكون عائقًا، في بعض الأحيان، دون الاطّلاع على حقائق الأمور، كما في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: “اتّهموا عقولكم، فإنّه من الثّقة بها يكون الخطأ”25.
3- الصدق والإخلاص في طلب المعارف الإلهيّة، حيث يقصد بعمله وجه الله تعالى، وامتثال أمره، وإصلاح نفسه، وإرشاد عباده إلى معالم دينه، ولا يقصد بذلك عرَض الحياة الدنيا من تحصيل مال أو جاه أو شهرة. فعن الإمام الصادق عليه السلام قال: “من تعلّم لله عزّ وجلّ، وعمل لله، وعلّم لله دُعي في ملكوت السماوات عظيمًا”26.
4- تبادل وجهات النّظر، بعيدًا عن التعصّب. فمن وصيّةٍ لأمير المؤمنين عليه السلام يقول: “اضربوا بعض الرأي ببعض يتولّد منه الصواب”27، وعنه عليه السلام أيضًا: “من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ”28، وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: “من تعلّم العلم ليماري به السفهاء، أَو يباهي به العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه ليُرَئِّسُوه ويُعَظّموه، فلْيتبوّأْ مقعده من النار”29.
5- عدم التسرّع في إعطاء الرأي وإبداء وجهة النظر، والانتظار حتّى تتبلور وتتّضح الفكرة، فتكون قابلة للاعتماد عليها. فعن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: “الرأي مع الأناة”30، وممّا أوصى به عليه السلام ولدَه الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، “أنهاك عن التسرّع في القول والفعل”31.
6- الدعاء وطلب العناية من الله تعالى من خلال التوسّل بأهل البيت عليهم السلام. وهذا له تأثير كبير جدًّا في التوصّل إلى المعتقدات العلميّة والمعارف الحقّة. وعليه، نصل إلى هذه النتيجة، ومفادها أنّ سرّ السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة منوط بعلاقة الإنسان بربّه، وبحضوره تعالى في حياته. فكلّما كان حضور الله تعالى أقوى، كان القربُ منه أشدّ وأكثر. وشرط هذا الحضور الاعتقادُ السليم والصحيح بأنّه تعالى معنا دائمًا، وشاهد علينا، وقريب منّا إلى الحدّ الذي يَحوْل فيه تعالى بيننا وبين قلوبنا، ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾32، وأنّنا إليه راجعون. مثل هذا الاعتقاد، والعمل بمقتضاه، مقدّمةٌ ضروريّة وأساس، تؤهّل الإنسان للارتباط الصحيح والقويّ بالله عزّ اسمه، وتساعده على دوام استحضار وجوده، وعدم الغفلة عنه أبدًا.
* التربية الإيمانية، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1- سورة آل عمران، الآية 169.
2- سورة الإسراء، الآية 84.
3- سورة الإسراء، الآية 19.
4- سورة الأنفال، الآية 17.
5- سورة يونس، الآية 31.
6- سورة الحديد، الآية 4.
7- سورة ق، الآية 16.
8- سورة آل عمران، الآية 98.
9- سورة يونس، الآية 4.
10- سورة الانشقاق، الآية 6.
11- الآمدي، غرر الحكم، ص73.
12- سورة الإسراء، الآية 10.
13- سورة الأنعام، الآية 31.
14- سورة الأعراف، الآية 147.
15- سورة الجاثية، الآية 34.
16- سورة القصص، الآيتان 39 – 40.
17- سورة محمّد، الآية 34.
18- سورة القلم، الآية 12.
19- سورة الزخرف، الآية 37.
20- سورة إبراهيم، الآية 3.
21- سورة الأعراف، الآية 86.
22- سورة الأعراف، الآيتان 44 – 45.
23- سورة الصفّ، الآيتان 2 – 3.
24- العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص33.
25- الآمدي، غرر الحكم، ص56.
26- الشيخ الكليني، الكافي، ج1، ص35.
27- م.ن، ج1، ص1024.
28- العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص29.
29- م.ن، ج2، ص31.
30- م.ن، ج75، ص81.
31- الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج27، ص167.
32- سورة الأنفال، الآية 24.
33- العلّامة المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص33.