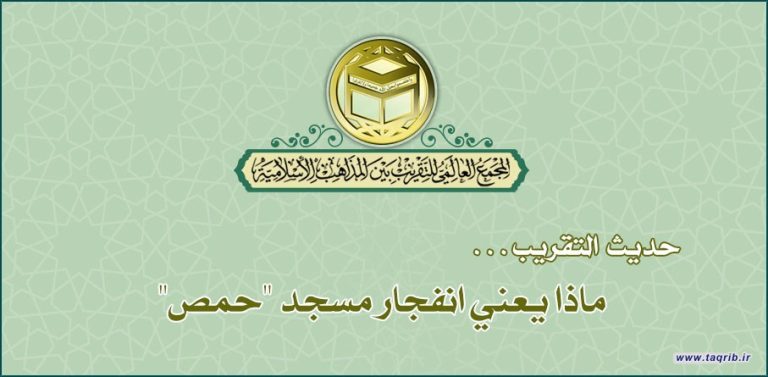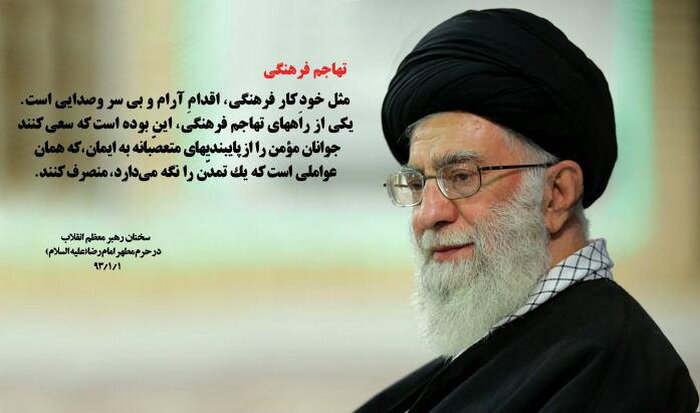لقد بذل الأئمة الهداة (ع) أقصى ما لديهم من جهد ليخلقوا شيعتهم بأخلاقهم، ويقصدوا بهم قصدهم، وسلكوا لذلك كل سبيل، ولم يقتصروا على إلقاء الخطب والمواعظ، والدروس والمحاضرات، وضرب الأمثال والحكم، وإيراد القصص والحكايات، بل أوجدوا لهم آثارا أخرى من غير هذا النوع، وغير الأساليب المألوفة في فن التربية الحديثة ودور المعلمين والمعلمات وعنوا بها عناية خاصة، لأنها أجدى وأبلغ في التأثير والتهذيب.
وقد اصطلح الشيعة على تسمية تلك الآثار التي لا يقدر قدرها إلا من فتح الله عليه باب علمه وهدايته، اصطلحوا على تسميتها بالأدعية والزيارات، ولكنها في واقع الأمر إشراق إلهي يكمل ما في النفس البشرية من نقص، ويطهر ما فيها من رجس، ويصلح ما فيها من فساد، هي وحي ما في ذلك شك، ولكنه وحي المحبة والاخلاص، وفيض الضمير والوجدان الحي أراد أئمة الشيعة أن يجردوا من كل نفس رقيبا ملازما لها في السر والعلانية مسيطرا عليها سيطرة السيد على عبده والقائد على جنده يقربها من الطاعة ويبعدها عن المعصية، فجعلوا لأتباعهم أدعية ومناجاة رتبوها على الأيام والأوقات، وأمروهم بتكرارها ومعاودتها حتى تصبح لهم طبيعة ثانية: فدعاء للصباح، وآخر للمساء، وفي كل يوم من أيام الشهر، وفي كل ليلة من ليالي الجمعة دعاء خاص، ولكل من رجب وشعبان ورمضان ولياليه عشية وسحرا وأيامه ظهرا وعصرا أدعية معينة، وأودعوا هذه الأوراد مكارم الأخلاق بكاملها، وعلى الأصح أودعوها أخلاقهم الكريمة بالذات، وهي لا تعد ولا تحصى، وقد جمعها علماء الإمامية في كتب خاصة، منها الصحيفة السجادبة، والإقبال لابن طاووس، ومصباح الكفعمي، وجامع الأدعية والزيارات نذكر منها في مقامنا هذا بعض الفقرات على سبيل الشاهد والمثال:
“ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي. إلهي لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك
رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني. اللهم ألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وحسن السيرة، والسبق إلى الفضيلة، والقول بالحق وإن عز، والصمت عن الباطل وإن نفع، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، وتفكيرا في قدرتك، وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب غائب أو سب حاضر نطقا بالحمد لك، وإغراقا في الثناء عليك… اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين.. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والحزن والجبن والبخل والغفلة والقسوة والذلة والمسكنة والفقر والفاقة، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع، وصلاة لا ترفع”.
فهل ترى وسيلة أيسر من هذه الوسيلة، وأبعدها أثرا وأعمها نفعا؟ وهل ترى شيئا أقرب إلى النفس، وأدنى من القلب والعقل من هذه الخشية والسكينة؟ وهل أدعى إلى التفكير والتأمل والرجوع بالنفس، إلى بارئها من هذا الشعور الديني الذي يبعث في القلب رغبة ورهبة وحنانا ورحمة إن هذا النحو من التأديب لم يكتشفه فن التربية الحديثة بعد ولم تهتد إليه رجاله الأخصائيون، فلم يكتف الإمام بتعداد المساوئ، وإضافة كل سيئة إلى نتيجتها الطبيعية التي تنفك عنها بحال، وإنما علم الإنسان كيف يتصل بخالقه رأسا ومن غير واسطة، وكيف يخلد إلى ضميره ووجدانه، ويعكف على نفسه فيهذبها ويجرد منها وازعا يقف سدا بينها وبين شهواتها واندفاعاتها، متجها بها إلى الخير والكمال، ناهجاً منهج السعادة والفضيلة.
على هذا الأساس، أساس الشعور بالله وبالخير المطلق، والتجرد من الشهوات والأهواء وتهذيب الأخلاق والطباِع، وتثقيف العقول والمواهب. على هذا الأساس أراد أئمة الشيعة أن يقيموا بنيان الإنسانية لتسيطر المحبة والعدالة، ويعم الأمن والسلام.
وقعت البشرية في أشد مما هي فيه اليوم من الجهل والعدوان، وإفشاء الرذيلة والفحشاء، ولم تنشلها من تلك الهوة السحيقة العميقة القنابل والطائرات، إن هذه تزيد المشاكل تعقدا وتقف حجرة عثرة في سبيل الصلاح والإصلاح لأن الأدواء والأوباء لا تعالج بإيجاد أسبابها الباعثة على نموها وانتشارها، لقد وقع العالم في شر مما هو فيه الآن، فكان خلاصه على يد الرسل الأنبياء، رسل الرحمة والسلام، وأنبياء الإنسانية والعدالة، إن إحياء روح الفضيلة في النفوس هي السبيل الوحيدة الموصلة إلى الراحة وحسن العاقبة والسعادة في الدنيا والآخرة.
ليس الغرض من هذه الأوراد التقرب إلى سبحانه بتلاوتها وترديد ألفاظها، وإنما القصد أن نتفهم معانيها ومغازيها، فتغمر بها نفوسنا، ويستغرق بها تفكيرنا، لنعمل جاهدين معتقدين أن من ورائنا قوة خفية تراقب وتحاسب، فتعين المخلص على جهاده، وتمهد له سبيل النجاح، وتشجعه على المضي والنشاط:
“ربي قوّ على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين”.
وهل القرب من الله غير الجهاد في سبيل الصالح العام؟ وهل السباق في ميادين الله غير المسارعة إلى الفضائل والخيرات؟ وهل الاتصال بخدمة الله غير المثابرة على العمل الذي يعود بالنفع عليك وعلى أهلك وأطفالك؟
“اللهم أعطني السعة في الرزق، والأمن في الوطن، وقرة العين في الأهل والمال والولد والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين”.
إن هذه ثمرات ينتجها السعي مع التوكل على الواحد الأحد، وهل تجد شيئا أمس بالعاطفة، وأسرع تأثيرا وانفعالا من قول الإمام زين العابدين (ع):
” اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعل أوسع رزقك عليّ إذا كبرت، وأحسن أيامي يوم ألقاك”.
وأي حرمة أو هيبة للمرء عند زوجه وأولاده إذا شاب رأسه وقل ماله؟ ولا يوم كيومه الأخير الذي عليه مدار سعادته أو شقائه الأبديين.
وبعد، فإن هذه الكنوز ليست بأدعية ولا أوراد فحسب، وإنما هي كتاب الدهر ومدرسة الحياة، وثروة القلب والعقل، فيجب أن يقرأها المؤمن والملحد، لأنها الوازع الوجداني في هذه الحياة، فضلا عما فيها من لذة ومتعة وجمال.
كان الشيعة الإمامية منذ عهد أئمتهم إلى زمن قريب يحافظون على هذه الآثار ذكورا وإناثا كبارا وصغارا، يجثمون في المساجد وفي البيوت يكررونها خاشعين متضرعين، فيشعر كل واحد أنه خلق لعمل الخير لا للشر، ووجد للطاعة لا للمعصية، ثم أهملوها كما أهملوا غيرها من الشعائر والعادات المقدسة التي كانوا بها مثلا أعلى لصدق الإيمان ورسوخ العقيدة.
المصدر: كتاب الشيعة في الميزان