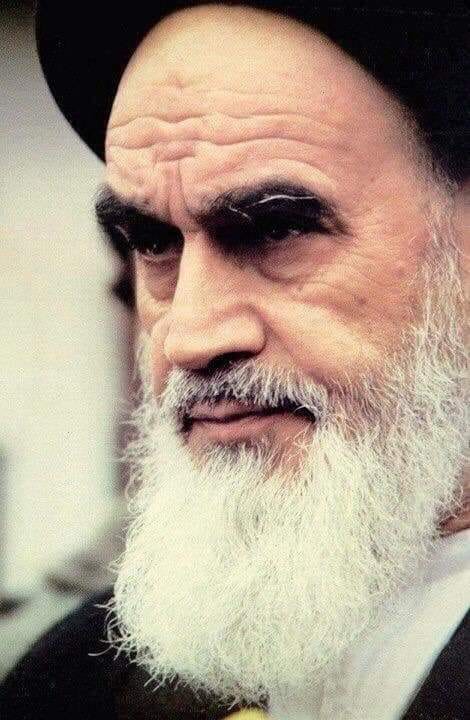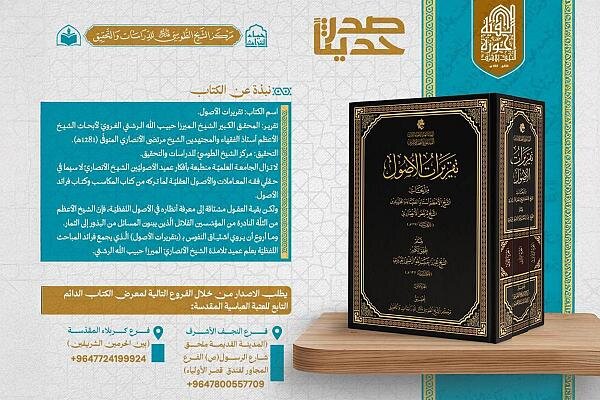1- بداية:
يبدو أن رسالة المهدوية قد لازمت الإنسان منذ بدايات وجوده، لكونها ترتبط ارتباطا مباشرا بفكرة الإنسان الكامل، الذي يحقق الخلافة الإلهية على الأرض، فيعمر الكون، ويعم السلام، وتتحقق العدالة، كما تدل عليه جملة من الآيات القرآنية المباركة.
لقد خلق الله تعالى الإنسان الأول كامل الأوصاف الإنسانية، بحيث عبر عنه تعالى بأنه >بشر<، وصح أن يباهي به الملائكة، فجعله خليفة له دونهم. إلا أن البعد المادي فيه لا يخلو من تأثير أثره عليه، فحصل في الأجيال اللاحقة عليه عنصر المادة في بعض أفراده، مما أدى إلى انتشار الفساد بنسب مختلفة، رغم بقاء العنصر العقلي والروحي مؤثرا فيه كذلك، مما أدى إلى التجاذب والتنافر بين البعدين ونشأت فكرة الإنتظار، وهذا ما نجده في مختلف الأديان السماوية والوضعية، وحتى منكرو الدين بالمعنى الخاص يؤمنون بهذه الفكرة بشكل أو بآخر، وآية ذلك أنا لا نجد فردا أو جماعة إلا ويسعى للكمال في مختلف أبعاد الشخصية الإنسانية، وعلى العموم يمكن القول أن المهدوية ملازمة للفطرة الإنسانية.
2- تمظهرات الفكرة:
قد يبدو للوهلة الأولى أن ملازمة فكرة المهدوية للفطرة مجاف للحقيقة ومخالف للواقع، خصوصا وأن مختلف الملل، ومنها كثير من المسلمين، لا تؤمن بها، بل وتسخر من معتنقيها، والقائلين بها كما تشهد به الملاحظة الميدانية. إلا أن هذا التوهم سرعان ما يزول، إذا صرفنا النظر قليلا عن المصداق الخارجي لهذا المفهوم، بمعنى أننا لم نجمد على عنوان المهدي، ومن هو الشخص الذي يحقق هذا المصداق. على هذا الأساس يمكن أن نلاحظ أن هذه المسألة تتمظهر لدى الجماعات الإنسانية بأشكال ومظاهر مختلفة، ، فتارة تظهر بصورة فكرة كلية يطمح إليها الناس ويعنونها، مرة بالعدالة، وأخرى بالمعرفة، وثالثة بالسيطرة التامة والمطلقة على الكون، ورابعة بالفناء بالروح الكلي وغير ذلك. وتارة أخرى تتجاوز العنوان وتتحدث عن المصداق المحقق لهذا العنوان، فتارة يوصف بأنه المسيح أو المخلص، كما في اليهودية والمسيحية، وأخرى بأنه المهدي كما في الإسلام، وان وقع الإختلاف في شخص المصداق هل هو المسيح ابن مريم(عليه السلام) أم مسيح آخر، وهل هو التاسع من ولد الحسين(عليه السلام) أم مهدي آخر من ولد فاطمة والحسين(صلى الله عليه وآله). إلا أن الجميع متفقون على العنوان العام، وهو خلاص البشرية، على يد إنسان كامل يحكم بينهم بالعدل، ويصل بالإنسان إلى ذروة الكمال، وأن كل ذلك يكون في آخر الزمان، وبعد فشل التجارب الإنسانية، التي يمكن أن يتفتق عنها الذهن البشري عبر التاريخ.
3- في عقائد أهل الكتاب:
إن خير مستند يمكن أن نستند إليه في بيان عقائدهم الأصلية هو الكتاب المقدس بعهديه –القديم والجديد- ذلك أنه وبعد عصر السيد المسيح(عليه السلام)، قد اضطرت الكنيسة لتغيير الكثير من عقائدها تحت ضغط الواقع، وعدم قدرتها على التعامل مع ما تدل عليه نصوصها المقدسة، التي أريد لها أن تكون محكومة لعقائدها القبلية، مع أن المنطق السليم يقضي بأن تكون هذه العقائد هي المحكومة للنصوص المقدسة. ومهما يكن من أمر، فإن اليهود كانوا ينتظرون مجيء من يخلصهم في آخر الزمان من الظلم الذي لحق بهم على مر التاريخ، وقد ظهرت الكثير من النصوص الدالة على هذه الفكرة في العهد القديم، وإن كان بعضها يحصر الخلاف والسيطرة لبني إسرائيل دون سواهم، بواسطة هذا المخلص. فنجد مثلا في سفر أشعياء قوله: >ويخرج قضيب من جذع يسّى وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذته تكون في مخافة الرب فلا يقضي بنظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين، ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفته، ويكون البر منطقة منطقة متينة والأمانة منطقة حقوية، فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معاً وصبي صغير يسوقها…[1]<. وأمثال هذا الحديث كثيرة في الأسفار النبوية في العهد القديم، أي تلك التي تتحدث عن آخر الزمان وفتنه السابقة على الخلاص النهائي.
4- في نصوص العهد الجديد:
وأما في العهد الجديد فالنصوص الدالة على هذه الفكرة كثيرة جدا، إلى حد أن بناء الديانة المسيحية قائم عليها، بل إن مسيحانية السيد المسيح(عليه السلام) مستندة إليها، على نحو يكشف كشفا واقعيا عن مدى ارتباط اليهود وتعلقهم بها، حتى الذين قبلوا دعوة السيد المسيح(عليه السلام) منهم على أساس أنه مخلص آخر الزمان. ولا بد قبل بيان بعض النصوص من بيان المصطلح الذي يعتمده أهل الكتاب في التعامل مع هذه الفكرة، وهو مصطلح “المسيح”. فمن هو المسيح، وما هي دلالات المصطلح، وكيف يمكن التعامل مع النصوص الدالة عليه، فنقول: إن مصطلح المسيح في الكتاب المقدس قد استعمل للدلالة على النبوة والكهانة تارة، وعلى الحكم والملك تارة أخرى، فقد ورد مثلا قوله: >فقال له الرب –أي لإيليا- اذهب راجعا في طريقك إلى برية دمشق، وادخل وامسح حزائيل على آرام، وامسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل، وامسح اليسع بن شافاط من آبل نبيا عوضا عنك[2]<. وقد أطلق لقب المسيح على كثير من الرجال، على داود[3]، وعلى شاول[4]، بل لقد أطلق على قورش ملك الفرس بأنه مسيح الرب[5]. وغلب مصطلح المسيح للدلالة على الملوك، دون أن تهجر دلالته على الكهنة والأنبياء، وصار من قبيل المشترك، الذي يحتاج في دلالته على المعنى المراد إلى قرينة خاصة، خصوصا وأن الكتاب المقدس قد قسم المهام والمناصب بين الأسباط، ومنع من المشاركة فيها من سبط لآخر.
5- ميراث الأسباط:
فقد حصر منصب الملك والقيادة السياسية في سبط يهوذا، كما حصر النبوة والكهانة والقيادة الروحية في سبط لاوي ابني يعقوب، ومنع من أن يتولى شخص واحد أو سبط واحد مهمتين معاً، بل إن لكل سبط مهمته ووظيفته، التي لا يحق له تجاوزها، ولا يحق لغيره الإعتداء عليها. وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا التقسيم، قال تعالى: {ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله،…….، قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا}[6]. ولأجل المحافظة على هذا الميراث منع من تزاوج الأسباط في ما بينهم، بل على كل سبط أن يتزوج من بنات نفس السبط، فقال: >فلا يتحول نصيب من بني إسرائيل من سبط إلى سبط، بل يلازم بنو إسرائيل كل واحد سبط آبائه، وكل بنت ورثت نصيبا من أسباط بني إسرائيل تكون امرأة لواحد من عشيرة سبط أبيها لكي يرث بنو إسرائيل كل واحد نصيب آبائه[7]<. وعلى هذا الاساس فلا بد من ملاحظة النسب والسبط الذي ينتمي إليه الملقب بالمسيح، لنعرف المعنى الذي أريد من هذا اللقب حين اطلاقه عليه، فإن كان من نسل لاوي فلا يصح حمله إلا على معنى النبوة والكهانة، ولا يمكن حمله على معنى الملك، وإن كان من نسل يهوذا فبالعكس.
6- المسيح والملكوت:
لا يخفى أن مصطلح الملكوت قد أصبح في الكتاب المقدس مساوقاً لدولة الحق والعدل، المستندة في أحكامها إلى الله تعالى، وأن يكون السيد المسيح الملك معينا من قبل الله تعالى، ولهذا نجدها في نصوص العهد الجديد مضافاً إليه تعالى أو إلى السماوات. ولما لم يتحقق ذلك في الأزمنة السابقة بعد داود وسليمان(صلى الله عليه وآله)، وظل اليهود يرزحون تحت نير السبي والذل، أخذوا يتطلعون إلى نهاية الأزمنة حيث يأتي المسيح المخلص ويحكم العالم بالحق والعدل، وقد تقدمت بعض النصوص الدالة على ذلك في العهد القديم، كما ورد الكثير منها على لسان السيد المسيح(عليه السلام) في نصوص الأناجيل، حتى أن سفر يوحنا اللاهوتي قد كتب لبيان أحوال آخر الزمان، والفتن التي تقع فيه، ومواصفات الحاكمية والحاكم في زمن الخلاص ودولة الحق. إن جوهر دعوة السيد المسيح(عليه السلام) -كما هو وارد في الأناجيل- هو البشارة باقتراب ملكوت السماوات أو ملكوت الله تعالى. وعلى هذا الأساس نستنتج أن مصطلح المسيح في نصوص أهل الكتاب هي عبارة أخرى عن مصطلح المهدي في النصوص الإسلامية. فلا بد من البحث عن الذي يحقق المصداق الواقعي لهذا العنوان، أي “المسيح” أو “المهدي”، وما إذا كان من الممكن استفادته من النصوص الكتابية، أو النصوص الإسلامية، أو منهما معا، بغية الوصول إلى الغاية المنشودة لدى كافة الأديان.
7- حقيقة الملكوت:
إلا أنه لا بد من محاولة التعرف على حقيقة الملكوت في ثقافة أهل الكتاب، وما إذا أمكن التوافق فيها مع دولة العدل في آخر الزمان لدى المسلمين، من خلال النصوص المقدسة وتصريحات اللاهوتيين، بمعزل عن التأويلات الباردة، وحمل النصوص على الرمزية، الأمر الذي يؤدي إلى سد باب المعرفة، وينتقض الغرض من الدعوات الدينية ورسالة الأنبياء. وفي هذا المجال سنكتفي بنقل بعض ما سطره علماء اللاهوت مما يسلط الضوء على هذه المسألة. قال في معجم اللاهوت الكتابي، بعد الفراغ من تفسير اللاهوت في الحضارات القديمة وفي العهد القديم، على أنه نائب أرضي للملك السماوي، وأنه سيكون في نهاية الأزمنة بحسب العهد القديم، قال: >ان ملكوت الله حقيقة سري لا يستطيع أن يطلعنا على طبيعتها إلا يسوع وحده،…… إلى أن يقول: ويقوم أسلوب الإنجيل التربوي في معظمه على الوحي التدريجي بأسرار الملكوت، وبخاصة في الأمثال[8]<. وشرح صاحب علم اللاهوت الكتابي معنى الملكوت في العهدين بشكل مفصل، وبين أن الملكوت في العهد القديم عبارة عن ملك أرضي، يحكم الناس من خلال قوانين الله تعالى، عبر الحديث عن المسيا الذي سيقيم هذا الملكوت، ثم يقول: >وإنا لنجد يسوع يستخدم في أقواله أسلوب اسخاتولوجية العهد القديم. فالملكوت الذي يعلن عن قربه، هو ذلك الملكوت الذي كان في طي المستقبل في العهد القديم< ولكنه اعتبر ذلك مجرد تمهيد ومرحلة أولى لبيان ملكوت جديد أراد السيد المسيح(عليه السلام) أن يتحدث عنه ويبينه للناس وهو ملكوت روحي[9]. وبعد عملية التأويل الهائلة، وحمل مسألة الملكوت –وكذلك غيرها من المسائل المهمة في النصوص المقدسة عندهم- ظهرت آراء جديدة بين علماء اللاهوت تذهب إلى تفسير النصوص كما كانت عليه الكنيسة الأولى، وأخذت تبشر بعودة ثانية للمسيح ليحكم العالم ويقيم دولة الحق والعدل في نهاية الأزمنة[10]. نستنتج مما تقدم أن المسألة ترتبط أساسا بفهم النصوص الواردة وتفسيرها، وأنها على أي المعاني يجب أن تحمل، هل هو ملكوت روحي لا علاقة له بالواقع والحياة، كما تبنته الكنيسة الرسمية –بشقيها الكاثوليكي والأرثوذكسي- أم أنه ملكوت أرضي يحقق خلافة الله تعالى على هذه الأرض، كما ذهب إليه اليهود والمسلمون وقسم من اللاهوتيين المسيحيين كذلك، بل إن مختلف الاديان تذهب إلى هذا المعنى، مما يؤكد فطرية المسألة كما ذكرناه سابقا، قال في معجم اللاهوت الكتابي: >إن فكرة الملك الإلهي هي فكرة مشتركة بين جميع أديان الشرق القديم، تستخدمها الأساطير لتعطي صفة مقدسة للملك البشري، النائب الأرضي للملك السماوي[11]<.
استنتاج وتعقيب:
نستنتج مما تقدم أن مصطلح “المسيح” و”المخلص” في ثقافة أهل الكتاب معادل ومساوق لمصطلح “المهدي” في الإسلام، وهذه النتيجة يمكن أن تكون محل توافق بين الأديان الثلاثة، بعد مراجعة النصوص المقدسة لديهم، والعمل على تفسيرها، استناداً إلى قواعد التفاهم بين الناس، خصوصاً وأن المسيحيين مجمعون على أن السيد المسيح(عليه السلام) كان يخاطب الناس بلغة بسيطة وسهلة، بعيداً عن التنظير والمصطلحات العلمية والفلسفية، التي لم تكن، وليست متيسرة لعامة الناس كما هو معلوم.
يبقى الكلام في الصغرى، وفي تشخيص من هو القائم على “الملكوت”، أو “دولة الحق والعدل”، هل هو “مسيح” أو مهدي إسرائيلي، كما يذهب إليه اليهود والمسيحيون، أم هو “مهدي” أو “مسيح” من غير بني إسرائيل، بل هو من نسل النبي الخاتم(صلى الله عليه وآله)؟
فهو لا بد من استكشافه، ومحاولة التعرف عليه، من خلال النصوص المقدسة نفسها، وهو ما يشكل مادة حوار بين الأديان كذلك، فيما إذا أردنا الوصول إلى الحقيقة من خلال البحث الجاد والمعمق.
ونحن نزعم أن الوصول إلى الغاية المنشودة أمر ممكن، بل متيسر للباحثين عن الحق بصدق وموضوعية.
وهنا نبادر إلى القول بأن النتيجة التي وصلنا إليها، من خلال دراسة النصوص الكتابية بقسميها –أي العهدين القديم والجديد- تشكل حقيقة ناصعة تقول: إن المخلص والمهدي لا يمكن أن يكون السيد المسيح(عليه السلام) بشخصه، كما يراه المسيحيون، فضلا عن أن يكون إسرائيليا كما يدعيه اليهود، وإنما تؤكد هذه النصوص أنه من أمة خاتم الأنبياء(صلى الله عليه وآله).
وأما تعيين شخصه، وأنه التاسع من ولد الحسين(عليه السلام)، أم غيره من ولد فاطمة الزهراء(عليها السلام)، فهذا ما تتكفل به النصوص الإسلامية خاصة.
سماحة الشيخ حاتم اسماعيل
[1] سفر أشعيا 11و12
[2] سفر الملوك الأول 19/15-16
[3] قاموس الكتاب المقدس، ص859
[4] صموئيل الأول: 24/10
[5] سفر أشعياء: 45/1
[6] سورة البقرة، آية 246-247
[7] سفر العدد: 36/7-8
[8] معجم اللاهوت الكتابي، مادة ملكوت، ص771-772
[9] علم اللاهوت الكتابي ص573-574
[10] علم اللاهوت الكتابي ص581-582
[11] معجم اللاهوت الكتابي ص769