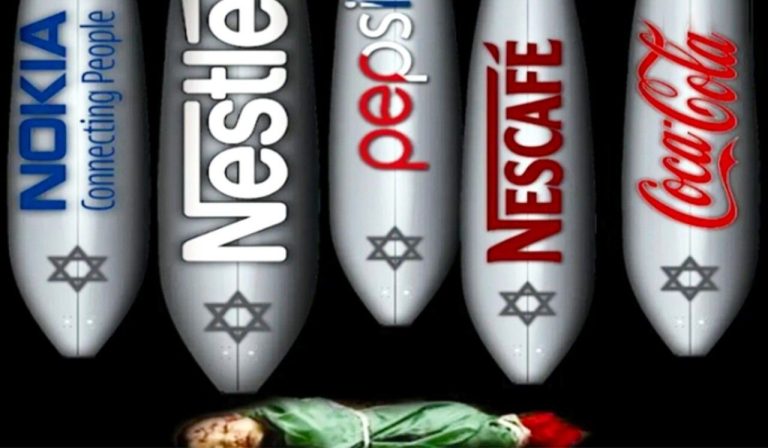إنّ من الأمور اللازمة للسالك في جميع عباداته، ولا سيّما في الصلاة التي هي رأس العبادات ولها مقام الجامعيّة(1)، الخشوع. وحقيقة الخشوع عبارة عن الخضوع التامّ الممزوج بالحبّ أو الخوف. وهو يحصل من إدراك عظمة جلال الله وجماله وسطوتهما وهيبتهما.
* الخشوع من خوف وحبّ
وتفصيل هذا الإجمال هو أنّ قلوب أهل السلوك، بحسب الجِبِلّة والفطرة، مختلفة؛ فبعضٌ منها عشقيّ ومن مظاهر الجمال يأخذهم الخشوع في حيال جمال المحبوب، وبعض من القلوب خوفيّ ومن مظاهر الجلال، فيكون خشوعهم من الخوف، ومن تجلّي الأسماء القهريّة والجلاليّة لقلوبهم، كما كان يحيى (على نبيّنا وآله وعليه السلام). فالخشوع يكون ممزوجاً تارة بالحبّ، وأخرى بالخوف والوحشة، وإن كان في الحبّ وحشة، وفي كل خوف حبّ. ومراتب الخشوع على حسب مراتب إدراك العظمة والجلال والحسن والجمال. وحيث إنّ أمثالنـــا محرومـون من نور المشاهدات فلا بدّ من أن نكون بصدد تحصيل الخشوع من طريق العلم أو الإيمان.
* المؤمنـــون فـــي صلاتهم خاشعون
قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (المؤمنون: 1-2)، فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلائمه؛ فكلّ مَن لم يكن خاشعاً في الصلاة فهو خارج عن زمرة أهل الإيمان؛ طبقاً لما قاله الحقّ تعالى شأنه. قال الإمام الصادق عليه السلام: “إذا دخلت في صلاتك فعليك بالتخشّع والإقبال على صلاتك، فإنّ الله تعالى يقول: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾”.
قال المحقق الكاشانيّ في المحجّة البيضاء ما حاصله: إنّ الخشوع في الصلاة على قسمين:
الأول: الخشوع القلبيّ، وهو أن يكون تمام همّته في الصلاة ومعرضاً عمّا سواها بحيث لا يكون في قلبه سوى المحبوب.
الثاني: الخشوع في الجوارح، وهو يحصل بأن لا يلتفت [المصلّي] إلى الجوانب، ولا تصدر منه حركة سوى الحركات الصلاتيّة، ولا يأتي بشيء من المكروهات.
وأقول: إنّ حقيقة الخشوع عبارة عن حالة قلبية تحصل للقلب من إدراك الجلال والجمال. وبمقدار ما يدرك القلب منهما تزول عنه الإنّيّة والأنانية؛ فيخضع ويسلّم لصاحب الجلال والجمال. وبهذه العناية نُسب الخشوع إلى الأرض والجبال، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ (فصلت: 39)، وهكذا الجبل بالنسبة إلى نزول القرآن قال تعالى: ﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ (الحشر: 21).
* العلم مغاير للإيمان
وبما أنّ صلواتنا ليست مشفوعة بالخشوع، فإنّ ذلك ناجم إمّا عن نقص الإيمان، أو فقدانه. وإن الاعتقاد والعلم مغايران للإيمان، فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وسائر المعارف الإلهية التي لدينا، مغاير للإيمان.
والدليل على ذلك أنّ الشيطان -كما يشهد له الذات المقدّسة الحقّ- عالمٌ بالمبدأ والمعاد، ومع ذلك خاطبه الله سبحانه بلفظ الكافر، وأخرجه من زمرة المؤمنين.
فإذاً، يمتاز أهل العلم من أهل الإيمان، وليس كل من هو من أهل العلم أهلاً للإيمان، فيلزم للسالك أن يدخل نفسه في سلك المؤمنين بعد سلوكه العلميّ، ويوصل إلى قلبه عظمة الحقّ وجلاله وبهاءه، كي يخشع قلبه، وإلّا فمجرد العلم لا يوجب خشوعاً.
* اجتهدوا في معراج القرب
على السالك لطريق الآخرة، وخصوصاً السالك بالخطوة المعراجيّة الصلاتيّة، أن يُحصّل الخشوع بنور العلم والإيمان، وأن يمكّن هذه البارقة الرحمانية في قلبه بمقدار ما يمكنه، فلعلّه يستطيع أن يحتفظ بهذه الحالة في جميع الصلاة من أوّلها إلى آخرها.
وحالة التمكّن والاستقرار [في الصلاة] وإنْ كانت لا تخلو في أوّل الأمر من صعوبة، ولكنّها مع الممارسة والارتياض القلبيّ أمر ممكن جدّاً.
عزيزي، إنّ تحصيل الكمال وزاد الآخرة يستدعي طلباً وجدّاً، وكلّما كان المطلوب أعظم فهو أحرى بالجدّ. ومن الواضح أن معراج القرب إلى حضرة الألوهيّة ومقام جوار ربّ العزّة، لا يتيسّر مع هذا التراخي والفتور والتسامح، فيلزمك القيام بفتوّة [وجدّ] حتى تصل إلى المطلوب، وطالما أنك تؤمن بالآخرة، وتعلم بأن النشأة الآخرة لا يمكن أن تقاس بهذه النشأة من حيث السعادة والكمال ولا في جانب الشقاوة والوبال؛ لأن تلك النشأة عالم أبدي دائم لا موت فيه ولا فناء، والسعيد فيه في راحة وعزّة، ونِعَمٍ ما خطرت على مخيِّلة أحد وكذلك الأمر في جانب الشقاوة، فإنّ عذابها ونَقِمَتها ووبالها ليس لها في هذا العالم مثيل ولا نظير، وتعلم أنّ طريق الوصول إلى السعادة إنّما هو إطاعة ربِّ العزّة، وأنّه ليس في العبادات ما يضاهي هذه الصلاة، وإن قُبلت قبلت جميع الأعمال.
* في الصلاة أنس مناجاة الحقّ تعالى
فلا بدّ لك من الجدّ التام في طلبها ولا تتضايق في السعي إليها ومن تحمّل المشاق في سبيلها مع أنّه ليس فيها مشقّة، بل إنّك إذا واظبت عليها مدّة يسيرة، وحصل لقلبك الأنس بها لتجدنَّ -وأنت في هذا العالم- من المناجاة مع الحقّ تعالى شأنه لَذّات لا تقاس بها لذّة من لذّات هذه الدنيا، كما يظهر ذلك من السير في أحوال أهل المناجاة مع الله سبحانه.
ولا بدّ للسالك ألّا يقنع في حال من الأحوال بالمقام الذي هو فيه. وليتذكّر، في جميع حالاته، نقائصه ومعايبه، فلعلّه ينفتح له طريق إلى السعادة من هذه السبيل، والحمد لله.
(*) مقتبس من: كتاب الآداب المعنويّة للصلاة، روح الله الخميني قدس سره.
1. أي أنّ الصلاة جامعة لجميع مراتب الكمال والمستتر فيها كلّ خير وسعادة. إنْ قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها.