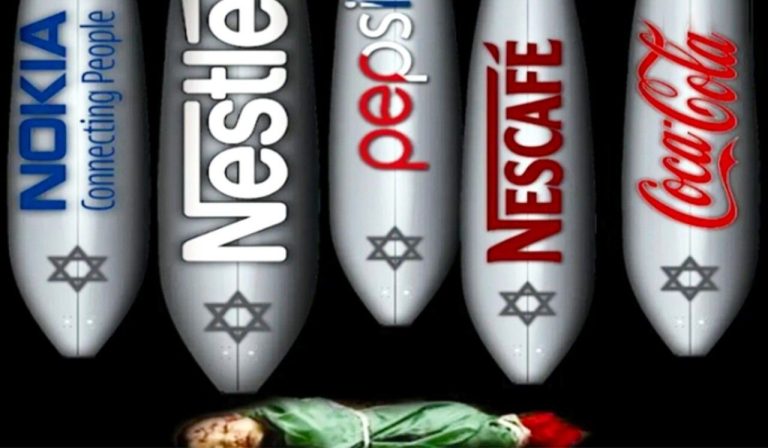{ ماجد الوشلي }
التغيير الاجتماعيّ هو كلّ تحوّل يحدث في المجمتع وينقله من حالة إلى أخرى؛ بسبب التبدّلات التي تطرأ على السلوك والأفكار والعادات والشؤون الإداريّة، وطرق العيش والروابط الاجتماعيّة، والتحوّلات التي تطال الوظائف والقيم والأدوار. وبغضّ النظر عن التقديرات الزمانيّة أو المكانيّة، فقد يكون التغيير في فترة زمنيّة معيّنة، وفي رقعة جغرافيّة محدّدة، ومع أناس خاصّين، وقد تكون المسألة أوسع من ذلك بكثير فتشمل أزمنة متباعدة، وبقاعًا مترامية تناسب كلّ ظرف في مجتمعه وبيئته.
التغيير الاجتماعيّ في القرآن:
أكّد القرآن الكريم على أنّ الأمّة التي يقع فيها الفساد وعبادة الناس لغير الله، فتجد من ينهض لتغيير واقعها، هي أمّة ناجية فائزة في الدنيا والآخرة، أمّا الأمم التي يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها الفاسدون، ولا يوجد من يدفع الظلم والفساد أو يستنكره، فإن سُنّة الله تحكم عليها بالهـلاك والاستئصال[1]، قال تعالى: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (سورة هود، الآية 117). ونلاحظ: «أنّ التأكيد على أهمّيّة دور الإنسان في منهج التغيير الاجتماعيّ أمر ضروريّ لبيان مجال فعل الإنسان، ومناط التكليف في استخلاف الأرض واستعمارها، فالإنسان ومن ورائه قدرة الله هو المؤثّر الأوّل في خطّ سير التاريخ، وفي الأطوار التي تتقلّب فيها الحياة والذي يجعل كلّ تغيير حليفه النجاح هو الإيمان النابع من ضمير الإنسان وعقله»[2]، ومن الملاحظ أنّه ضمن السلسلة التاريخيّة لحركة الإنسانيّة، وخاصّة في سيرة الإنبياء والمُرسلين وفي سياق نشاطهم وتحركهم التغييريّ أنّهم قادوا مجتمعاتهم نحو حياة أفضل وأكمل، ونحو أرقى وجود بشريّ إنسانيّ، وقد ركّز كلّ طرف منهم على حالة اجتماعيّة معيّنة، لها خصوصيّاتها وحيثيّاتها التاريخيّة والاجتماعيّة، واستهدفها بالعلاج والتصحيح، وهذا لا يعني أنّهم اهملوا الجوانب الأخرى المُتعلّقة في المسير الإنسانيّ نحو الكمال أو أنّها لم تكن موردًا لعنايتهم، كما لا يعني أنّ إصلاحاتهم كانت جُزئيّة ومحدودة، بقدر ما يعني أنّ تفشّي ظاهرة مرضيّة اجتماعيّة معيّنة يجعل منها محورًا ومنطلقًا لحركتهم الإصلاحيّة الشاملة لكونها تحتاج إلى جُهد مُضاعف في معالجتها ولكون الأمراض الاجتماعيّة تُشكّل سلسلة مترابطة ومتماسكة، وعلاج الحلقة الأهمّ يعني توجيه بقيّة السلسلة في الاتجاه الصحيح؛ فالإصلاح الاجتماعيّ الحقيقيّ لا يُعطي ثماره إلاّ إذا كان إصلاحًا شاملًا لجميع الحيثيّات والجوانب الحياتيّة.
ونرى أنّ الأنبياء قبل بدء عمليّة التغيير الاجتماعيّ يختبرون الناس ليعرفوا من هم أنصارهم في الإصلاح، فقد دعا نوح قومه إلى طاعة الله واللجوء إلى السفينة التي يُمثّل ركابها أنصاره والمطيعين له، وقد جعلها نجاة لمن ركبها وهلاكًا لمن تخلّف عنها، وجعل طالوت الشرب من النهر الذي مر ّبه علامة لمخالفيه، وكان صيد الحيتان يوم السبت وعبادة العجل، واتباع السّامري، معيار موسى لمعرفة المبطلين، وقد كان نداء «مَنْ أنصاريّ إلى الله» العيسويّ سبيلًا لالتزام خطّ الولاية لله وللرسول، وهكذا كشفت المواقف والأحداث أتباع الأنبياء والمرسلين الحقيقيّين الذين يمكن أن يساهموا ويشاركوا في الدفع بعمليّة الإصلاح الاجتماعيّ للمسيرة الإلهيّة والقرآنيّة.
وقد ارتكزت دعوة كلّ نبي على إصلاح حالة اجتماعيّة معيّنة، فإبراهيم (ص) جاء بالوحدانيّة؛ فنَبَذَ ظاهرة الشرك، وعبادة الآلهة المتفرّقة، ونبّه قومه إلى أنّ المعبود الحقيقيّ هو الربّ الذي لا غياب له ولا أفول، والذي لا يغيب عن علمه وقدرته شيء، فلا الكواكب الآفلة تصلح للعبادة، ولا الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعًا ولا ضرًا. وقد قام بالأمر ذاته هود (ص) في قوم عاد، وزاد صالح (ص) عليهما عندما جعل الله الناقة فتنة لثمود، وأمّا لوط (ص) فقد حارب ظاهرة الشذوذ الجنسيّ والانحلال الأخلاقيّ، وتحمّل شعيب أعباء الإصلاح الاقتصاديّ والماليّ، وسعى للقضاء على الفساد والتلاعب التجاريّ، بينما أرسى موسى القواعد الأساس لقيام دولة المستضعفين، وأصّل عيسى لقيام المجتمع الربانّيّ بمساندة حوارييه.
التغيير من وجهة فلسفيّة:
إنّ المقاربة الرصينة للتغيير الاجتماعيّ تبدأ في الوهلة الأولى من التأصيل الفلسفيّ للظاهرة -التغيير الاجتماعيّ إلى انشغال الفلسفة الاجتماعيّة- حيث يكشف الفكر الفلسفيّ عن زخم كبير من المساهمات الفلسفيّة التي أثارت إشكاليّة التغيير، فمنذُ الفكر الفلسفيّ اليونانيّ لم تتوقّف الآراء الفلسفيّة عن معالجة هذه الإشكاليّة، وإن تفاوتت في الطرح والتصوّر؛ «إذ نجد المفكر الهيراقليطسيّ لم يبتعد عن إثارة التغيير التي كانت قضيّة فلسفيّة مركزيّة في إسهاماته الفلسفيّة، وحاول من خلالها دحض آراء خصومه التي كانت تركز على الثبات، فدافع هيراقليطس عن تغيير الكائنات والموجودات، وسار أرسطو في الاتجاه نفسه الذي رسمه هيراقليطس، حيث ساهمت كتاباته وإنتاجاته الفلسفيّة في رسم معالم فكر يؤمن بأهمّيّة التغيير، ودافع عنها بالتركيز على مبدأ الصيرورة في حياة الكائنات والموجودات»[3].
أهداف التغيير الاجتماعيّ:
يبدأ التغيير الاجتماعيّ العمليّ من نفس الإنسان؛ لذا تؤكّد النظريّات والرؤى الاجتماعيّة والقرآنيّة التي تتحدّث عن التغيير على أنّ الإصلاح الفرديّ لا بدّ أن يكون منطلَقًا للإصلاح المجتمعيّ، (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (سورة الرعد، الآية11).
وقد سعى الأنبياء والرسل والمصلحون من خلال رسالاتهم وعقائدهم إلى إيجاد التغيير الاجتماعيّ، ونقل المجتمعات إلى الحالة المثاليّة؛ لما لذلك من أهمّيّة وقُدسيّة، فالتغيير الاجتماعيّ يرتبط جوهريًّا بالفعل الإنسانيّ؛ لأنّه المظهر الديناميكيّ للمجتمع، والحركة المستمرّة والمتتابعة التي تتمّ من خلال التفاعل الاجتماعيّ عبر الزمن. وهذا التفاعل يُعبّر عن أنماط من العمليّات والانتقال والتنمية والتقدّم التي تتمّ عن طريق الاختلافات والتعديلات التي تطرأ في الطبيعة والجماعات والعلاقات الاجتماعيّة، ومنها: السلوك الاجتماعيّ الذي يتمثّل في العادات والأعراف والنظم واللغة عبر تتابع الزمن.
وينظر المنهج الإلهيّ إلى الدور الإيجابيّ المتعلّق بإرادة الإنسان لإحداث التغيير الاجتماعيّ ضمن الرؤية التي تحدّدها العقيدة الإسلاميّة الصحيحة، ويعمل على تنميته، وعندما تتوافر الإرادة والقصد للتغيير لدى الإنسان يتجمّع ليشكّل جماعة تشاركه الرؤية في عمليّة التغيير الاجتماعيّ.
——————————-
[1]ـ يراجع: السيد قطب: في ظلال القرآن، ط15، دار الشروق، القاهرة، (لا ت)، مجلد 4، ص933.
[2] السيد قطب: مقوّمات التصوّر الإسلاميّ، ط1، دار الشروق، القاهرة، 1986م، ص 21.
[3]- إدوارد تايلور، الثقافة البدائيّة، الأبحاث في اتجاه تطوير الأساطير والفلسفة والدين والعرف، مقال في مجلة نزوى،ص2