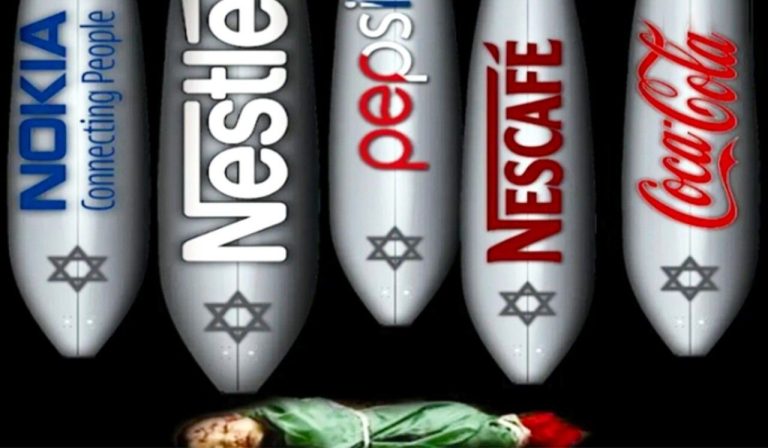لا نذهب بعيدا ونغور في التاريخ القديم للأمم والشعوب، بل نبدأ بصور من بداية العصر النبوي، ونتحدث عن الطبيعة الصهيونية التي طُبع بها اليهود التلموديون، وذلك نتيجة عدة عوامل وظروف تاريخية ونفسية مرت بهم، إضافة لترسخ العامل الحسي الذي يعتمدونه في طبيعة معتقداتهم، بمعنى إخضاع الإيمان الغيبي للمصلحة المادية. إذ كان هؤلاء المرئيون يحملون صفات الشيطان غير المرئي، وكونوا أبرز تمظهراته الحسية المادية.
قال تعالى: ﴿وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.
(يقول بعض المفسرين في معرض تفسير هذه الآية المباركة: إنّ اثني عشر من يهود خيبر وغيرها وضعوا خطة ذكية لزعزعة إيمان بعض المؤمنين، فتعاهدوا فيما بينهم أن يصبحوا عند رسول الله (ص) ويتظاهروا باعتناق الإسلام، ثم عند المساء يرتدون عن إسلامهم، فإذا سئلوا لماذا فعلوا هذا، يقولون: لقد راقبنا أخلاق محمد عن قرب، ثم رجعنا إلى كتبنا وإلى أخبارنا رأينا ما رأيناه من صفاته وسلوكه لا يتفق مع ما موجود في كتبنا، لذلك ارتددنا، وهذا سيحمل بعض المسلمين إلى القول بأن هؤلاء قد رجعوا إلى كتبهم السماوية التي هم أعلم منا بها، فلا بد أن يكون ما يقولونه صحيحا، وبهذا تتزعزع عقيدتهم).
ويتحدث القرآن الكريم عن الأوس المدعومة من قبل يهود بني قينقاع، والخزرج المدعومة من قبل بني النضير، وقد أغرى قوم من اليهود بينهم بذكر حروبهم في الجاهلية، ليفتنوهم عن دينهم، الذي خلصهم من تلك النزعات الجاهلية وأحقادها وعداوتها وخصومتها وجعلهم متوادين متحابّين متآلفين.
وكاد يقع الصدام، وعرف ذلك النبي (ص)، فأتاهم ونهاهم عن عادات الجاهلية، خاصة أنه (ص) بينهم، وقد أعزهم الله بالإسلام، فبكوا وعانق بعضهم بعضا.
هذان مثالان من مئات الأمثلة الحية، واللذان نستخلص منهما العديد من النتائج ونكون صورة عن الطبيعة المترسخة في أغلب اليهود الذين يعتنقون الفكر التلمودي دون نقاش أو بصيرة.
ومما نستخلصه:
أولا: إن اليهود المتصهينين منذ القدم إذا حلوا بمكان لا يرغبون أن يروا أحدا من أهل هذا المكان أفضل منهم منطلقين من أكذوبة شعب الله المختار، بينما هم أكثر الأقوام الذين ذمهم الله في التوراة والإنجيل غير المحرفين وكذلك في القرآن الكريم.
ثانيا: ما حلوا في بقعة من الأرض، منذ القدم إلا وعملوا على جعل أهلها شيعا، من أجل إضعافهم والسيطرة عليهم، ولا نستثني بقعة من الكرة الأرضية من ذلك بدليل طردهم قرابة الأربعين مرة من أقطار الدنيا منذ السبي البابلي الأول وإلى يومنا.
ثالثا: كل العقائد التي تبنوها منحرفة عما جاء به الأنبياء والمرسلون (ع)، حين كان هؤلاء المبعوثون إليهم بينهم، وقتلوهم، فكيف إذا لم يكونوا بينهم؟! وذلك لأنهم قوم شغفتهم المادة بعيدا عن الروحانية والإرتباط بحبل السماء، (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ).
رابعا: أخضعوا كل القيم السماوية وجيروها نحو شهواتهم المادية، ثم أصابهم الغرور نتيجة ما اكتنزوه من السيطرة، عبر الربا وتجارات الخمور والرذيلة، فهم لا يرعوون عن استخدام كل عمل قذر من أجل السيطرة والهيمنة.
خامسا: أعلنوا صراحة عداءهم للرسل والملائكة كجبريل وميكال، واعتبروا ملائكة الرحمن سببا في تدمير حضاراتهم المادية كسدوم والمؤتفكات وقوم لوط وغيرها (مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ).
سادسا: لا يحمل إي دين سماوي فكرة الغزو والهيمنة والإحتلال والقتل والتدمير، بل دعت الأديان السماوية إلى المحبة والتآلف والتعارف بين الشعوب والأمم، وما نراه اليوم عند التلموديين الصهاينة عكس ما جاءت به رسل الله وخطابات السماء تماما.
هذا وهناك العديد من النقاط التي يمكن تأشيرها والكتابة والتطرق إليها، كتعاملهم مع المرأة والمثلية والربا ومحاربة قوانين الله تعالى في الأحوال الشخصية، وزواج بنت الأخت، وغيرها الكثير.
فبأي جبهة يمكن تصنيف الصهاينة؟ في جبهة الحق والسماء؟ أم في جبهة الشيطان ومواطن حربه المتقدمة ضد المؤمنين والإنسانية؟
بقلم : أبو عامر