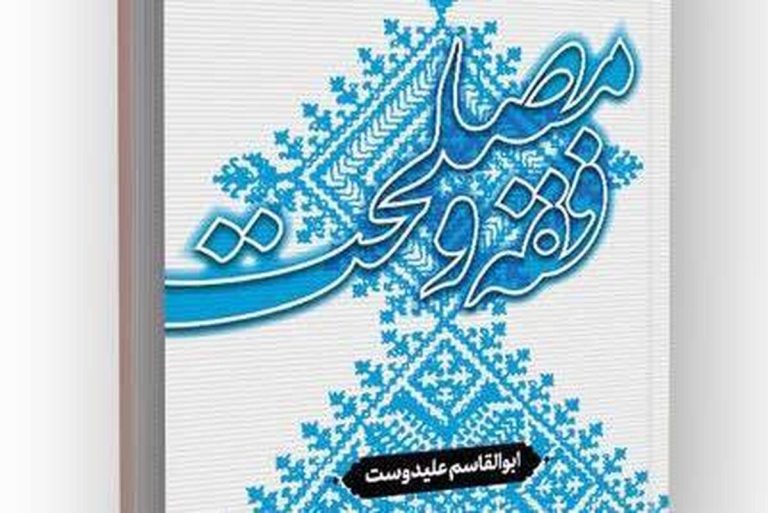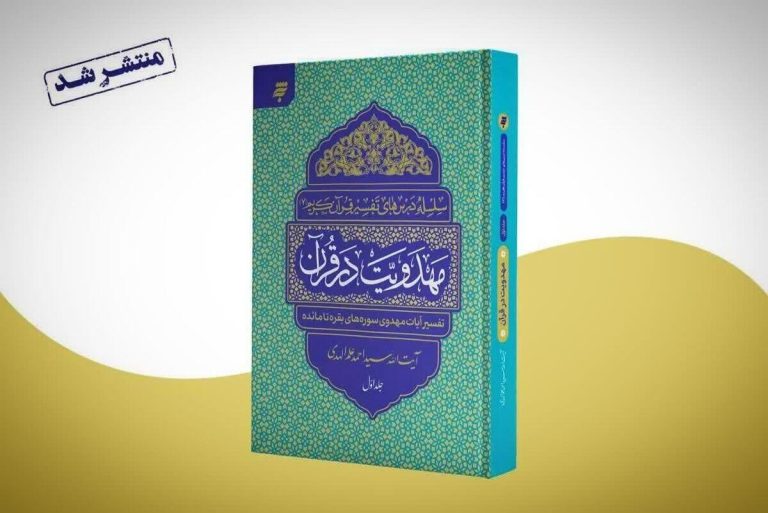في تقريرٍ لمراسل وكالة أنباء «الحوزة»، ألقى حجة الإسلام والمسلمين أحمد واعظي، عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية ورئيس مكتب التبليغ الإسلامي في حوزة قم العلمية، كلمةً بمناسبة أسبوع البحث العلمي، وذلك في جمعٍ من الأساتذة والمحققين والباحثين من الحوزة والجامعة، في قاعة الإمام الحسين (ع) التابعة لمعهد بحوث العلوم والثقافة الإسلامية.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة رئيس مكتب التبليغ الإسلامي:
إنّ آفاقًا جديدة ومساحات مبتكرة للعمل في مختلف المجالات آخذة في الانفتاح، ونحن نشهد حيويةً علميةً طيبة، ويمكن ملاحظة نتائج ذلك في الجوائز التي تُمنح في «كتاب العام» و«كتاب الحوزة للعام»، وكذلك في التكريمات التي تُقام لمكانة البحث العلمي في مكتب التبليغ، ولا سيما البحوث التي يكون جوهرها قائمًا على البحث العلمي نفسه.
فالنتاجات العلمية، سواء من حيث المحتوى أو من حيث الابتكار، جيّدة جدًا، وهي تفتح أمامنا آفاقًا جديدة. وقد تجلّى في هذه الزيارة أيضًا الدور الريادي لمكتب التبليغ؛ إذ إنّ بعض المجالات التي دخل فيها الإخوة الباحثون وأنتجوا أعمالًا علمية، أصبحت مصدر إلهام لمؤسسات أخرى اقتبست منها وتابعت المسار نفسه. وهذه الرسالة يتصدّى لها الإخوة القائمون على العمل.
وبسبب ضيق الوقت، سأحاول أن أقدّم ملاحظات مختصرة للغاية تكون في الحقيقة فتحَ بابٍ للنقاش؛ إذ لا يمكننا في هذه الجلسة الخوض في التفصيل في بعض المجالات، غير أنّ طرح هذه المحاور من باب إثارة البحث، وأن يلتفت إليها كيان العلم في مكتب التبليغ، أي الجامعة والمعهد البحثي ومؤسسة الإمام الرضا (ع)، وأن تُعقد أحيانًا جلسات وورش عمل حولها، أمرٌ بالغ الأهمية.
الفرق بين البحث الفردي والبحث الاستراتيجي
إذا نظرنا إلى البحث بما هو بحث، أي البحث المحض، أو جعلنا هموم الباحث الفردية وفضوله العلمي أساسًا له، فلن يكون مهمًا كثيرًا في أي مجال أو أي زمان يعمل، بل قد لا يكون مهمًا أيضًا أين يقف، وفي أي جغرافيا هويّاتية وثقافية وعصرية يعيش؛ لأن دافعه وفضوله فرديان. أمّا إذا كان البحث ذا توجّهٍ استراتيجي وتطبيقي، وموجّهًا نحو تلبية الحاجات وتقليل آلام المجتمع والبشرية، فعندئذٍ تصبح مسألة الجغرافيا الهويّاتية والثقافية والاجتماعية التي يعيش فيها الباحث بالغة الأهمية، وكذلك معرفة سياقه الزماني والمكاني وكيفيتهما.
ثلاثة محاور أساسية في البحث الاستراتيجي
برأيي، إذا اعتمدنا هذا المنظور وهذا النهج، فهناك ثلاثة محاور بالغة الأهمية ينبغي الالتفات إليها.
المحور الأول هو في الحقيقة تشخيصٌ للواقع؛ أي أن ندرك أين نقف، وما هي مقتضيات عصرنا. وفي تشخيص الواقع، من الطبيعي أن تُدرَس التحديات. وعندما نتحدث عن «التحدي»، لا نعني النقص أو القصور، بل نقصد الأمور التي تضعنا أمام تحدٍّ، وتطالبنا بالتدبير والمواجهة والتعامل الجاد معها.
أربعة تحديات رئيسة في النشاط الديني والتبليغي
قبل أيام، وفي مهرجان «جنّات والابتكارات التبليغية والثقافية»، تطرقتُ إلى مسألة التحديات التي تواجه النشاط الديني والتبليغي في عصرنا، وذكرتُ أربعة تحديات رئيسة:
أولاً: التحدي الأول هو تحدي التفكك أو التباعد الاتصالي.
ثانياً: التحدي الثاني يتمثل في التفسير والقراءة المنحازة للرسائل التبليغية والثقافية؛ فليس الأمر دائماً أن تتم قراءة مطابقة للرسالة، بل كثيراً ما تكون القراءة تقابلية أو نقدية. قد يكون لك قصد وغاية، وقد قمتَ بترميز رسالتك بطريقة تُوحِي بمضمون وتوجّه خاصين، لكن هذا لا يضمن بالضرورة أن يقوم المتلقي بقراءة مطابقة، أو أن يكون فكّ رموزه منسجماً مع ترميزك. فكثيراً ما تتخذ القراءة طابعاً نقدياً، وأحياناً طابعاً تقابلياً، بحيث يُفسَّر خطابك على نحوٍ معاكس تماماً لغايتك ومقصدك.
ثالثاً: التحدي الثالث هو تحدي الانفعال الثقافي والتأثر بالتمثيل الإعلامي الذي تقوم به الإمبراطورية الخبرية والإعلامية في العالم؛ ونحن في الواقع في موقع انفعالي أمامها، ولا نستطيع أن نُنتج تمثيلاً إعلامياً لرسائلنا ومضاميننا الثقافية والتبليغية يعادل من حيث الوزن والحجم ما تقدمه تلك المنظومات الإعلامية.
رابعاً: التحدي الرابع يتمثل في تراجع رأس المال الاجتماعي للفاعلين الدينيين، سواء من رجال الدين أو من غيرهم.
ولم يكن الهدف من ذكر هذه التحديات الأربعة في ذلك اللقاء هو الإيحاء بأنها مجرد نواقص أو عيوب لدينا، بل المقصود أن نُدرِك وجود مثل هذه التحديات، وأن نُفكّر في كيفية التدبير لها، وأن نُبدع ونبتكر ونتحلى بالمرونة والخلاقية، حتى نتمكن من مواجهتها وتحقيق النمو والتطور.
التحديات الأساسية في مجال البحث
في ميدان البحث أيضًا، أرى أنّ هناك جملةً من التحديات الجادّة. ولا أقصد هنا إحصاء جميع التحديات، وإنما أشير إلى بعض التحديات المحورية لتكون عناوين إرشادية للأصدقاء الذين يمكنهم الإسهام في معالجتها، والتفكير فيها، والتدبير لإيجاد حلول مناسبة لها.
أولاً: الذكاء الاصطناعي
أحد هذه التحديات هو الذكاء الاصطناعي. فقد أشار الأستاذ إلهينجاد في حديثه إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه «مساعدًا»، وذكر أنّه يمكن أن يكون عونًا للبحث العلمي؛ غير أنّني لا أتبنّى هذا التصور. فالذكاء الاصطناعي اليوم يُعَدّ تحدّيًا حقيقيًا للبشرية. إنه بالفعل ظاهرة كبرى، غير أنّ عِظَم هذه الظاهرة يزداد يومًا بعد يوم، ومعه يزداد جانبها المثير للقلق والخوف. فمن جهة قد تتسع وظائفه وخدماته التقنية، لكن من جهة أخرى قد يتحول إلى ظاهرة مقلقة ومخيفة.
الذكاء الاصطناعي ظاهرة ناشئة تشهد نموًا لافتًا من ثلاث زوايا أساسية:
- التزايد المستمر في حجم البيانات:
منذ تأسيس شركة «غوغل»، قام ملايين المستخدمين بإنتاج بيانات ضخمة لها بشكل مجاني، واليوم يشهد الذكاء الاصطناعي المسار ذاته. فمع كل استخدام وكل تفاعل جديد، تزداد بياناته أو تُصحَّح، وبذلك يقترب شيئًا فشيئًا من مستوى الذكاء البشري وقدراته. - الارتفاع الهائل في سرعة المعالجة:
إنّ التوجّه الحالي نحو الذكاء الاصطناعي والحواسيب الكمية (الكمومية) ينذر بحدوث تطورات غير مسبوقة. فإذا بلغ هذا المسار مرحلة النضج، فلن يعود للتشفير أو أنظمة القفل معنى، إذ سيكون كل شيء قابلًا للاختراق. وبحكم الطبيعة الكمية، ستقع تحولات مذهلة تنطوي على مخاطر جدية. فقبل مدة، كان الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى بضع ثوانٍ للإجابة، أما اليوم فقد باتت الاستجابة لحظية أو أقل من ثانية واحدة، ولا تزال قدرته على المعالجة في تصاعد مستمر. - تنامي القدرة الخوارزمية:
فالخوارزميات المصمَّمة لكل نظام ذكاء اصطناعي تمثّل في الحقيقة «العقل المفكّر» له. وبذلك تكون البيانات بمثابة الوقود، وتكون القدرة الحاسوبية هي المحرّك، فيما تمثّل الخوارزميات العقل المدبّر. والمثير أنّ تطورات بالغة الأهمية تجري في هذا المجال. فهذه الخوارزميات بالغة الخطورة والأهمية؛ إذ إنّ المعايير (النُّظُم) التي تُبنى عليها، ثم آليات توجيه المستخدم، وتأثيراتها الثقافية، وتغيير أنماط الحياة البشرية، كل ذلك مرتبط بكيفية تصميم هذه الخوارزميات وتوجيهها. وربما نشهد في المستقبل تطورات أخطر من ذلك بكثير.
يكفي أن ننظر إلى أرقام الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هذا العام فقط: فقد استثمرت الولايات المتحدة نحو 255 مليار دولار في هذا المجال. ولتقريب الصورة، فإنّ إجمالي العائدات النفطية وغير النفطية لإيران ـ بحسب إحصاءات مركز الإحصاء الإيراني ـ يبلغ نحو 88 مليار دولار، أي أنّ الولايات المتحدة استثمرت في الذكاء الاصطناعي وحده ما يقارب ثلاثة أضعاف مجموع دخلنا من العملة الصعبة. كما استثمرت الصين 55 مليار دولار، واستثمرت بريطانيا 18 مليار دولار في هذا المجال.
وهذه الاستثمارات لا تتم بدافع الخدمة أو بهدف توفير «مساعد مجاني» لنا، بل ستترتب عليها تحولات عميقة. فحالات الاعتماد التي ستنشأ، ستُفضي لاحقًا إلى توجيه العلم، وتشكيل شخصية الإنسان، وتغيير أنماط الحياة، كل ذلك استنادًا إلى الخوارزميات المصمّمة. وعليه، فإنّ الذكاء الاصطناعي تحدٍّ وليس مجرد فرصة.
والسؤال المطروح الآن: كيف نتعامل مع هذا التحدي؟ كيف يمكن لنا من جهة أن نستفيد من جوانبه الإيجابية والفرص التي يتيحها، ومن جهة أخرى أن نواجه مخاطره وتحدياته؟ فالذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى زوال مئات الملايين من الوظائف، أو على الأقل إلى تحولات جذرية في سوق العمل. فكيف يمكن لنا ـ بوصفنا باحثين ومنتجين للمعرفة ـ أن نحافظ على زمام البحث العلمي بأيدينا في ظل وجود الذكاء الاصطناعي، وألّا نتحول إلى حالة من الانفعال والتبعية؟
هذه القضايا تحتاج إلى نقاشات معمّقة وطويلة، وما ذكرته هنا إنما هو على سبيل طرح الموضوع وفتح باب البحث والنقاش.
ثانيا: التحدّي الثاني ـ وهو ما أشار إليه أيضًا الأستاذ إلهينجاد ـ يتمثّل في غياب التوازن بين البحوث الأساسية من جهة، والبحوث التطبيقية والاستراتيجية من جهة أخرى.
فنحن ـ في الغالب ـ بحكم الميول العلمية، ونوعية التكوين الذي تلقيناه، والتجارب الدراسية التي مررنا بها، نميل في المرحلة الأولى إلى الإنتاجات المعرفية التأسيسية والبحوث الأساسية. غير أنّ ما يحتاجه المجتمع، وما يحتاجه النظام، وما تقتضيه حاجاتنا الحضارية، هو البحوث الاستراتيجية والتطبيقية.
ومن هنا، تبرز ضرورة إرساء هذا التوازن، وهو بحدّ ذاته تحدٍّ حقيقي يستوجب التفكير الجاد:
كيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟ وبأي بنى تحتية؟ وبأي آليات للتمكين؟ وبأي توجّهات وسياسات بحثية يمكن الوصول إليه؟
ولا شكّ أنّ أهمية البحوث الأساسية أمر لا يمكن إنكاره؛ ففي جميع فروع العلوم، تمثّل العلوم الأساسية القاعدة التي يقوم عليها التقدّم العلمي، وهي التي تدفع العلم إلى الأمام وتؤسّس له. غير أنّ إنتاج الثروة، وإحداث التحوّلات الاجتماعية والحضارية، مرهون بالمعارف الاستراتيجية والتطبيقية. ومن ثمّ، فإنّ تحقيق هذا التوازن مسألة بالغة الأهمية، وينبغي التعامل معها بوصفها تحدّيًا أساسيًا والعمل الجاد لمعالجتها.
ثالثا: التحدّي التالي يرتبط بتلك الأجزاء من إنتاجاتنا العلمية وبحوثنا التي تنطوي على بُعد صناعة المعنى، وبناء المفاهيم، وإنتاج المحتوى والرسالة. فنحن نروم في هذا المجال أن نقوم بعملية إيجابية لصناعة المعنى، وبناء المفهوم، وصياغة الرسالة، غير أنّنا نواجه هنا تحدّيًا بالغ الأهمية.
ذلك أنّه في هذا المضمار، توجد جهات وأفراد آخرون، وكذلك وسائل الإعلام العالمية، وبالنظر إلى أنّ الثقافة ـ ولا سيما لدى الجيل الشاب ـ قد غدت في الغالب ثقافةً بصرية، فإنّ الإنتاجات الإعلامية والتمثّلات التي تُقدَّم في الفضاء الإعلامي تؤدّي دورًا محوريًا في تشكيل الهوية وبناء الشخصية، ورسم أنماط العيش، وتوجيه نظرة الإنسان المعاصر إلى الحياة، وتحديد كيفية العيش ومساراته. وفي المقابل، تريد أنت أيضًا أن تنتج رسالة، وأن تقوم بصناعة المعنى وبناء المفهوم. ومن ثمّ فإنّ ذلك القسم من إنتاجاتنا الذي يتمتّع بحضور اجتماعي وثقافي واضح، ويقوم على صناعة المعنى وبناء المفهوم، هو في أمسّ الحاجة إلى فهم عميق للواقع القائم في الجغرافيا الهوياتية والثقافية المعاصرة.
وهنا، أعترف صراحةً بأنني أشعر بضعفٍ ونقصٍ حقيقيين. فنحن نتحدّث عن جملة من الكلّيات؛ أي إننا ندرك أنّ تحوّلًا هوياتيًا قد وقع، وأنّ عملية إعادة تشكّل ثقافي قد جرت في بعض طبقات المجتمع، كما نفهم أيضًا منابع هذه التحوّلات وأصولها في الجغرافيا الهوياتية والثقافية. غير أنّ فهمنا لعمق هذه التحوّلات، ولطبقاتها السفلى الخفيّة، يظلّ فهمًا ضعيفًا، وذلك لأنّ احتكاكنا المباشر بهذه الظواهر محدود. فنحن لا نلمس هذه التحوّلات ولا نعيشها من خلال الكتب وحدها، ولا ننخرط فيها انخراطًا فعليًا.
وكثير منّا ـ حتى من بين الزملاء الذين يعملون في مجال الدراسات الاجتماعية أو الثقافية ـ إلى أيّ حدّ هو على تماسّ مباشر، وجهًا لوجه، ومتعايش ومتنفّس مع فئات الشباب والناشئة اليوم؟ إنني أؤكّد بشدّة على هذه المسألة، لأنّ كلّ ما يجري من تحوّلات ثقافية وهوياتية يحمل في كلّ سياق خصوصيّته وصيغته الخاصّة. فحتى حين نقول إنّ العالم قد أصبح علمانيًا، وإننا نعيش في عصر علماني، فإنّ العلمانية الغربية تختلف عن العلمانية الشرقية، وتختلف عن العلمانية الإيرانية، كما تختلف عن العلمانية العربية. فليس ثمّة رواية واحدة أو قصة واحدة تُروى في كلّ مكان، بل لكلّ سياق حكايته الخاصة.
وعلينا أن نستشعر هذا التداخل وهذا التحوّل الهوياتي والثقافي الجاري في طبقاته العميقة، وأن نفهمه فهمًا دقيقًا، حتى نتمكّن من صناعة المعنى المناسبة، وصياغة الرسالة الملائمة، وكذلك من اختيار السبل الكفيلة بنقل هذه المعاني والرسائل، وبسطها ونشرها وتعميمها.
وعليه، فإنّ المحور الأوّل كان هو ضرورة تشخيص الواقع (الوضعية الراهنة) والتعرّف إلى التحدّيات، وقد ذكرتُ ثلاثة نماذج منها على سبيل المثال. وبالطبع، فإنّ من يضع هذا الأمر ضمن جدول أعماله، سيجد أمامه ميدانًا أوسع بكثير للعمل والبحث.
المحور الثاني
النقطة التالية، وهي بالغة الأهمية، وقد أشرتُ إليها أيضًا في كلماتي في العام الماضي، تتمثّل في هذه المسألة، وهي أنّ مسار البحث العلمي وإنتاج المعرفة في العالم يجري في خدمة الخطاب المعنوي الغربي. وبعبارة أخرى، ليس صحيحًا أنّ حركة العلم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة في العالم تجري في فراغٍ خطابي، أو بمعزلٍ عن الهيمنة والسيطرة الغربية وعن الخطاب المعنوي الغربي. فمسار المعرفة كان دائمًا واقعًا تحت تأثير تلك الهيمنة الخطابية.
فالخطاب الغربي المهيمن، من حيث المعنى، يشتمل على متغيّرات ومكوّنات لا ترسم فقط مسار التحوّلات الهوياتية والثقافية، بل تفرض كذلك ضوابطها وأولوياتها وتوجّهاتها على عملية إنتاج المعرفة نفسها. أي إنّ جهات التمويل البحثي والمؤسّسات التي تقدّم دعمًا ضخمًا لمجال العلم، ليست جهاتٍ محايدة أو بلا انحياز. فهذه المئتان والخمسون مليار دولار التي تنفقها الولايات المتحدة، أو تلك الشركات الاقتصادية العملاقة مثل «ميتا» و«فيسبوك» و«غوغل»، ليست كياناتٍ بلا انتماء خطابي، ولا تعمل بحيادٍ كامل. بل إنّ لديها برامج وخططًا، وتضع في اعتبارها مجموعة من المتغيّرات الأساسية التي تريد ـ على أساسها ـ أن ترسم مسار الحركة الهوياتية للبشر، سواء في البعد الثقافي ونمط الحياة، أم في مسار المعرفة وإنتاجها.
واليوم، فإنّ الخطاب الغربي المهيمن، ومنظومة الهيمنة العالمية، قد تعرّضت للتحدّي في البعدين العسكري والاقتصادي؛ فلم يعد لدينا عالمٌ أحاديّ القطب على هذين الصعيدين. فدول مثل الصين وروسيا والهند تخوض نوعًا من المنافسة مع مجمل الغرب. غير أنّ هذه التحدّيات لم تتحوّل بعد إلى تحدٍّ خطابيٍّ عميق. فلا يمكن القول اليوم إنّ الصين أو روسيا قد نجحتا في تشكيل خطابٍ معنويٍّ حضاريٍّ متكامل يناهض الخطاب الغربي المهيمن. وفي الحقيقة، ما يزال العنصر المعنوي والخطابي المهيمن في العالم هو ذلك المنتمي إلى الغرب وإلى الحضارة الغربية المعاصرة؛ أي إنّ هذا التحدّي العسكري والاقتصادي لم يفضِ بعدُ إلى تحدٍّ خطابيٍّ جذريٍّ ولا إلى تشكّل خطاباتٍ جديدة متكاملة.
غير أنّ هذه القابلية موجودة في العالم الإسلامي وفي الثورة الإسلامية. فخطاب الثورة الإسلامية يمتلك هذه القدرة، لكنه يحتاج إلى الدعم، وإعادة النظر، والتنقيح، والمعالجة الدقيقة لمكوّناته، والعمل الجاد عليه. فإذا كنّا نملك رؤية حضارية، فإننا لا نستطيع تبنّي هذا النهج من دون تنقيح خطابٍ معنويٍّ مستقل، قائم على القيم والمصادر الإسلامية.
وعليه، فإنّ البحث العلمي القائم اليوم ينبغي له أن يقوم بعملية تحديد موقعه ونسبة انتمائه، وأن يسأل نفسه:
- ما هي علاقته بخطاب الثورة الإسلامية وبالخطاب المعنوي للحضارة الإسلامية؟
- وما هو موقفه إزاء هذا الخطاب الغربي المهيمن الذي يوجّه في الواقع مسار المعرفة والهوية الثقافية في العالم ويرسم معالمها؟
هل ينبغي لنا أن نكتفي بموقفٍ انفعالي، نراقب فيه باستمرار توسّع هذا الخطاب ونفوذه وتأثيره، ونشهد امتداد المعرفة المرتبطة به؟ أم يمكن لنا أن نتّخذ موقفًا نقديًا هجوميًا، وأن نمارس النقد والمواجهة الفكرية؟
ومن البوادر الإيجابية التي لاحظتُها اليوم خلال زيارتي لهذا المعرض، وجود تحرّكات جيّدة، سواء في الجمعيات العلمية الطلابية أو في بعض أقسام الهيئة التدريسية، تتوجّه نحو إعادة القراءة النقدية لهذا الخطاب المعنوي الغربي في أبعاده المختلفة. والتقرير الذي قدّمه الأستاذ غلامي خلال تلك الزيارة، والمتعلّق بالجامعة، يندرج ضمن هذا النوع من الجهود، وهو عملٌ يحتاج إلى مزيد من النضج، كما يتطلّب بذل جهدٍ أكبر واستمرارًا أوسع في هذا المسار.
المحور الثالث
إذا أراد الإنسان أن يكون بحثه منخرطًا بزمانه وسياقه، فإنّ المسألة الأساسية هي: إلى أيّ مدى نمتلك نحن أنفسنا الاستعداد للتغيير، بل لإعادة النظر؟ فعندما يواجه الإنسان أو المؤسّسة أو الجماعة أوضاعًا وتحدّيات جديدة، تظهر آليّتان أو نمطان من التكيّف:
أولًا: آليّة التبرير؛ حيث يعمد الإنسان إلى تبرير ذاته وتبرير الواقع القائم، ويغدو مسرورًا بالوضع الموجود، راضيًا عمّا يجري، ومدافعًا عنه.
ثانيًا: منهج الاستعداد للتحوّل والتغيير؛ أي أن يكون المرء مهيّأً للتبدّل، وأن يسعى، من خلال فهمٍ دقيق للظروف والموقع الذي يوجد فيه، إلى أن يراجع باستمرار: كيف يمكنه، عبر تغيير الواقع القائم، أن يغيّر ذاته، وأدواته، وطريقة مواجهته وتعاطيه مع الأمور.
ومن هنا نفهم تلك التحذيرات المتكرّرة التي أطلقها سماحة القائد، منذ سنوات، موجّهةً إلى الحوزات العلمية، حين نبّه إلى أنّ عدم التحوّل سيقود إلى العزلة. فذلك يعود إلى أنّ أحد ردود الفعل النفسية الانفعالية هو أنّ الإنسان، عندما يواجه ظروفًا وتحدّيات جديدة، بدل أن يكون مستعدًّا للتغيير والتحوّل، وبدل أن يعتمد مواجهةً فاعلة لتغيير الواقع، يلجأ إلى التبرير، فيبرّر نفسه ويبرّر الوضع القائم. وعندئذٍ، وبفعل هذا التبرير النفسي والمعرفي، يُغلِق باب أيّ تحوّل أو تغيير.
ومن الأهمية بمكان أيضًا أن نتساءل، نحن كمجموعة وكمؤسّسة علمية تابعة لمكتب التبليغ: ما مقدار الاستعداد الذي نمتلكه؟ وما التكتيكات الممكنة، أو التعديلات في التموقع، أو التحوّلات التي يمكن أن نجريها في توجّهاتنا العلمية والبحثية، بحيث نتمكّن من تجاوز التحدّيات القائمة أمامنا والتغلّب عليها؟
هذه هي المحاور الثلاثة التي أشرتُ إليها وطرحتُها بوصفها فتحًا لباب النقاش. ويمكن لهذا الطرح أن يكون موضوعًا لجلسات ولقاءات وحوارات فكرية معمّقة. إنّ علينا، بحقّ، أن نتعامل مع هذه القضايا بجدّية، وأن نبحث في أنماط المواجهة الممكنة والفعّالة حيالها.