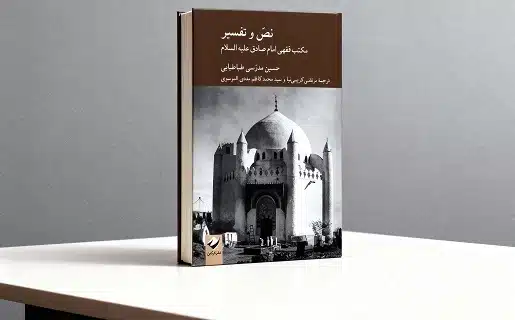شبكة الاجتهاد-يُعَدّ كتاب «النصّ والتفسير»[1] كتابًا حافلًا بالأخطاء. بل هو من فرط ما فيه من أخطاء، يكاد يُفهم أنّ المترجم نفسه لم يكن راضيًا عن نشر هذه الترجمة، لولا أنّه أرفقها بنقدٍ مطوّل في خاتمة الكتاب.
يتصدّى الكتاب لعرض سيرة الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وبيان الخصائص والامتيازات التي ينفرد بها مذهبه الفقهي؛ وهو موضوع كُتبت فيه إلى اليوم مقالات وكتب كثيرة. ومع بساطة موضوع الكتاب ووضوحه، فإنّ النصّ يعجّ بالأخطاء، وهو أمر يثير الاستغراب؛ وإن كان هذا الاستغراب لا يشمل أولئك الذين يعرفون حسين مدرّسي طباطبائي (مؤلّف الكتاب) ويطّلعون على منهجه واتجاهه الفكري.
صدر كتاب «النصّ والتفسير» (Text and Interpretation) بعُنوانٍ فرعي هو «المدرسة الفقهية للإمام الصادق»، غير أنّ الترجمة الدقيقة للعنوان الفرعي في نسخته الإنجليزية هي: «الإمام جعفر الصادق وتأثيره في القانون الإسلامي». وقد اقتُرح هذا الكتاب على المؤلّف حسين مدرّسي طباطبائي سنة 2018م (1397هـ.ش) ضمن سلسلة «آباء القانون في العالم»، ثم نُشر رسميًا عام 2022م (1401هـ.ش) عن دار نشر جامعة هارفارد.
قسّم المدرّسي كتابه إلى أربعة فصول؛ خُصّص فصلان منها بالكامل تقريبًا لنقلٍ متسلسلٍ للنصوص الأصلية لأحاديث الإمام الصادق عليه السلام مع ترجمتها. فمن أصل 325 صفحة، يشغل نقلُ الأحاديث وترجمتها ما يقارب 215 صفحة، وقد أورد معظم الأحاديث بنصّها الكامل، حتى تلك التي يتجاوز طولها الصفحة الواحدة. وهذا الأسلوب غير المألوف أكسب الكتاب مظهرَ مصنَّفٍ «حديثي»، ومنح القارئ إحساسًا بالتواصل المباشر مع متن الفقه الجعفري. وبهذا، يكون المدرّسي قد أعدّ في هذه الصفحات ما يشبه كُرّاسة في الفقه المأثور.
أمّا الثلث الأوّل من الكتاب، فيتولّى عرض شخصية الإمام الصادق عليه السلام، وبيان الخطوط العامة لفقهه من حيث المنهج والمضمون. وقد جُعل ما يَرِد في الفصلين الأوّلين أساسًا لفهم ما يأتي لاحقًا في الفصلين الثالث والرابع؛ ومن هنا تتركّز القراءة النقدية أساسًا على هذين الفصلين التمهيديين.
اختزال الإمام المعصوم إلى «شخصيةٍ تاريخية»
يُفاجأ القارئ الإيراني -الذي يُفترض في الغالب أن يكون شيعيًا اثني عشريًا- منذ السطور الأولى، حين يواجه العبارة الافتتاحية الآتية: «يسعى هذا العمل إلى تقديم ماهية وخصائص المدرسة الحقوقية للإمام جعفر الصادق، العالِم الديني البارز والفقيه المتقدّم في مدينة المدينة خلال النصف الأول من القرن الثاني الهجري».[2]
«عالِم ديني»؟ «فقيه متقدّم في المدينة»؟
إنّ الإمام الصادق (عليه السلام) في الوجدان الشيعي ليس مجرّد «عالِم»، بل هو إمام؛ إمامٌ له الولاية في مراتب التشريع كافة، وفي عوالم التكوين، ومقيمٌ في مقام الشفاعة الكبرى.
هو ليس عالمًا بالمعنى الذي يُطلَق فيه الوصف على سائر علماء الدين، بل إنّ العلم نفسه يفيض من منبعه. وليس فقيهًا بالمعنى الاصطلاحي الشائع، بل إنّ الفقه قد نما وازدهر من بيانه وبنانه، ولا يزال حيًّا ومتجدّدًا ببركة شفاعته.
وخلاصة القول: في العرف الشيعي، الإمام الصادق (عليه السلام) هو إمام، لا «عالِم دين» ولا «فقيهًا متقدّمًا في المدينة».
غير أنّ مدرسي يُقدِم -بوضوح وصراحة- على تقليص المقام القدسي للإمام، وإرجاعه إلى مثل هذه الأوصاف التاريخية المحدودة. وهذا الاختزال لا يقتصر على الألفاظ، بل ينعكس بعمق في طريقة عرضه وفهمه وتحليله لشخصية الإمام. إنّه فهمٌ متأثّر برؤيةٍ تفصل الإمام عن مقامه الإلهي، وتقوم على تمايزٍ بيّن، بل تعارضٍ جوهري، مع المرويات والعقائد الإسلامية كما استقرّت في الوعي الشيعي.
مظهرٌ آخر لرأي المدرسي
يتجلّى هذا التصوّر عند المدرسي بوضوحٍ في موضعٍ آخر، حين يعمد إلى تفسير أفعال الإمام وسلوكه لا بوصفها منسوبة إلى «الحق»، بل بإرجاعها إلى «التركيبة النفسية» للإمام نفسه.
وفي الوعي الإمامي الاثني عشري، فإنّ مقام الإمامة ممتزج جوهريًا بمقام العصمة، ولذلك لا يصحّ تفسير اختلاف مواقف المعصومين عليهم السلام باختلاف الظروف الجغرافية أو التاريخية على أساس «الذوق الشخصي» أو «السمات النفسية الخاصة».
ومن هنا، فمع أنّ التاريخ يحدّثنا عن اثني عشر إمامًا بأسماء وسِيَر متمايزة، إلا أنّ الحقيقة العقدية تشير إلى أننا بإزاء إنسانٍ معصومٍ واحد تجلّى في أزمنة متعددة. وفي هذا السياق تحديدًا برزت النظرية التحليلية المعروفة بـ«الإنسان ذي المئتين والخمسين عامًا»، والتي لم تكن ممكنة لولا الالتفات إلى هذا الأصل العقدي الجوهري والبسيط: عصمة الإمام.[3]
غير أنّ المدرسي، على ما يبدو، لا يتبنّى هذا الأصل إيمانًا حقيقيًا. ولهذا تتحوّل وحدة تاريخ الإمامة في نظره إلى مجرّد إطارٍ زمنيٍّ مرّ خلاله اثنا عشر شخصًا، تتشابه شخصياتهم أحيانًا وتختلف أحيانًا أخرى. وبناءً عليه، لا يسعى في تحليله لسيرة الأئمة إلى الكشف عن حكمة الفعل الإمامي أو إظهار كونه فعلًا حقّانيًا، بل يغلب عليه إرجاع تلك الأفعال إلى خصائص نفسية وشخصية.
وبعبارة أدقّ، فإنّه يُنزِل الإمام -والعياذ بالله- منزلة «موضوعٍ للدراسة النفسية الوصفية». فعلى سبيل المثال، يكتب في الفصل الأول عن الإمام الباقر عليه السلام: «من حيث الشخصية، كان الإمام الباقر مسالمًا، ويتجنّب العنف»[4]. وبعد صفحات قليلة، يتّبع النغمة نفسها في حديثه عن الإمام الصادق عليه السلام، فيقول: «في القضايا السياسية، كان الإمام الصادق شديد الشبه بأبيه: متحفّظًا على المشاركة، مسالمًا، ومعارضًا للعنف»[5]. ويواصل على المنوال نفسه، إذ يربط الموقف السلمي للإمام الصادق بتفسير نفسي، مستشهدًا بروايته لحديث النبي صلى الله عليه وآله: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»، ثم يعلّق بأنّ الإمام قال: «أمّا أنا، فلو كنت في ذلك الموقف، لتركْتُ السارق ولم أُقاتله». ويضيف: أنّ الإمام كان يتبرّأ ممّن يلجأ إلى العنف.
ويستند المدرسي في دعم هذا التحليل إلى موقف الإمام الصادق عليه السلام من ثورة محمد بن عبد الله المعروف بـ«النفس الزكيّة»، حيث قال الإمام: «اسكنوا ما سكنت السماء والأرض»[6]، أي: الزموا السكون ما دام النظام الكوني قائمًا على هدوئه.
غير أنّ هذا النمط من التحليل -القائم على إسقاط مفاهيم نفسية حديثة على مقام العصمة- يكشف بوضوح عن الفجوة العميقة بين القراءة الأكاديمية الغربية للإمامة، وبين الفهم العقدي الإمامي لها، ويُبرز كيف يُختزل الإمام المعصوم من «حجّةٍ إلهية» إلى «شخصية تاريخية قابلة للتفسير النفسي».
ما أصل الإشكال؟
تتلخّص القضيّة في أنّ محمّد بن عبد الله المعروف بـ«النفس الزكيّة» قد خرج سنة 145هـ في حركةٍ كان من الواضح أنّها حركة باطلة؛ إذ لم تكن تهدف إلى إسقاط الطاغوت لإقامة ولاية الحق، بل كانت في حقيقتها محاولةً لإحلال طاغوتٍ مكان آخر. ومن الطبيعي، والحال هذه، أن لا يراها الإمام حركةً مشروعة، وأن لا يساندها، بل وأن ينهى أصحابه عن المشاركة فيها. ولهذا أصدر الإمام توجيهه الصريح للشيعة بأن يلزموا الهدوء وألا ينخرطوا في هذا الخروج.[7]
غير أنّ مدرّسي يتعامل مع هذا الموقف الصادر عن الإمام في سياقٍ سياسيّ_اجتماعيّ خاص، لا بوصفه حكمًا شرعيًا نابعًا من تشخيصٍ دقيقٍ لملاك الحق والباطل، بل يختزله في إطار “سِمَةٍ نفسية” أو “خاصيةٍ شخصيّة”، فيقدّمه على أنّه تعبير عن كون الإمام: «مسالمًا، متجنّبًا للمشاركة السياسية».
وهنا مكمن الخلل المنهجي؛ إذ يُنزَع الفعل الإمامي من سياقه الحقّي والتشريعي، ويُعاد تفسيره تفسيرًا نفسيًا_سلوكيًا، بما يؤدّي عمليًا إلى تفريغ الموقف من مضمونه العقدي والفقهي، وتحويله إلى مجرّد انعكاس لطبعٍ شخصيّ أو نزعةٍ مزاجية، لا إلى تجلٍّ للحكمة الإلهية في مقام الإمامة.
استخدام مثل هذه الأوصاف يبتعد أساسًا عن أدب فهم سيرة الإمام؛ لأننا لا نقسم الأفعال إلى فئتين: “مسالم_عنيف”. بل تُصنّف الأفعال، بشكل عام، إلى فئتين: “صحيح_خاطئ”. وموقف الإمام (ع)، مثل سائر أئمة الهدى (ع)، كان دائمًا أنه إذا استلزم الفعل الصحيح القتال والحرب، فيكون القتال والحرب، وإذا استلزم السلم والسكينة، فيكون السلم والسكينة.
وقد وردت أحاديث متعددة عن الإمام الصادق (ع) في كتب الجهاد، تؤكد أنه، مثل سائر الأئمة (ع)، كان يؤمن بالجهاد والقتال، لكن ضمن شروط وضوابط، لا بدونها[8]. ويشير مدرسي إلى اعتقاد الإمام بالجهاد، أي أن الإمام الصادق في كتاب “النص والتفسیر” لا يعاني من أي نقص عقيدي، وهو ملتزم بالجهاد؛ غير أن هذا يبقى مجرد إشارة، ولم يكن بالنسبة لمدرسي ليصبح “من سمات شخصية” للإمام الصادق بأي حال من الأحوال[9].
الإمام فقيه محترم، لا يعرف جواب بعض المسائل
الإمام الصادق في كتاب “النص والتفسیر” إمام لا يعرف حتى جواب بعض المسائل الفقهية. يأخذ مدرسي طباطبائي هذا “جهل الإمام” مفترضًا، دون أدنى تردد في بيانه، ويحوّله إلى سبب لمدح الإمام. فيكتب: «إذا لم يكن للإمام جواب محدد لسؤال ما، كان يوضّحه صراحة لمخاطبه»[10]. بعد هذا الادعاء الغريب، الذي يفترض -أعاذنا الله- جهل الإمام ببعض المسائل الفقهية، ينقل مدرسي روايتين جاء فيهما التعبيران: «لا أعلم فيه شيئًا» و«لا أعلم له شيئًا مؤقتًا» كما هما، دون أن يتيح أي احتمال آخر لفهم كلام الإمام سوى “جهل الإمام”.
روح البحث عند مدرسي طباطبائي: محاولة لبناء خطاب تاريخي-كلامي لتشيع متجدد
الدهشة من هذا الكتاب لا تكاد تنتهي، وهي كثيرة إلى درجة أن أحد مترجمي الكتاب (السيد محمد كاظم مددي) كتب بنفسه نقدًا من أربعين صفحة على هذا الكتاب ونشره كمرفق مع الكتاب. حاولنا في ما سبق أن نبيّن أن أخطاء الكتاب بلغت حدّ تحريف مقامات الإمام المعصوم. فإذا أردنا تعداد الأخطاء من نوع: «التحريف بالحذف في النقل، الخطأ في فهم وترجمة عبارات الأحاديث، الإشارات غير الصحيحة أو غير المرتبطة بما ورد في النص، عدم مطابقة العناوين مع النص المشار إليه، …»؛ لكان علينا، مثل مترجم الكتاب، كتابة نقد يمتد لعشرات الصفحات، والحمد لله أن المترجم المحترم قد أوفى بحق ذلك.
لكن السؤال الآن: ما النهج الذي دفع مدرسي إلى هذه الأخطاء؟
كتب مترجم الكتاب في مستهل نقده: «المشكلة الأولى هي طريقة المؤلف في التعامل مع المصادر والوثائق، والتي قد يُمكن اختصارها بوصفها تقدّم النظرية على التاريخ. فالمؤلف، بافتراض صحة نظرياته المثبتة سلفًا، يصوغ الوثائق التاريخية بحسب قالبها، أو -ببساطة- يعتبرها غير صالحة.»[11]
ويشرح مددي على مدى عدة صفحات أنّ مدرسي يتخلى عن منهج البحث التاريخي المعروف، ويتجاوز أيضًا المنهج التقليدي لعلماء الحديث الشيعة، لكنه لا يوضح أبدًا وفق أي معيار يستخدم المصادر والوثائق التاريخية.
وفي كلمة واحدة، يقدم مدرسي معيار قبول أو رفض الروايات والتقارير التاريخية كمفهوم عام وغامض مُسبقًا: «أن تكون متوافقة مع لغة وشخصية الإمام الصادق»، وبحسب قول مددي، «هذا المعيار في الجوهر غير قابل للتقييم ومبني كليًا على التوفيق المسبق لما يُراد إثباته.»[12]
بمعنى أن مدرسي، قبل أن يصمت ويفتح أذنه ليصغي لما عرضه التاريخ عن الإمام الصادق، يكون قد قرّر مسبقًا من يكون «الإمام الصادق؟»، والآن ينقل ويستفيد فقط من الروايات التي تؤيد هذا الإمام الصادق المرغوب فيه، بينما يتجاهل الروايات الأخرى بدعوى زيفها أو يتركها صامتة تمامًا.
تقرير السيد مددي تقرير دقيق، ومدرسي يقوم تمامًا بنفس الفعل. لكن جذره لا يكمن في «التوفيق المسبق لما يُراد إثباته». أنا أسمي أسلوب بحث مدرسي «التوفيق المسبق بالقرار». فمدرسي قد اتخذ قراره مسبقًا بشأن الصورة التي يجب أن يصنعها عن التشيع؛ وهذا القرار هو ذاته الذي أشار إليه ضمنيًا في وقتٍ ما بالنسبة لكتابه المثير للجدل الآخر، وهو كتابه «المذهب في مسار التطور».
كتاب «المذهب في مسار التطور»، الذي نُشرت أول نسخة إنجليزية له عن دار داروين التابعة لمعهد الدراسات المتقدمة في برينستون، قسم تاريخ الدراسات الشيعية إلى ما قبل وما بعد صدوره. في الفصل الثاني من هذا الكتاب، تحت عنوان «الغلو، التقصير والطريق الوسط»، وضع مدرسي في الواقع معظم عقائد الشيعة الإمامية المعاصرين، مثل ولاية الأئمة على التشريع والتكوين، ضمن إطار عقائد المفوضة والغلاة، واعتبر العديد من أصحاب الرواية الكثيرة عن الصادقين (ع) -مثل مفضل بن عمر الجعفي ومحمد بن سنان الزاهري- من الغلاة.
في نظر مدرسي، وسط هؤلاء الغلاة، كان هناك شيعة “معتدلون”، أي إنهم لم يروا الأئمة مجهزين بهذه الصفات «الفوق بشرية»[13]، بل مجرد «علماء صالحين متقين»[14]. وهذه الترجمة هي مقابل العبارة العربية «علماءٌ أبرارٌ أتقياء»، التي وردت على لسان عبدالله بن أبي يعفور، الصحابي الخاص بالإمام الصادق (ع)، في جداله مع معلى بن خنيس. كل ما اعتمد عليه مدرسي في صياغة نظريته عن «العلماء الأبرار» هو هذا التقرير الواحد الموجود في كتاب رجال الكشي.
القصة تبدأ بأن معلى بن خنيس ادعى أن «الأوصياء هم أنبياء»، فأجاب عبدالله بن أبي يعفور: «لا، بل هم علماء أبرار أتقياء». ولأن مدرسي لا يريد أن يعكس معنى العلم في الروايات الشيعية، ترجم «العلماء الأبرار» إلى «علماء صالحين ومتقين»،
وقدم عبدالله بن أبي يعفور للقارئ باعتباره الشيعي الحقيقي الذي لا ينسب للأئمة صفات فوق بشرية أو خارقة[15]؛ مع العلم أن عبدالله بن أبي يعفور لم يكن يتبنى هذا الرأي الذي نسبه إليه مدرسي[16].
ثم يقدم عبد الله بن أبي يعفور للقارئ باعتباره ذلك الشيعي الحق الذي لا يعرّف الأئمة مطلقًا بصفات فوق بشرية أو غير طبيعية؛ غير أن عبد الله بن أبي يعفور لم يكن، في الواقع، من مؤيدي الرأي الذي قدمه مدرسي طباطبائي. وإلقاء نظرة على الأحاديث التي روّاها يوضح هذه الحقيقة؛ إذ كان بن أبي يعفور أحد الرواة الذين يؤكدون على كون الأئمة محدّثين، أي أنهم يمتلكون علمًا موحىً به إلهيًا وغيبيًا[17]. وهو نفسه راوٍ لحديث عن شفاء تربة سيد الشهداء (ع)، ورواية أخرى يظهر فيها الله في هيئة الحسين (ع)[18] أمام رسول الله، والعديد من الروايات الأخرى[19]. وإذا أمعنا النظر في كتاب الحجة للكافي، يتضح لنا أن علم الإمام (ع) هو علم إلهي. من بين نحو 150 بابًا في كتاب الحجة، حوالي 125 بابًا تتعلق بـ علم الإمام، وفي جميع هذه الأبواب واضح أن هذا العلم هو علم «ما كان وما سيكون»، وعلم القدر، وغير ذلك.
لذلك، لا يمكن أن يكون المقصود بـ «العالم» عند ابن أبي يعفور هو العالِم العرفي الاعتيادي. فالإمام عالمٌ بارٌّ تقي، لكن نوع علمه هو هذا العلم الإلهي. ومع ذلك، فإن مدرسي عمد إلى تجاهل هذا الجانب المهم تمامًا.
بعد نشر نظرية العلماء الأبرار، أبدى المجتمع الشيعي والباحثون في الدراسات الشيعية ردود فعل متباينة تجاه هذا الادعاء؛ ففي الحوزات العلمية، كُتبت العديد من الأعمال النقدية التي رَدّت على هذا الكتاب على يد فضلاء الحوزة، وما زالت الردود والاعتراضات تُكتب حتى اليوم (كان آخرها كتاب «مقامات الأئمة» لمصطفى سليمانيّان، الذي نُشر عام 1398 هـ ش.).
أما في الأوساط الأكاديمية المتخصصة بالدراسات الشيعية، فقد قام بحثان مهمان بالتصدي لهذا الطرح:
1.البحث الموسع للدكتور أميرمعزي[20] في سوربون، الذي جاء مباشرةً في مواجهة طرح مدرسي، وسعى لإظهار كيف كان الشيعة الأوائل -وخصوصًا قبل الشيخ المفيد- يعتبرون الإمام قلب العالم وباطنه. وقد أوضح أن هذا التصور العقلاني الخاص بالمتكلمين المعتزلة، مع هيمنتهم في عصر مدرسة بغداد، حدّ تدريجيًا من العقائد الباطنية للشيعة وقيدها.
2.البحث الأكاديمي الجاد للدكتور محمدهادي گرامي، الذي أظهر خصوصًا في كتابه «أول العلاقات الفكرية للشيعة»[21] أن العقائد التي نسبها مدرسي إلى الغلاة كانت في الواقع مقبولة لدى غالبية مشايخ الشيعة. وبالفعل، كانت العقائد الخطابية مختلفة تمامًا، وبالتالي فإن عمل مدرسي، من الناحية التاريخية، خاطئ، ومن منظور مفهوم الغلو، لم يتمكن من رسم حدود دقيقة بين الشيعة والغلاة.
ويبدو أن جميع هذه البحوث -رغم فوائدها الأكاديمية- غفلت عن شيء واحد جوهري: قرار مدرسي ودوافعه الخاصة!
في مقدمة النسخة الثانية الفارسية من كتابه «المدرسة في مسار التطور»، يوضح مدرسي أنه مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران، «رأت القوى الشيطانية العالمية والإقليمية فجأة جميع مصالحها في خطر»، وبناءً عليه شرعت هذه القوى في تدمير الثورة داخليًا وتشويه صورتها خارجيًا. ويضيف أن «الخلفيات التاريخية عمومًا، وعداء الطائفة الخاصة في العالم الإسلامي خصوصًا» كانت رأس المال الأساسي للشيطانيين لتشويه صورة الإسلام والثورة».
ويبين أن المحور الرئيسي لهذه العملية كان «تشويه وجهة التشيع وأتباعه». ويواصل قائلاً: «كان هناك آخرون أيضًا، في زي الدفاع عن التشيع، ساهموا بقدر ما استطاعوا في تشويه صورته، سواء عبر إعادة إحياء الأفكار الغالية والخرافية من مخلفات ومؤثرات عقائد الفرق المنحرفة القديمة التي ارتبطت بالمجتمع الشيعي، أو في هيئة تجديد بعض التقاليد والعادات الشعبية الجاهلة التي كانت منذ مدة متروكة ومهجورة بفضل نضالات وجهود السلف الصالح وعلماء الشريعة، وذلك من خلال الترويج والتأكيد على الأقوال والأفعال التي تثير الفرقة وتصنع الأعداء»[22].
ومن هذه العبارات يتضح أن الدافع الأساسي لمدرسي في بحثه لم يكن السعي وراء حقيقة التشيع، بل إدارة صورة التشيع.
إنه يريد أن يواجه الصورة التي صنعها الأعداء عن التشيع؛ وأهم عنصر في هذه الصورة هو “باطنية التشيع”. وتوضيحاته اللاحقة تُظهر هذا الدافع عند مدرسي بشكل أوضح: «في سنوات العقد السادس، كان هناك سيل هجومي ودعائي ضد التشيع، أحيانًا يظهر في شكل نقاشات وبحوث نقدية، وكان هذا التفسير يُطرح مع أقصى استخدام للمواد القابلة للاستدلال في النصوص القديمة لدعم هذا الادعاء، بحيث يُقدَّم التشيع في الغالب على أنه اتجاه باطني وخارج عن الإطار المعروف للإسلام. هذا التفسير أثر تدريجيًا على وجهة نظر المجامع الأكاديمية الغربية أيضًا، وبدأت صورة جديدة -كانت ثمرة مشتركة للأعداء والأصدقاء- تحلّ تدريجيًا محل النسخة التي كانت، لعقود، تصوّر التشيع على أنه حركة عقلانية وفهم متقدم وحديث للتقليد الإسلامي في ذهنية الأوساط العلمية الغربية».[23]
وبناءً على ذلك، أصبح الطريق لمواجهة الأعداء في نظر مدرسي هو “مواجهة الصورة الباطنية للتشيع”. وكان همّه أن يُفهَم التشيع كتراث عقلاني وراق، ومع ذلك ليس واضحًا من أين استنتج أن كون التشيع عقلانيًا أو مرتقيًا يتعارض مع “باطنية” التشيع.
ويواصل قائلاً: «فكرة كتابة هذه الرسالة (أي كتاب المذهب في عملية التطور) تشكّلت في سنوات أواخر العقد السادس في هذا السياق، كجهد لتقديم تحليل أكثر قابلية للعرض عن مذهب التشيع في المجامع العلمية».
تعد عبارتا “أكثر قابلية للعرض” و“علمي” مهمتين للغاية في هذا التوضيح. فهو مضطر للالتزام بفهم علمي محدد موجود في الأكاديميا الغربية، وأن يجعل صورة التشيع متوافقة مع هذا الإطار “العلمي” الخاص؛ وفقط في هذه الحالة تصبح هذه الصورة “أكثر قابلية للعرض”!
ويؤكد هذا المعنى لاحقًا بقوله: «(هذا العمل) نظرًا لأصله الثقافي، كان مضطرًا أن يأخذ في الحسبان المبادئ الأساسية والذهنية السائدة في ميادين الدراسات الإسلامية الغربية، لكي يحقق نجاحًا وقبولًا في تلك المجامع، ويكون مؤثرًا في تفسير “إسلامية” التقليد التشيعي الإمامي. ومن جهة أخرى كان لابد له من دراسة وتقييم بعض المفاهيم المثيرة للجدل التي كانت الأدبيات المضادة للتشيع في ذلك الوقت تراها قابلة للنقد وتطرحها».[24]
ماذا كان يفهم الغرب عن الإسلام؟ كانت صورة التشيع لا بد أن تقارب هذا الفهم لتصبح مفهومة. وما الذي كان أعداء التشيع يتهمون به التشيع؟ كانوا يقولون إن “الشيعة باطنية”. إذًا كان لا بد من تصحيح هذه الصورة المشوهة.
وبعبارة واحدة، جوهر عمل مدرسي هو عمل دعائي، وليس بحثًا علميًا حرًا في ساحة الحقيقة.
لقد سعى مدرسي من خلال طرح نظرية “العلماء الأبرار” -التي عرضها في كتابه القديم وبنى على أساسها شخصية مختلقة للإمام الصادق في كتابه الجديد- إلى تقديم صورة “عقلانية” (بالمعنى الذي تُعرف به العقلانية في الغرب)، و“مترقّية” (وفق المفهوم الغربي للتقدّم)، و“إسلامية” (وفق التصور الشائع لدى المستشرقين الغربيين). موضوع بحثه هو التشيع، ونتيجة بحثه هي “صورة التشيع”؛ لكن المؤشرات والمعايير التي وضعها لبحثه ليست القيم الجوهرية للتشيع، بل قيم الحداثة: العقلانية والتقدّم.
أولئك الذين يعرفون ذوق الحداثة يدركون أن العقلانية والحداثة في الغرب -سواء في الثقافة العامة أو في الأكاديميا- مترابطة مع العلمانية ونفي القداسة عن الأمور. إذا كان من المقرر تقديم تشيع “أكثر قابلية للعرض”، فإن أول ما يجب أن يُعرض بهذه الطريقة هو جوهر التشيع وأساسه: الإمامة والولاية. لذلك، يجب إنكار الشؤون المقدسة والإلهية للإمام، وإثبات أن الشيعة لم يكونوا أبدًا يعتقدون في مثل هذه المقامات، وأنها اختراع طائفة متشددة ومتطرفة. عندها يصبح الإمام مجرد “عالم تقي فاضل”؛ نعم، كان فقيهًا محترمًا، لكنه لم يكن يعرف بعض المسائل الفقهية (وكم كان متزنًا ومستنيرًا ليعلن هذه الجهل صراحةً!)، فكيف يُنسب إليه علم إلهي وسمات فوق بشرية؟
وفي المجال السياسي، كان الإمام، كفقيه عالم بالفقه، منصفًا ومعارضًا للظلم، لكنه، بشكل عام، مسالم وغير عنيف في شخصيته وتصرفاته. نعم! هذا هو الإمام الذي يمكن أن يصبح “إمام التشيع الأكثر قابلية للعرض” للغرب! الإمام الصادق حقًا غربي وحداثي!
بهذه الطريقة، يدخل مدرسي طباطبائي في مسعى لتصحيح صورة التشيع في نظر الغربيين، لكنه يغير ويشوّه الجوهر نفسه للتشيع من أجل تحسين المظهر الخارجي. وهذه النتيجة هي عاقبة قراره، وليست مجرد خطأ منهجي أو سهو بحثي.
بالطبع، لمواجهة مدرسي، من المفيد الإشارة إلى الأخطاء المنهجية والمحتوى وتصحيحها؛ لكن فساد هذا البحث لا يكمن في المنهج أو المحتوى ذاته. مادام مدرسي لا يعترف بسيادة قيم التشيع الجوهرية، ويعتبر أن الأصل يكمن في قيم الحداثة، فإنه سيقرأ التشيع وفق تلك المؤشرات والمعايير؛ لأنه، سواء أراد أم لم يُرد، هو مصوّر للتشيع على نحو حداثي، وليس باحثًا عن تشيع أهل البيت (ع).
الكاتب: السيد حميد رضا ميرركني بنادكي
[1]. نظرًا لأن أكثر الإشارات في هذا النص تتعلق بكتابين لحسين مدرسي طباطبائي، فإننا سنستخدم في الإشارة اسميْن مختصرين: نص = مدرسي طباطبائي، السيد حسين. نص. ترجمة: مددي الموسوي، سيد محمد كاظم؛ كريمي نيا، مرتضى. طهران: منشورات كركدن، الطبعة الأولى، 1404 هـ. مکتب = مکتب در فرایند تکامل. مدرسي طباطبائي، سيد حسين. ترجمة: إيزدپناه، هاشم. طهران: منشورات كوير، الطبعة الأولى، 1356 هـ.
[2]. النص والتفسیر؛ ص 17
[3]. هذه العبارة وهذه الطريقة في رؤية التاريخ وسيرة المعصومين (ع) أشار إليها لأول مرة قائد الثورة في سلسلة دروس قبل الثورة الإسلامية في إيران، ويمكن الآن تتبعها في الكتب التي تحمل عنوان “الإنسان 250 سنة”.
[4]. النص والتفسیر؛ ص 29
[5]. نفسه؛ ص 45
[6]. نفسه؛ ص 46
[7]. الكافي (دار الحديث)؛ ج 1، ص 598
[8]. الوافي؛ المجلد 8، ص 23
[9]. النص والتفسیر؛ ص 47
[10]. نفسه؛ ص 58
[11]. نفسه؛ ص 356
[12]. نفسه
[13]. مکتب در فرایند تکامل؛ ص 62
[14]. نفسه؛ ص 73
[15]. نفسه؛ ص 66
[16]. نفسه؛ ص. 74
[17]. بصائر الدرجات؛ ج 1، ص 322
[18]. كامل الزيارات؛ ج 1، ص 274
[19]. كامل الزيارات؛ ج 1، ص 67
[20]. لدى الدكتور أمير معزي العديد من الكتابات. لكن ربما يكون كتاب دليل رباني في التشيع الأولي أكثر وضوحًا للتعرف على بحثه؛ أمير معزي، محمد علي. دليل رباني في التشيع الأولي. ترجمة: الله ديني، نور الدين. طهران: كارنگ، الطبعة الأولى، 1398 هـ.
[21]. غرامي، محمد هادي. أولى العلاقات الفكرية في التشيع؛ إعادة قراءة مفهوم الغلو في فكر التيارات المتقدمة الإمامية. طهران: منشورات جامعة الإمام الصادق، الطبعة الأولى، 1391 هـ.
[22]. مکتب در فرایند تکامل؛ ص 9
[23]. نفسه؛ ص 11
[24]. نفسه؛ ص 12