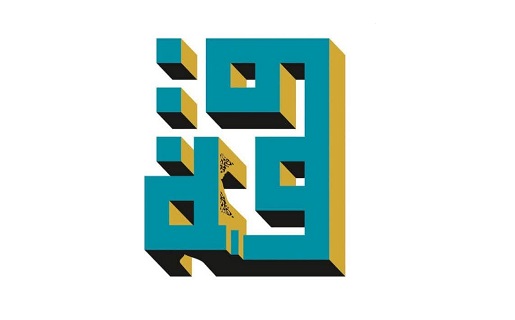منذ سنوات ونحن نتحدّث عن «الاجتهاد المعاصر»؛ لا بوصفه مجرّد مصطلح فنّي، بل باعتباره خطّ الدفاع في مواجهة أحكامٍ تقوِّم الفقه الشيعي على أنه «فاقد الزاد» أمام التحوّلات العالمية. لقد أثبتنا دائمًا، بفضل طاقاتٍ مثل أصول الفقه، والعقل العملي، والقواعد العامّة، واستيعاب عنصري الزمان والمكان، أنّ الفقه حيٌّ من حيث الأدوات والمنهج. غير أنّ الإشكال اليوم لم يعد مجرّد كفاية الفقه؛ بل أصبح السؤال عن كونه كافيًا بالفعل. وذلك لأنّ العالم في العصر الجديد لم يتغيّر على نحوٍ هادئ وخطّي.
إنّ التحوّلات المتسارعة في التكنولوجيا، وظهور البيانات الضخمة (Big Data)، وإسناد القرارات المصيرية إلى الأنظمة الذكيّة، قد غيّرت صورة المسألة جذريًا. كما شهدنا بوضوح في الحروب والأزمات الأخيرة كيف تحوّلت الأنظمة والتطبيقات الاجتماعيّة إلى ساحاتٍ لاندلاع الاضطرابات ومستَنقعاتٍ عميقة للأزمات الهويّاتيّة.
وعليه، لم نعد نواجه فقط «مكلَّفًا فرديًا» تكون نيّته واختياره محلّ الحكم الفقهي؛ بل أصبحنا أمام «فاعلين صامتين»: خوارزميات تبدو بلا نيّة، لكنها تُحدث آثارًا هائلة وتغيّر مصائر البشر. في مثل هذا العالم، كيف يمكن لاجتهادٍ كان إلى بضعة عقودٍ خلت نادر الاحتكاك بالقضايا العامّة الكبرى، أن يؤدّي واجبه أمام هذه القوى الاجتماعيّة الجبّارة؟
إنّ النقص الجوهري في اجتهاد اليوم لا يكمن في استنباط الحكم، بل في تشخيص ميدان الحكم. فكثيرًا ما ندخل ميدان القضايا متأخّرين؛ بعد أن تكون الأنظمة قد صُمّمت، والخوارزميات قد بدأت في اتّخاذ القرار، فلا يبقى مجالٌ لعرض الرؤى الفقهيّة. أو ندخل بأسئلةٍ غريبة عن واقع الحياة المعاصرة. وهنا تبرز الحاجة إلى فقهٍ بنيوي، وفقهٍ يستهدف لا السلوك الفردي فحسب، بل النظام الجمعي، والأنظمة، وبُنى القوّة ذاتها.
لقد انتقد الإمام الراحل، في خطابه بتاريخ 20 تمّوز 1980م أمام جمعٍ من العلماء وأئمّة الجماعات، رجال الدين الذين اعتزلوا القضايا السياسيّة، فقال في سياق نقده لهذا المسلك:
«[بعضُ رجال الدين] كانوا قد اقتنعوا بأنّ على العلماء أن يذهبوا فقط لبيان المسائل؛ وبعض المسائل لا كلّها. ولو كانت المسائل كلّها، لكانت أكثر كتب الفقه كتبَ سياسة».
وهذا يعني أنّ الإمام (قدّس سرّه) لم يكن يرى الفقه حيًّا فحسب، بل كان يعدّه أداةً لإعادة تعريف القوّة وإدراكها في النظام العالمي الجديد.
فـ«السياسة» هنا لا تعني اللعب السياسي، بل تعني تنظيم العلاقات الاجتماعيّة على أساس العدالة الإلهيّة. لقد أخرج الإمام الخميني (ره) الفقه من الدائرة الخاصّة، ووضعه في قلب النظام الحُكمي. واليوم ينبغي أن يمتدّ النهج ذاته إلى مجالات التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والعدالة الخوارزميّة. وهذه الحاجة الجديدة ليست بدعة، بل هي استعادة للطاقات الكامنة في الفقه الكلاسيكي.
إنّ كثيرًا من صور الظلم المعاصر لا تنشأ عن قرار شخصٍ ظالم، بل عن تصميمٍ خاطئ لنظامٍ ما. وفي مثل هذا العالم، لا تعود العدالة محصورة في «حكمٍ عادل»، بل تتجسّد في «بنيةٍ عادلة». وعلى الاجتهاد أن يرتقي من فقه السلوك الفردي إلى فقه تنظيم العلاقات الجمعيّة والنُظُميّة. وهذا هو بالضبط ما كان الإمام الخميني (ره) يسعى إليه بتأسيسه لنظريّة «ولاية الفقيه»؛ فقهٌ لا يكتفي بأن «يقول ماذا نفعل»، بل يحدّد أيضًا «كيف نبني العالم».
إنّ حيويّة الاجتهاد لا تتحقّق بمجرّد ترديد هذا اللفظ. فالحيويّة تحتاج إلى شجاعة: شجاعة إعادة التفكير في تشخيص موضوعات الفقه، وشجاعة إعادة تعريف علاقة الفقه بالقوّة في عصر البيانات، وشجاعة إعادة الإنسان الإلهي إلى مركز النظام الجديد، لا بوصفه مستهلكًا، بل باعتباره صاحب حقّ وكرامة. فإذا لم يُعِد الفقه تعريف علاقته بهذه الصور الجديدة للقوّة والعدالة والتمييز، فسوف يُدفَع إلى هامش الحياة. واليوم، مع أنّ الاجتهاد كافٍ من حيث المبدأ، إلّا أنّه بحاجة إلى تحوّلٍ ليصبح كافيًا بالفعل. على الفقه أن يوضّح علاقته بالمستقبل أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وإلّا فإنّه – من حيث لا يشعر – سيعيش في عالمٍ لم يعد موجودًا.
الكاتب: الدكتور محمدرضا فارسيان، باحث وأستاذ جامعي
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل