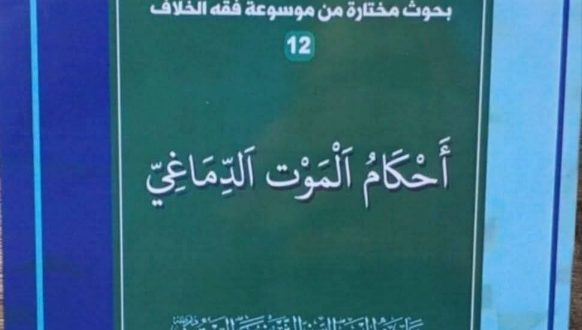شبكة الاجتهاد:
من الأخطاء الشائعة في النقاش حول الاقتصاد الإسلامي، الخلط بين «الغايات الشرعيّة الثابتة» و«الأساليب والآليّات الاجتماعيّة المتغيّرة»؛ وهو خطأ يؤدّي إلى إنتاج تصوّراتٍ وهميّة ذهنيّة تُسمّى «الاقتصاد الإسلامي»؛ أوهام تتغذّى على تبسيط الواقع الاجتماعي أكثر ممّا تتغذّى على الفقه.
في منطق القرآن، ما يُؤكَّد عليه بصراحة هو غاية العدالة، لا شكلٌ معيّن من الأدوات الاقتصاديّة. فقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، وهو ناظر إلى منع تركّز الثروة، لا إلى إقرار نموذجٍ تنفيذيّ محدّد.
القرآن يحدّد الهدف، لكنّه يترك الأسلوب للعقل الجمعي، والتجربة الاجتماعيّة، ومقتضيات الزمان. أمّا الإصرار على أنّ العدالة لا تتحقّق إلّا عبر وصفة تنفيذيّة واحدة بعينها، فهو في الحقيقة فرضٌ للطريقة على النصّ، لا استنباطٌ منها.
وفي سيرة أمير المؤمنين (عليه السلام) يظهر هذا التمييز بوضوح. فالإمام في كتابه إلى مالك الأشتر، لا يتحدّث عن تسعيرٍ قهريّ، ولا عن توزيعٍ شعاريّ للثروة، بل يؤكّد على إصلاح الولاة، والمراقبة المستمرّة، والمساءلة، وسدّ منافذ الفساد قبل وقوعه، حيث يقول: «ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَابْعَثِ الْعُيُونَ… فَإِنَّ تَفَقُّدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ».
وهذا الكلام ناظر إلى تصميمٍ مؤسّسيّ لضبط السلطة، لا إلى الاكتفاء بالنيّات والشعارات.
كما أنّ فقه الشيعة لم يعتبر الاقتصاد يومًا مجالًا لـ «الإرادة المطلقة للحاكم». فحتّى في بحث الولاية، تكون تصرّفات الحاكم مقيّدة بـ «المصلحة النوعيّة العقلائيّة» وبـ «الآثار الواقعيّة للقرار». ولم يقل أيّ فقيه إنّ مجرّد توفّر نيّة العدالة يجعل أيّ سياسةٍ مشروعة وناجعة. وهذا هو التمييز الدقيق بين «الحكم» و«التطبيق»، وهو تمييز غُفِل عنه في مسار الاجتهاد، ليحلّ محلّه خيالٌ سياسيّ مؤدلج.
وتبدأ المشكلة من اللحظة التي يُختزل فيها الاقتصاد الإسلامي إلى «اقتصاد الأوامر»؛ وكأنّه يمكن عبر تحديد الأسعار، أو التوزيع القسري للموارد، أو الحلول المفاجئة، إصلاحُ بنى اجتماعيّة معقّدة. هذا التصوّر لا يملك سندًا فقهيًّا، كما أنّه يتعارض مع التجربة التاريخيّة في الحكم الإسلامي.
فالرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) في قضيّة التسعير امتنع عن التدخّل المباشر، وربط ذلك بإخلاله بعدالة التبادل الطبيعي؛ وهذا يعني الالتفات إلى الآليّات، لا الاكتفاء بحسن النيّة.
ومن المنظور الإسلامي، يختلف مجتمع اليوم اختلافًا ماهويًّا عن مجتمع الأمس. فالأدوات، والأسواق، وحجم المبادلات، وتعقيد العلاقات الاقتصاديّة بلغت حدًّا يجعل تجاهلها بحدّ ذاته مصداقًا لتضييع الحقّ. والإصرار على الأساليب المبسّطة هو في الحقيقة تجاهلٌ لـ موضوع الحكم؛ وفي الفقه، تغيّر الموضوع يستتبع تغيّر الحكم.
والخطر الأكبر أنّ هذا التصوّرَ الوهميّ للاقتصاد يتحوّل – من حيث لا يُراد – إلى غطاء أيديولوجيّ للريع والامتيازات. فعندما يُختزل الاقتصاد الإسلامي إلى شعار، تُقمع بسرعة أيّ مساءلة مؤسّسيّة تحت عناوين مثل «الغربَنة» أو «التأثّر بالعلوم الإنسانيّة الغربيّة»، في حين أنّ هذا القمع نفسه يهيّئ الأرضيّة لتكريس البُنى غير العادلة. وهذا هو ما كان الإمام الخميني (رضوان الله عليه) يعبّر عنه بـ «الإسلام الأمريكي»؛ إسلامٌ يبرّر الظلم البنيوي بدل أن يواجهه.
فالاقتصاد الإسلامي، إن أُريد له أن يكون ذا معنى حقيقيّ، لا بدّ أن يُعاد بناؤه على مستوى الحوكمة المؤسّسيّة؛ أي بالتركيز على قواعد تضبط حتّى الأفراد غير الصالحين، ولا تُوقع الأفراد الصالحين في شباك الفساد.
وهذا المنهج ليس تراجعًا عن الدين، ولا تقليدًا للغرب، بل هو عودة إلى روح الاجتهاد، والعقلانيّة العلويّة، والعدالة القرآنيّة.
*ترجمة مركز الإسلام الأصلي