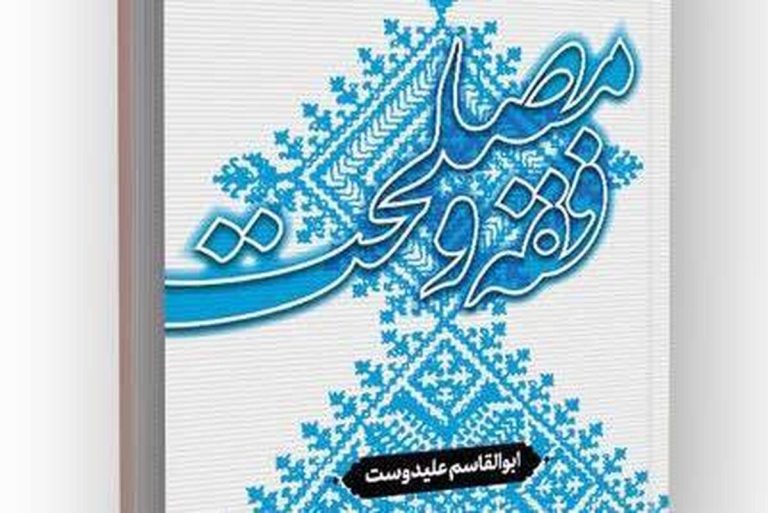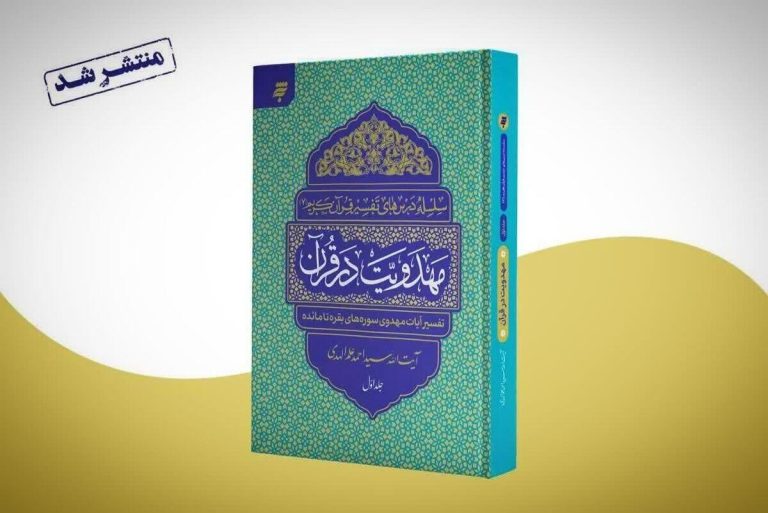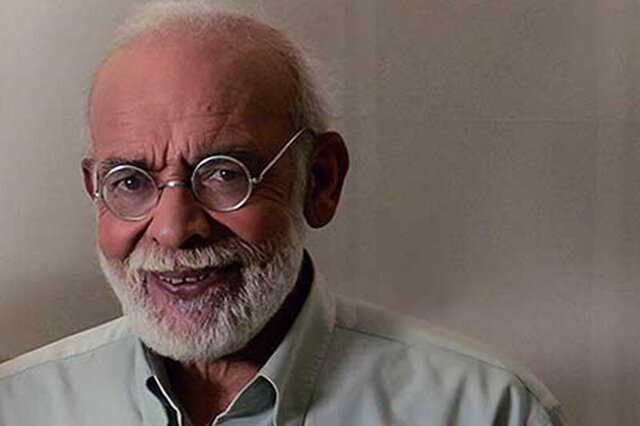بتاريخ: 26 جمادى الآخرة 1447 ه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
في سياق الكلمات النورانية لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (سلام الله عليه)، بلغنا الكلمة الطيّبة رقم (191) من كلماته القصار، حيث قال (عليه السلام):
«إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا، وَنَهْبٌ تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ، وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ، وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ، فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ، وَأَنْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُوفِ، فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ، وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلَّا أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا بَنَيَا، وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعَا؟!»
وهذه الكلمة النورانية رقم (191) تمثّل تفسيرًا جامعًا لحقيقة الدنيا: ما هي الدنيا؟ وما طبيعة علاقتنا بها؟ وما طبيعة علاقتها بنا؟ حيث تختصر هذه الكلمة هذه المعاني في صورة مثلّث متكامل الأضلاع.
أما الجملة النورانية الأولى:
«إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا»،
فتشير إلى أن الإنسان ما دام يعيش في هذه الدنيا، وينتفع بهوائها وأرضها وإمكاناتها البرية والبحرية، فإن هذا الانتفاع ليس مجانًا، بل هو معاملة حقيقية.
وبما أنها معاملة، فقد يكون المبيع في بعض الموارد أكثر من الثمن، وقد يكون الثمن أكثر من المبيع في موارد أخرى، إلا أن الإمام (عليه السلام) يبيّن هنا أن الربح دائمًا يُسجَّل لصالح الدنيا، والخسارة تقع على عاتق الإنسان؛ لأن الإنسان يدفع أغلى الأثمان، ويأخذ في المقابل الزمان والمكان.
فالإنسان يعطي من عمره، ويأخذ زمانًا ليقضيه، ويأخذ أرضًا ليعيش عليها؛ فهو يحتاج إلى مكان يسكنه ـ وهو الأرض ـ ويحتاج إلى زمان، ليلًا كان أو نهارًا، إذ لا يمكن للإنسان أن يعيش خارج إطار الزمان. وفي النظام الطبيعي، لا ينفك الإنسان عن عنصرين أساسيين: الزمان والمكان، وكلاهما من شؤون هذا النظام الطبيعي، ومن مقوّمات عالم الدنيا.
فإذا أراد الإنسان أن ينتفع من الزمان ـ سواء أكان ليلًا أم نهارًا ـ فلا بدّ له من أن يدفع ثمنًا أو يؤدّي أُجرة. وكذلك إذا أراد أن ينتفع من الأرض، فلا بدّ أن يدفع ثمنًا. غير أنّه في كلا الموردين مغبون؛ لأنه يدفع أغلى ما يملك، ويأخذ في المقابل الزمان، والزمان لا يُمَلَّك له، بل ينتفع به كثيرون، وهو واحد منهم فقط. وكذلك الأرض، فإنها لا تُجعل ملكًا له على الحقيقة.
إنهم يأخذون عمره، وهو رأس ماله الأصيل والأساسي، ثم يُقال له: نم هذه الليلة هنا، أو غدًا هناك، وما شابه ذلك. فإذا أراد أن ينتفع من زمانه، فلا محالة عليه أن يبذل من عمره. وإذا أراد أن ينتفع من أرضه، فعليه أيضًا أن يبذل من عمره. وفي كلا نوعي المبادلة هذه يكون مغبونًا.
ومن هنا يتّضح معنى ما ورد في سورة «التغابن»، التي سُمّيت بهذا الاسم؛ إذ سيتبيّن لاحقًا بوضوح أن كثيرًا من الناس مغبونون، غير أن غبنهم لا يتحقّق في ذلك اليوم، بل يظهر ويتجلّى فيه. فذلك اليوم ليس يوم تجارة، وإنما هو يوم الجزاء فحسب. ويوم الجزاء والحساب ليس موطن الغبن؛ لأن الغبن إنما يكون في زمن التجارة.
ولما كان ظرف التجارة هو الدنيا، فإن أكثر الناس فيها مغبونون، قال تعالى:
﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾.
فهذا اليوم هو يوم ظهور الغبن، لا يوم حدوثه وابتدائه. ومن كثرة من كانوا مغبونين سُمّي ذلك اليوم بـ«يوم التغابن». فالغبن يتجلّى هناك، لا أنه ينشأ هناك؛ إذ لا بيع ولا شراء في ذلك اليوم، وإنما البيع والشراء في الدنيا، غير أن حقيقة الغبن تنكشف هناك.
قال الإمام (عليه السلام): إنكم لا تملكون شيئًا للانتفاع بالزمان إلا أن تبذلوا رأس المال، ولا تملكون شيئًا للانتفاع بالأرض إلا أن تقدّموا رأس المال. وليس لديكم رأس مال سوى العمر. فأنتم تدفعون رأس المال وتأخذون الزمان، وتدفعون رأس المال وتأخذون الأرض؛ ومن ثمّ تكونون في كلا الحالين مغبونين. وهذا هو معنى قوله تعالى:
﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾.
أحيانًا يُعطي الإنسان سلعةً في مقابلها زمانًا، كما هو الحال في باب الإجارة والاستئجار، حيث يدفع الأجير أو المستأجر شيئًا ويُقال له: كن في هذا المكان ساعة أو بضع ساعات. فهو يدفع مالًا ويأخذ زمانًا من صاحب المكان. أمّا هنا، حيث نعيش في ظلّ النظام الطبيعي ـ بإذن الله تعالى ـ فهل نملك شيئًا نقدّمه للزمان ليُعطينا الزمان نفسه؟ إننا في الواقع نستأجر الزمان من النظام الطبيعي، وندفع في مقابل هذه الإجارة حياتنا، ونبذل أعمارنا، ونسلّم أرواحنا. ولهذا الأمر حدٌّ معلوم.
وعلى هذا الأساس، فإن الإمام (عليه السلام) يبيّن أن الإنسان في هذه الدنيا مغبون على الدوام؛ وهذه حقيقة أولى. والحقيقة الثانية أن سهام الغبن تصيبه باستمرار، غير أنه لا يشعر بها الآن؛ لأنه مخمور ومغترّ. أمّا يوم القيامة فليس يوم رمي السهام، بل هو يوم الإحساس بآلام السهام السابقة؛ إذ لا أحد يرمي الإنسان في ذلك اليوم. فبعد المحاكمة يكون الحساب من نوع آخر، غير أن الإنسان يستيقظ بالألم، وهذا الألم هو ألم السهام التي أُصيب بها من قبل ولم يكن منتبهًا لها.
ولهذا قال (عليه السلام): إن حال الدنيا هو هذا: «إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ»
أي إن الإنسان في الدنيا هدف للسهام، يتلقى الضربات باستمرار، لكنه لا يشعر بها لانشغاله وغفلته.
وتلك السهام التي تصيبه تتمثّل في الحوادث القاسية، والأمراض التي تطرأ عليه، وفقدان المكانة والاعتبار الاجتماعي؛ وهذه كلّها سهام أخرى. وهو «غَرَض» لسهام الموت والغارات المتتالية التي تسلبه واحدًا بعد آخر: إمّا عقله، أو وعيه، فيقول: لم يعد ذهني حاضرًا، ضعفت قدرتي العقلية، قلّ إدراكي، ونقصت قابليّاتي. سنةً بعد سنة، يفقد هذه النعم الإلهية واحدةً بعد أخرى.
ولا يحدث الأمر دفعةً واحدة، بحيث يفقد الإنسان فجأة صحته، أو ذاكرته، أو قوته العاقلة، أو خياله، أو وهمه؛ بل إن هذه القوى تضعف تدريجيًا على امتداد العمر، ثم شيئًا فشيئًا تضعف الذاكرة، وتزول القدرة على التذكّر، وتضمحل قوة التوهّم، وسائر هذه الملكات.
وعلى هذا الأساس، فإن الإنسان في المرتبة الأولى يدخل في معاملةٍ يكون حاصلها أنه يبذل عمره ويأخذ في المقابل الزمان؛ لكي ينام بضع ليالٍ، ويقضي بضع أيام. وفي هذه المعاملة يكون مغبونًا. ومن جهة أخرى، فإن الحوادث التي تطرأ عليه تمثّل رميًا متواصلًا بالسهام، حيث تفقد قواه واحدةً بعد أخرى، أو تضعف تدريجيًا؛ فيكون هدفًا دائمًا للرمي والإصابة.
فهو من جهةٍ هدفٌ للمنايا والموت، ومن جهةٍ أخرى هدفٌ لتلك السهام، وهو «غَرَضُ البلايا». وكل حادثٍ يَرِد عليه يكون مصحوبًا بالألم، كما قال (عليه السلام):
«تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ».
فكل شرابٍ يشربه يكون مؤلمًا؛ و«الشَّرَق» بمعنى الألم والحرقة. وليس الأمر كذلك أن ما يُفرض على الإنسان تناوله ـ كما هو الحال في الدواء الذي يصفه الطبيب ـ لا بد أن يكون حلوًا أو خاليًا من المرارة؛ بل لا محالة يكون مصحوبًا بالشَّرَق، أي بالألم والحرقة. فقد يصف الطبيب شرابًا يكون له أثرٌ علاجي أو لا يكون، غير أن هذا الشراب لا يخلو ـ في الجملة ـ من ألم أو لسع.
فالإمام (عليه السلام) يبيّن أن كل حادثة تَرِد على الإنسان، وكل أمرٍ يعطيه الزمان، لا يخلو من شَرَقٍ وحرقةٍ وإيلام.
ثم قال (عليه السلام): «وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ».
فإذا أُعطي الإنسان شيئًا وقيل له: كُلْه، فإن في ذلك «غُصَّة». والغُصَّة في الأصل هي ما يَغُصُّ به الحلق، أي ما يعلق في الحلق ويؤلم. واستعمال لفظ «الغصّة» في الحوادث النفسية هو استعمالٌ تشبيهي؛ لأن ما يعلق في الحلق إذا أُكل كان مؤلمًا وغير قابلٍ للهضم، يبقى هناك ويُزعج الإنسان.
وكذلك الحادثة المؤلمة: لا تزول من الذهن، بل تبقى عالقة في النفس، وتحرق صاحبها باستمرار، فتصبح «غُصَّة». فالماء إذا علق في الحلق قيل له غُصّة، والطعام إذا علق في الحلق قيل له غُصّة، والغُصّة معناها: ما يَغُصُّ به الحلق.
ولما كانت الحوادث المؤلمة تُحدث أذًى دائمًا، أُطلق عليها وصف «الغُصَّة»، لا بمعنى الألم أو المصيبة أو الحدث المرّ في نفسه، بل بمعنى ما يعلق ويمنع الانسياب الطبيعي. ولهذا قال (عليه السلام):
«وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ».
قوله (عليه السلام): «وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى»
من خصائص الدنيا أن كل نعمة تُعطى للإنسان يُطلب في مقابلها ثمن. فإذا أراد أن يضمّ إليها نعمةً أخرى، فلا بدّ أن يدفع ثمنًا آخر. فالدنيا لا تمنح شيئًا مجّانًا أبدًا. فإذا تحقّقت المعاملة الأولى، وبذل الإنسان جهد يومٍ وليلة حتى حصل على نعمة ما، ثم أراد أن يبلغ نعمة أخرى، فلا محالة عليه أن يبذل رأس مالٍ جديدًا. وليس الأمر كذلك أن يُقال له: بما أنك صرت زبونًا مرةً، فهذه المرة الثانية تكون بلا مقابل! كلا، لا يُعطى الإنسان شيء بلا عوض.
ومن هنا قال (عليه السلام): «وَلَا يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقِ أُخْرَى»،
حيث إن «أُخرى» وصفٌ لنعمةٍ محذوفة، أي: إلا بفراق نعمةٍ أخرى.
ثم قال (عليه السلام): «وَلَا يَسْتَقْبِلُ يَوْمًا مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا بِفِرَاقِ آخَرَ».
فإذا قيل: إن الإنسان صار أكبر بيوم، فليُعلم أنه في المقابل قد فقد يومًا من عمره. وليس الأمر أن يُحسب الغد ربحًا صافيًا من غير خسارة؛ كلا، بل خسر يومًا وأخذ يومًا آخر. ولو أن الغد جاء مع بقاء الأمس لكان ذلك زيادةً في العمر وربحًا حقيقيًا، أمّا إذا جاء الغد بعد فراق الأمس، فليس ذلك كمالًا ولا دخلًا. ولهذا قال (عليه السلام): إن الإنسان لا يستقبل يومًا إلا بفراق يومٍ آخر.
وبناءً على هذا التحليل، يتّضح أننا في معرض الموت دائمًا. و«المَنون» بمعنى الموت، ولذلك قال (عليه السلام): «مِنْ أَجَلِهِ فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ»
أي إننا نُسهم في مساعدة الموت؛ لأن الأمراض تُعين الموت، والآلام تُعين الموت، والهموم والغُصَص تُعين الموت. فكلّها عوامل مساعدة على الموت، ومن هذه الجهة نكون أعوانًا للموت.
ثم قال (عليه السلام): «وَأَنْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُوفِ».
كأنّما زُرعنا في هذا العالم ليُرمى إلينا بالموت، وكأنّنا نُصِبنا هنا لتُوجَّه نحونا سهام الهلاك. ولا طريق لنا غير هذا الطريق، ولا مفرّ لنا من هذا المصير. فالحوادث تتوالى باستمرار، واحدةً بعد أخرى، ليأخذ كلٌّ منها جزءًا من أعمارنا.
ثم يتساءل (عليه السلام): «فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو الْبَقَاءَ؟»
فأيّ بقاءٍ يُرجى في عالمٍ تكون فيه جميع الحوادث في صدد السلب والإزالة؟ والدليل على ذلك قوله (عليه السلام):
«وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلَّا أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا بَنَيَا وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعَا».
فالليل والنهار في أنفسهما مظهر للبركة ومن نعم الله تعالى، ولكن ماذا صنعا بنا؟ فما من شيء رفعاه إلى مقامٍ وشرف، إلا وسارعا بعد ذلك إلى نقض ما بنياه، وتفريق ما جمعاه.
قال تعالى في القرآن الكريم: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾.
فمن كانت له برامج صالحة في النهار ولم يتمكّن من إنجازها، فليؤدّها في الليل، ومن كانت له برامج صالحة في الليل ولم يُتح له أداؤها، فليؤدّها في النهار. فالليل والنهار فيهما بركة، أوّلًا؛ وهما مكمّلان أحدهما للآخر، ثانيًا؛ وبينهما اختلاف لا تخالف، ثالثًا.
والاختلاف أمر مبارك؛ إذ معناه أن يقوم أحدهما مقام الآخر ويكون خلفًا له وخليفةً عنه في أداء العمل. فإذا قيل: إن «أ» يختلف مع «ب»، فمعناه أنه ما دام «ب» موجودًا يقوم هو بوظيفته، وإذا غاب «ب» قام «أ» مقامه وخلفه في إنجاز عمله. وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾،
أي إن كلاً منهما خليفة عن الآخر.
ولهذا لا يصحّ للإنسان أن يقول: فاتني الليل فلا أستطيع التعويض؛ كلا. حتى في باب الصلاة ورد هذا المعنى؛ فإذا لم يتمكّن من أداء النوافل في الليل، أداها في النهار، وإذا لم يتمكّن من أدائها في النهار، أداها في الليل. فالاختلاف من أعظم البركات الإلهية.
ومن هذا الباب جاء وصف الملائكة بـ«مُخْتَلَف الملائكة»، وكذلك المؤمنون. ففي الزيارة عند التشرف بالحرم نقول:
«السلام عليكم يا … مُخْتَلَفَ الملائكة»،
و«مُخْتَلَف» اسم مكان، أي موضع الذهاب والإياب، حيث تأتي جماعة وتذهب أخرى، ثم تأتي فئة وتغادر أخرى، فيكون مكان تردّد الملائكة.
ولا توجد هنا مخالفة؛ فإن المخالفة هي المذمومة، أمّا أن يقوم أحدهما مقام الآخر في حال غيابه، فذلك غاية المودّة والتكامل. ومع كل هذه البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار لحلّ مشكلات الإنسان، إلا أنّهما ـ في علاقتنا نحن بهما ـ يقومان بسلبنا؛ لأنهما يأخذان من رأس مالنا.
صحيح أن الله تعالى جعل الليل والنهار نعمة وبركة: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾،
إلا أن هذه النعمة ـ من جهتنا نحن ـ ليست نعمة خالصة؛ لأن كليهما يأخذان من أعمارنا. ولهذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «وَهَذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلَّا أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا بَنَيَا وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعَا».
فهما من جهةٍ يعطِيان، ومن جهةٍ أخرى يهدمان ويفرّقان.
وعلى هذا، فإن علاقتنا مع النظام الطبيعي لا تثمر إلا المديونية والخسارة. فهذا هو برنامجنا في هذه الدنيا. فإذا تلذّذنا بلذّة، أو نلنا راحة، أو نمنا نومًا، أو تناولنا طعامًا، فإننا ندفع في مقابل ذلك أثمانًا باهظة. فنحن في زمن المعاملة مغبونون، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾.
وهذا هو حال الدنيا التي أصبحت متاع الغرور.
ما دمنا نملك رأس مالنا فإننا نتعامل تعاملَ الخاسرين. وما دمنا نملك الروح، والقوى، والصحة، فإننا نتعامل تعاملَ المغبونين. نعطي شيئًا ونأخذ شيئًا، وفي جميع هذه المعاملات نكون خاسرين.
والآن نحن نموت… نعم، نموت في نهاية المطاف، ولا بدّ لنا أن ننتفع من هذه الأرض. فلن يُحرقونا، بل سيضعوننا في الأرض. فتقول الأرض: هل لديك شيء تدفعه لي؟ فنقول: لا. فتقول: إذن قدّم رهنًا.
وهذا هو البيان النوراني للإمام السجاد (سلام الله عليه) حين قال: «رَهَائِن، رَهَائِن». أي إن الذين يُحملون إلى المقبرة هم «رَهَائِنُ القُبُور». إلى أين تريد أن تذهب؟ تقول الأرض: لا أسمح لك إلا إذا كنتَ أنتَ نفسُك في رَهني. فهذا الميت المسكين مرهون لهذه المقبرة. ومعنى «رهائن، رهائن» هو هذا بعينه، كما ورد في دعاء الإمام (عليه السلام).
واليوم، نحن إذا أردنا أن نبني بيتًا في هذه الدنيا، تقول لنا الأرض: حسنًا، ابنِ، لكن ادفع الثمن، واصرف وقتك، وأعطني من عمرك. فيتعب الإنسان سنتين أو ثلاثًا، ويبذل من عمره، فيحصل على بيت. نعم، دفعتَ الثمن وأخذتَ المثمَن؛ أي أعطيتَ العمر وأخذتَ شيئًا في مقابله.
لكن حين يحين وقت الموت، لا بدّ أن ندخل في هذه الحفرة ـ القبر ـ فالروح لا تأتي إلى هنا، بل تنتقل ـ إن شاء الله سالمة ـ إلى عالم آخر، إلى ديار العوالم المرسلة. غير أن هذا الجسد لا بدّ أن يُدفن في مكان ما.
فماذا سندفع هذه المرة؟ نحن أنفسُنا نكون الرهن.
كحال من يريد استئجار مخزن، وليس لديه مال يدفعه، فيقول: أضع هذه الحقائب في مخزنك. فيُقال له: حسنًا، ولكن تكون هذه الأمتعة رهنًا عندي، متى ما دفعتَ الأجرة أخذتها. كنتَ سابقًا تدفع الإيجار، أمّا الآن فلا تملك ما تدفعه، فيكون نفسُ المتاع هو الرهن.
وهكذا هو معنى الرهن.
ومعنى قوله: «رَهَائِنُ القُبُور» هو هذا تمامًا؛ أي إن الأموات قد صاروا مرهونين في القبور.
أنتم تعلمون أن ما يُتداول بين الإخوة الطلبة وغيرهم من مسألة الرهن والإجارة هو في حقيقته عقدان مستقلان شرعًا. فمَن أراد أن يستأجر بيتًا على نحو «رهن وإجارة» فإنما يتعامل مع مسألتين فقهيتين منفصلتين:
الأولى: أنه يدفع مبلغًا من المال إلى صاحب البيت بعنوان القرض؛ فهو يُقرضه هذا المال. وبما أنه أقرضه، فإنه يأخذ البيت رهنًا في مقابل هذا القرض، ليطمئن إلى استرجاع ماله. فهنا تحقّق عقد القرض من جهة، وعقد الرهن من جهة أخرى. أعطاه المال قرضًا، وأخذ البيت رهنًا ضمانًا لرجوع المال. وهذا تمام الأمر.
الثانية: أن هذا البيت الذي صار رهنًا لم يُبع، بل بقي على ملك صاحبه. وبحسب القاعدة الفقهية، فإن منافع العين المرهونة في مدة الرهن تكون للراهن لا للمرتهن. فهذا البيت الذي أُخذ رهنًا، لمن تكون منافعه؟ هي لصاحب البيت، أي للراهن، لا للمرتهن؛ لأنه لم يبع له البيت، وإنما أخذه رهنًا فقط.
إذًا: المرتهن يجب أن يكون أمينًا، ويحفظ بيت الناس، ولا يحق له أن يسكنه؛ لأن جميع منافع العين المرهونة في مدة الرهن تعود إلى الراهن، لا إلى المرتهن.
الثالثة: بعد ذلك يُنشأ عقد آخر، فيُبرم اتفاق جديد، فيقول صاحب المال لصاحب البيت: هذا البيت ملكك، وأنا أخذته رهنًا لئلا تبيعه، ومنافع العين المرهونة في مدة الرهن هي لك أنت. ولكن اسمح لي أن أسكن في هذا البيت، وأنا أستأجره منك. وهنا يتحقق عقد الإجارة.
وعليه، فـ«الرهن والإجارة» ليس عقدًا واحدًا، بل هو مجموعة مسائل فقهية متعددة: قرض، ثم رهن، ثم إجارة. وإلا فماذا يستأجر المرتهن؟! ما دام البيت رهنًا، فإن منافع العين المرهونة للراهن، والمرتهن لا يملك حق السكنى فيه. فكون البيت رهنًا لا يبيح له الدخول والسكنى، وإلا كان ذلك غير مشروع. ولا يجوز له أن يسكن إلا بعد تحقق عقد الإجارة، فيكون مستأجرًا شرعًا.
وعلى هذا الأساس قال الإمام (عليه السلام): «أنتم رهائن القبور»، فماذا يعني ذلك؟
يعني: ما دمتم أحياء، فإنكم تعطون شيئًا وتأخذون شيئًا؛ تعطون العمر وتأخذون بضع حجارة، تعطون العمر وتأخذون قطعة أرض، تعطون العمر وتأخذون مالًا. هذا هو حال التجارة في الدنيا. كون هذه التجارة خاسرة مسألة أخرى، لكن على كل حال أنتم تعطون وتأخذون.
أما حين تموتون، فماذا تملكون لتعطوه؟ لا شيء.
عندئذٍ يُؤخذ الإنسان نفسه رهنًا؛ لأنه مدين. أنتم مدينون للزمان والأرض، ونحن جميعًا مدينون للزمان والأرض، فيُؤخذ الإنسان نفسه. هذا الميت ماذا يملك؟ لا يملك شيئًا.
ولهذا قال (عليه السلام): هؤلاء «رهائن القبور»؛
مدينون أولًا،
ولا يملكون شيئًا يؤدّونه ثانيًا،
فتأخذهم الأرض رهنًا ثالثًا،
إلى أن يُفصل الأمر يوم القيامة رابعًا.
وأمّا فيما يتعلّق بالقيامة، فإن هذه السورة في القرآن الكريم سُمّيت سورة «التغابن»، حيث قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ﴾.
فالإنسان أعطى العقل وأخذ شيئًا آخر. وكل من سلك طريق الضلال، فلا شكّ أنه وضع عقله جانبًا، وعطّله، واتبع غير المعقول؛ إذ إن وظيفة العقل أن يكون عِقالًا، أي ما يقيّد الإنسان ويمنعه من الانحراف. فكل من ـ والعياذ بالله ـ مدّ يده إلى الحرام، سواء كان ذلك بالاختلاس، أو النهب، أو بأي صورة أخرى، فقد باع عقله وأخذ شيئًا آخر مكانه. هذا العقل الذي كان ينبغي أن يقيّده ويهذّبه لم يعد حاضرًا. وهذه في الحقيقة معاملة خاسرة.
وعلى هذا، فإن التحليل الذي قدّمه أمير المؤمنين (سلام الله عليه) لحقيقة الدنيا يرجع إلى هذه النتيجة:
إن الإنسان ما دام حيًّا فهو إمّا في حال تجارة أو في حال إجارة، لكنه في كلتا الحالتين مغبون؛ إذ يعطي أثمن ما يملك ويأخذ شيئًا زائلًا، وفي الحقيقة لا يملك شيئًا، وإنما يستأجر.
فإذا رحل عن الدنيا، فأين يذهب؟ هل يُطرح خارج الدنيا؟ هذا غير ممكن؛ فلا بدّ أن يُدفن في موضع من هذه الأرض. فماذا يملك ليقدّمه في مقابل ذلك؟ لا شيء. ولذلك يُؤخذ هو نفسه رهنًا. ولهذا وُصفوا بأنهم «رَهَائِنُ القُبُور»؛ أي إنهم مرهونون إلى أن يُفصل الأمر يوم القيامة. هذا هو حالنا مع هذه الدنيا.
ومن ذا الذي يستطيع أن يقدّم هذا النوع من التحليل؟
في إحدى خطبه قال (عليه السلام) إنه سيشرح الدنيا شرحًا لا يترك لأحد فيها رغبة. نعم، قد قيل إن حلال الدنيا للمؤمن طيّب وطاهر، ونحن نكتفي بهذا المقدار، لكن هذا النوع من التحليل العميق الذي يبيّن أن الدنيا على هذه الشاكلة، وأن الإنسان عند موته يكون مرهونًا بالقبر، لا مالكًا لشيء، لا يصدر إلا من مقام رفيع كهذا.
ثم في الكلمة النورانية التالية، وهي الكلمة 192، قال (عليه السلام): «يا ابنَ آدمَ، ما كسبتَ فوقَ قوتِكَ فأنتَ فيه خازنٌ لغيرِكَ».
أي إنك إذا جمعتَ أكثر من مقدار حاجتك، فأنت في الحقيقة خازن لغيرك، ومستودع لأموال الآخرين. وهذا أمر واضح. فما تكسبه بقدر حاجتك فهو لك، أمّا ما زاد على ذلك فأنت مجرّد أمين عليه لغيرك.
إن الله سبحانه وتعالى منح الإنسان هذا العمر، وهذا العقل، وهذا الذكاء، وهي من أعظم نعمه، لكي تُصرف في طريق لا انحراف فيه ولا ظلم، لا يضلّ الإنسان فيه ولا يقطع طريق غيره. وهذه الأدعية والكلمات كلّ واحدة منها مدرسة في الحكمة.
فأحيانًا يكون الكلام مجرّد موعظة ونصيحة، ولها بركتها الخاصة، وأحيانًا تكون الموعظة مصحوبة بالتحليل، وكلمات أمير المؤمنين (عليه السلام) غالبًا ما تكون كذلك، ولا سيما هذا الكتاب النوراني، نهج البلاغة.
فإن نهج البلاغة بأكمله يحتاج إلى فهرسة معجمية علمية دقيقة، وينبغي للحوزات العلمية وغيرها أن تبذل كل جهدها ليكون هذا الكتاب كتابًا رسميًا معتمدًا؛ لأنه كتاب علمي دقيق، لا يقتصر على الوعظ، وإن كان الوعظ أحد آثاره الكثيرة.
ثم قال (عليه السلام) في الكلمة اللاحقة: «إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً، وَإِقْبَالًا وَإِدْبَارًا؛ فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِي».
أي إن هذه القلوب بطبيعتها تمرّ بحالات متغيّرة؛ فمرّة تكون لها رغبة ونشاط، ومرّة تصاب بالفتور والإعراض، تارةً تُقبل، وأخرى تُدبر. فخاطبوها في وقت إقبالها، واستثمروها حين تكون مشتاقة ومهيّأة؛ لأن القلب إذا أُكره وأُجبر عمي، أي فقد بصيرته وأثره.
فالمراد أنّه عندما يكون الإنسان في حالة سعة صدر ونشاط نفسي، فلا ينبغي أن يُغفل عن المطالعة وطلب العلم. وحين يكون مزاجه منفتحًا وحاله حسنًا، فلا ينسى قراءة الكتاب والتحصيل العلمي. أمّا إذا كان فاقدًا للحوصلة بسبب حادثة مؤلمة، أو مرض، أو ضيق نفسي، فذلك له حكم آخر.
إن للقلب إقبالًا وإدبارًا؛ فإذا أقبل وكان في حال نشاط واستعداد، فذلك من أفضل الفرص التي ينبغي اغتنامها بملازمة العلم. لأن ما يُغرس في النفس في مثل هذه الحالات لا يكون مجرّد محفوظات عابرة، بل يتحوّل إلى علم مؤثّر راسخ.
ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعًا للانتفاع من هذه البركات النورانية، وأن نغترف من فيوضات كلمات أمير المؤمنين (سلام الله عليه).
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
- ترجمة مركز الإسلام الأصيل
الهوامش:
[1] سورة التغابن، الآية 9.
[2] سورة الفرقان، الآية 62.
[3] من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 610: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَوْضِعَ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَة».
[4] الصحيفة السجادية، الدعاء الثالث.