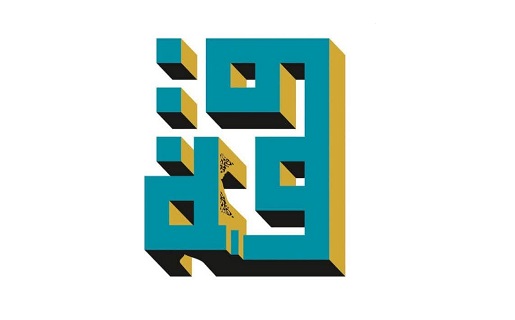خاصّ بشبكة الاجتهاد
تشهد الساحة الفقهية اليوم تصاعدًا ملحوظًا في النقاشات الثبوتية حول وجود «فقه النُّظُم» بين المتعاطين مع الفقه. فقد ذهب فريقٌ إلى أنّ الفقه، منذ لحظة تأسيسه الأولى، كان يمتلك بنيةً ونظامًا لم يُكشَفا بعد، وأنّ من واجبنا استنطاق هذا البناء الكامن من داخل الفقه، كي يتمكّن من الدخول في معالجة القضايا المستجدّة، ويتحرّر من الجمود وعدم القدرة على الاستجابة للمسائل الطارئة.
في المقابل، يرى فريقٌ آخر أنّنا لسنا سوى مكلَّفين بالتعبّد بالشريعة، ولا يُسمَح لنا بتجاوز دائرة هذه الأحكام نحو التعميم أو التوسعة. وبعبارةٍ أخرى، فإنّ النظرة الكلّية إلى الفقه خارج نطاق إدراك البشر، ولا يملكها إلا صاحب الشريعة نفسه، في حين أنّنا لا نصل إلى ملاكات الشريعة ولا إلى أنظمتها، وإنّما نتعبّد بالأحكام والمسائل المكشوفة منها فحسب. وعليه، فإنّ هذا التصوّر الكلّي البنيوي القائم على فهم الملاكات والمقاصد والمصالح الشرعية، هو خارج عن طاقة الفقيه وإمكاناته.
وهذا الفريق نفسه ينقسم إلى اتجاهين:
يرى بعضهم أنّ الشريعة، في الأساس، لا تمتلك نظامًا، بل هي مجرّد أحكام وظواهر جُعلت في مقام العمل ورفع التكليف عن المكلّف. أمّا مقام «النظام» فهو مقام الواقعية، وبما أنّ الأحكام الشرعية لم تُنشأ لبيان الواقع، فإنّ الشريعة لا تتصدّى أصلًا لبيان الواقع، وبالتالي لا يمكن افتراض بنية أو هيكل لها. وبعبارةٍ أخرى، فالشريعة ـ في نظرهم ـ لم تُشرَّع إلا لرفع التكليف، ولا تسعى إلى غايةٍ أو هدفٍ يتجاوز هذا الحدّ.
كما يذهبون إلى أنّ تكاليف الشريعة ليست جميعها في مقام تحصيل المصلحة، بل إنّ كثيرًا منها في مقام امتحان المكلَّف. وحيث إنّ جميع تكاليف الشريعة ليست قائمة على مصالح واقعية ونفس أمريّة، فلا يمكن افتراض مقاصد وأهداف نفس أمريّة لها.
ومن هنا نجد أنّ عددًا من فقهاء الشيعة يتّخذون من «التكليف» محورًا، فيسعون إلى كشف التكليف ولو في مقام الظاهر، من أجل تحصيل الحجّة الشرعية أمام الله تعالى. وبمجرّد تحقّق هذه الحجّة، يكون المكلَّف والفقيه قد بلغا غايتهما، إذ تحقّق المعذِّر والمنجِّز.
في المقابل، يرى آخرون أنّ أحكام الشريعة ذات أهداف، ونظم، وانسجام، غير أنّ هذه الأمور خارجة عن متناول الفقيه؛ إذ لا يملك الفقيه الوصول إلى ملاكات الأحكام، وإنّما يحكم على أساس ظواهرها فقط. وما دام الفقيه لا يصل إلى ملاكات الأحكام، فلا يمكنه تأسيس نظام، لأنّ ذلك خارج عن قدرته، إلا إذا قام الشارع المقدّس نفسه ببيان هذه الملاكات الواقعية، بحيث يمكن ـ على أساسها ـ كشف النظام.
ولكي يصبح الحديث عن «فقه النُّظُم» وتأسيس النُّظُم الفقهية ممكنًا، لا بدّ من مناقشة جملةٍ من الفرضيات والمبادئ، يمكن أن نطلق عليها عنوان «فلسفة فقه النُّظُم».
وأوّل أصلٍ لا بدّ من بحثه هو: إمكان القول بأنّ الحُسن والقُبح في الأشياء ليسا أمرين ذاتيّين، بل هما أمران اعتباريّان. لأنّه إذا سلّمنا بذاتية الحُسن والقُبح في الأشياء، فلن يمكن القول بأنّ الفقه منظومة متكاملة، ولا بأنّ الأحكام اعتباريّة على نحوٍ كلّي.
فالأحكام إمّا أن تكون ذاتية وفردية، وتشتمل على مصلحة نفس أمريّة في ذاتها، وإمّا أن لا تكون هناك مصلحة في ذات الأشياء بما هي أشياء، بل تكون المصلحة في «الكلّ بما هو كلّ».
إنّ التعبير بـ«فقه النُّظُم» يسير جنبًا إلى جنب مع «فقه المقاصد»؛ أي إنّ الفقه لا بدّ أن يكون ذا مقاصد وأهداف كلّية، وإنّ الشارع المقدّس إنّما جعل الأحكام من أجل بلوغ هذه الأهداف. وإلّا فلا يكون للحكم الجزئي في ذاته هدفٌ أصاليّ أو ذاتيّ.
ومثال ذلك قوانين المرور، حيث يضع المشرّع قوانين لتحقيق النظام الاجتماعي والمدني، كجعل الضوء الأحمر علامةً للتوقّف، والضوء الأخضر إذنًا بالعبور. ومن ثمّ قد نجد في بعض مناطق العالم أنّ دلالة هذه الألوان معكوسة تمامًا؛ فيكون الأخضر للتوقّف، والأحمر للمرور. فلا ذاتية في خضرة اللون أو حمرته، وإنّما الأمر مجرّد اعتبار.
وبناءً عليه، فإنّ القول بانسجام الأحكام على نحو النُّظُم الاجتماعية يقتضي بالضرورة الإقرار باعتبارية الأحكام، وعدم ذاتيّتها، وعدم كونها مشتملة على مصالح نفس أمريّة؛ إذ لو قيل بالذاتية، لتعذّر ـ أو تعسّر ـ الوصول إلى النظام. ومن هنا لا بدّ من بحث مسألة: هل الحُسن والقُبح ذاتيّان في الأشياء أم لا؟
وفي هذا السياق يمكن استقراء عدّة مسالك:
المسلك الأوّل: مسلك العدلية
وهم القائلون بذاتية الحُسن والقُبح في الأشياء، أي إنّ للأشياء ـ قبل أمر الشارع ونهيه ـ حُسنًا أو قُبحًا، وبعض هذه الصفات ذاتي لا يقبل الانفكاك، كما أنّ الزوجية ذاتية للعدد أربعة ولا يمكن فصلها عنه. وعلى هذا الأساس، يكون العدل حسنًا على الإطلاق، غير قابل للتقييد أو الاشتراط، ويكون الظلم قبيحًا على الإطلاق، غير قابل للتخصيص؛ لأنّ الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص.
غير أنّه لا بدّ من التنبيه إلى أنّ الحكم العقلي إنّما يجري في الموارد التي يكون فيها الحُسن والقُبح ذاتيّين. أمّا إذا لم يكونا ذاتيّين بل اقتضائيّين، فلا تجري هذه القواعد. ولذلك يقال: إنّ بعض الأحكام يكون الحُسن والقُبح فيها اقتضائيّين، تابعين للجهة المعتبرة فيها. وهذه الجهة الاعتبارية من قبل المعتبر مرتبطة بالعالم الخارجي؛ فإن كان الصدق لا يترتّب عليه ضرر، اعتُبر على نحو الوجوب، وإن ترتّب عليه ضرر، اعتُبر على نحو السلب والتحريم. وبعبارةٍ أخرى: إذا كان الفعل نافعًا جُعل وجوبه، وإذا كان ضارًّا جُعل تحريمه.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنّ أحكام العدلية ليست على نسقٍ واحد، بل تتنوّع: فبعضها ذو حُسن وقُبح ذاتيّين، وبعضها الآخر ليس كذلك. وكلام العدلية ـ بما هم عدلية ـ هو أنّ وجود مثالٍ واحدٍ للحُسن أو القُبح الذاتي كافٍ لإثبات مذهبهم. وهذا بخلاف الأشاعرة، الذين ينفون الذاتية نفيًا كليًا، ويقولون إنّ الحُسن والقُبح ليسا ذاتيّين في أيّ حكمٍ أو شيء، بل هما شرعيّان محض، تابعان لإرادة الشارع وقصده.
ومن اللافت أنّ بعض القائلين بفقه النُّظُم يذهبون إلى نفي ذاتية الحُسن والقُبح في الأشياء، أو على الأقل يُفهَم من كلامهم أنّ الأشياء لا تمتلك حُسنًا وقُبحًا ذاتيّين، ولا أنّ هناك أحكامًا شرعية ثابتة تكشف عن مصالح ثابتة أو حُسن ثابت. بل يرون أنّ الأحكام الشرعية والعقلية اعتبارات واصطلاحات جُعلت استجابةً لحاجات الشريعة أو لحاجات العقلاء في تنظيم العلاقات الاجتماعية. والنقطة المحورية في هذا التصوّر هي تلبية حاجات الحياة الإنسانية، وعلى هذا الأساس يتمّ جعل القوانين.
ومن هنا يبدو، في النظرة الأوّلية، أنّ فقه النُّظُم يتعارض مع القول بذاتية الحُسن والقُبح في الأشياء. ولذلك فإنّ من يريد القول بفقه النُّظُم، وجعل الفقه ذا نظام بشري قابل للإدراك، مع افتراض مقاصد وأهداف عليا له، لا بدّ له إمّا من الإجابة عن هذا التعارض، أو من إنكار الحُسن والقُبح الذاتيّين للأشياء رأسًا.
غير أنّ إنكار الحُسن والقُبح مطلقًا يبدو بعيدًا؛ لأنّ جميع القائلين بفقه النُّظُم ينتمون إلى العدلية، ويؤمنون بالحُسن والقُبح العقليّين قبل أمر الشارع. ومن ثمّ لا بدّ من معالجة هذا التعارض، ورفع التنافر المتوهَّم بين الإيمان بالحُسن والقُبح في الأشياء، والنظر إليها بنظرة نظامية.
وقد يُدّعى أنّه في مقام الثبوت والإمكان لا يوجد تنافٍ بين الأمرين؛ إذ يمكن أن تكون الأشياء ذات حُسن وقُبح ذاتيّين، وفي الوقت نفسه تمتلك نظامًا، بل ويمكن تحقّق ذلك خارجًا، وإن لم يكن قد تحقّق بعد.
غير أنّ الجواب هو: لو كان هذا الجمع ممكنًا ذاتًا ولا تنافر فيه، لكان ينبغي أن يتحقّق في الخارج أيضًا، أي لكان إدراكنا للحُسن والقُبح إدراكًا نظاميًّا بديهيًا. لكن الواقع أنّ هذا الانسجام ليس بديهيًا، بل هو نظري يحتاج إلى استدلال، وإلى الإجابة عن الإشكالات، بل وأحيانًا إلى نزع الذاتية عن بعض الأشياء من أجل الوصول إلى الانسجام الداخلي والنظرة المقاصدية. ومع ذلك، يبدو أنّ الجمع بين الحُسن والقُبح من جهة، والاعتبار والانسجام من جهة أخرى، أمرٌ ممكن.
وبيان ذلك: أنّ عدد الأحكام ذات الحُسن والقُبح الذاتيّين محدود جدًّا، كحُسن العدل وقُبح الظلم. وكون الحُسن ذاتيًّا يعني عدم إمكان انفكاكه عن العدل، مهما تغيّرت الجهات والاعتبارات. بخلاف كثيرٍ من الأشياء الأخرى، التي يؤدّي اختلاف الجهة فيها إلى تغيّر الحكم.
وبما أنّ غالب الأحكام إمّا اقتضائية في الحُسن والقُبح، أو لا اقتضائية، فلا يمكن القول إنّ جميع الأحكام ـ حتى عند العدلية ـ تتنافى مع الجعل والاعتبار وبناء النظام. فالكثير من الأحكام بطبيعتها قابلة للجعل تبعًا للاقتضاء. ويبقى الإشكال في الأحكام القليلة ذات الحُسن والقُبح الذاتيّين: كيف يمكن إدخالها في دائرة الجعل؟ وما علاقتها بالأحكام المجعولة المتغيّرة؟ هل هي أحكام متعالية، تشكّل إطارًا وضابطًا لسائر الأحكام دون أن تكون خاضعة للجعل؟
فالظلم ـ مثلًا ـ لا يمكن جعله قبيحًا بجعل الجاعل، لأنّ قبحه ذاتي غير قابل للتغيير. ولو قيل إنّ الجاعل هو الذي جعل قبح الظلم، لزم خروج الجاعل نفسه عن هذا القبح، ولما أمكن الحكم على أفعاله. وهذا ما يفتح باب القول بجواز الظلم على الشارع، كما تقول به الأشاعرة.
وعليه، لا بدّ من القول إنّ بعض الأحكام خارجة عن دائرة الجعل، وهي تشكّل الأساس لجميع الأحكام المجعولة، لكونها ثابتة في جميع الظروف. بخلاف غيرها من الأحكام التي تصدق من جهة دون أخرى؛ فالصدق ـ مثلًا ـ يكون قبيحًا من جهة الإضرار، وحسنًا من جهة حفظ النفس المحترمة، بينما العدل حسن من جميع الجهات.
في العقل العملي يُستعمل تعبير «الثبوت» بمعنى الثبات من جميع الجهات، بينما في العقل النظري يُستعمل تعبير «الصدق» بمعنى الصدق من جهة معيّنة. وإذا كان الحكم صادقًا من جميع الجهات كان بديهيًا، وإلّا كان نظريًا. وعلى هذا، فإنّ قضايا الحُسن والقُبح الذاتيّين تمثّل «أمّ القضايا» في العقل العملي، كما أنّ امتناع اجتماع النقيضين هو «أمّ القضايا» في العقل النظري.
فهذه القضايا ليست قضايا ذات مصاديق جزئية، بل هي قضايا متعالية تجعل صدق وثبوت سائر القضايا ممكنًا، كما أنّ الوجود ليس موجودًا بين الموجودات، بل هو أصلها وأساسها.
ومن هنا، فإنّ الحُسن والقُبح الذاتيّين ـ المعبَّر عنهما بحُسن العدل وقُبح الظلم ـ ليسا قضايا موجودة، بل هما أساس التقييم في العقل العملي، وبدونهما لا يمكن لأيّ تقويم قيمي أن يتحقّق.
وقد ذهب بعض الأصوليين، مع إقرارهم بإدراك العقل للحُسن والقُبح الذاتيّين، إلى إنكار قاعدة «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع»، بحجّة أنّ مصالح الشارع أوسع من مصالح العقل، وأنّه لا يمكن استنتاج الوجوب الشرعي من مجرّد حكم العقل بالحُسن.
ويمكن تفسير هذا الإنكار بأنّ إدراك العقل للحُسن والقُبح ليس إدراكًا لفعلٍ من الأفعال الجزئية، بل إدراك استعلائي في مجال الحكمة العملية، تمامًا كما أنّ الوجود في العقل النظري ليس شيئًا بين الأشياء، بل أساسها. فحُسن العدل وقُبح الظلم ليسا فعلين جزئيين، بل أساسًا تُقاس عليهما الأفعال.
ولو كانا فعلين جزئيين، لتعلّق بهما الحكم الشرعي مباشرة، لكنهما ليسا كذلك. وإنما الشارع الحكيم يُجري شريعته في الأفعال على أساس هذين المعيارين.
كما أنّ إدراك العقل للمصالح والمفاسد في الأشياء ليس إدراكًا تفصيليًا، بل هو إدراك استعلائي، في حين أنّ بيان الشارع هو الذي يحدّد مقدار الحُسن والقُبح والمصلحة والمفسدة. وكما قال المرحوم آية الله الخوئي: «ليس لنا طريقٌ إلى إدراك المصلحة والمفسدة في الأشياء سوى بيان الشارع، لأنّ الأحكام توقيفية».
وعليه، فإنّ العقل يدرك الكليات، والشرع يبيّن الجزئيات. وقد عبّر العلماء عن ذلك بقولهم: «الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية».
والنتيجة التي نصل إليها هي أنّ مجعولات الشريعة قائمة على أساس الحُسن والقُبح، لكنّ أفعال المكلّفين في ذاتها ليست ذات حُسن وقُبح، بل تُقيَّم على أساس الاعتبار الشرعي ومقاصد الشريعة. فالشريعة، بوصفها منظومة اعتباريّة، إنّما تجعل الأحكام وفق أهدافها.
ومن هنا يمكن الجمع ـ إلى حدٍّ ما ـ بين القول بالذاتي والاعتباري، وإظهار أنّ الجعل الاعتباري نفسه قائم على أساس الحُسن والقُبح، دون القول بتباينٍ جذري بينهما.
بل لعلّ هذه النظرية تتيح تقريب وجهات النظر بين الأشاعرة والمعتزلة، وتمنح للجعل والاعتبار موقعًا معقولًا، مع الحفاظ على المكانة الأساسية للعقل في الإدراك، وحلّ التعارض بين العقل والدين على نحوٍ متوازن ومقبول.
الكاتب: هادي غلامي
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل
*تعليق مركز الإسلام الأصيل: يلاحظ على البحث إشكال منهجي يتمثّل في عدم انسجام البناء الفعلي للمقال مع الإعلان التمهيدي عن تعدّد المسالك في المسألة؛ إذ يقتصر العرض التفصيلي على مسلك العدليّة، بينما يُذكر موقف الأشاعرة عرضًا وفي سياق جدلي لا يرقى إلى مستوى مسلك علمي مكتمل، الأمر الذي يُضعف إمكان المقارنة المنهجيّة التي يُفترض أن تمهّد للنتيجة. والأهمّ أنّ الكاتب ينتهي عمليًّا إلى تبنّي موقف تركيبي يقوم على الإقرار بقيم استعلائيّة محدودة ذات حُسن وقُبح ذاتيَّين، مع اعتبار المجال الواسع للأحكام والنُّظُم خاضعًا للجعل الشرعي والمقاصدي، غير أنّ هذا المسلك المركزي لم يُعنون ولم يُبرز بوصفه نتيجة مستقلة، بل جاء متفرّقًا في ثنايا البحث. ويترتّب على هذا الخلل البنيوي إضعاف الحجّية النظريّة لأطروحة فقه النُّظُم، إذ يبدو الدفاع عنها أقرب إلى خيار انتقائي منه إلى ثمرة مقارنة علميّة واضحة بين المسالك.