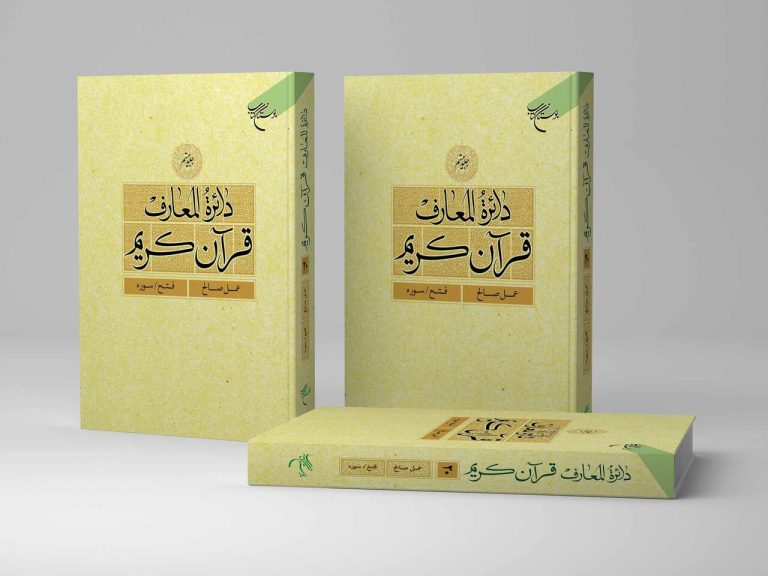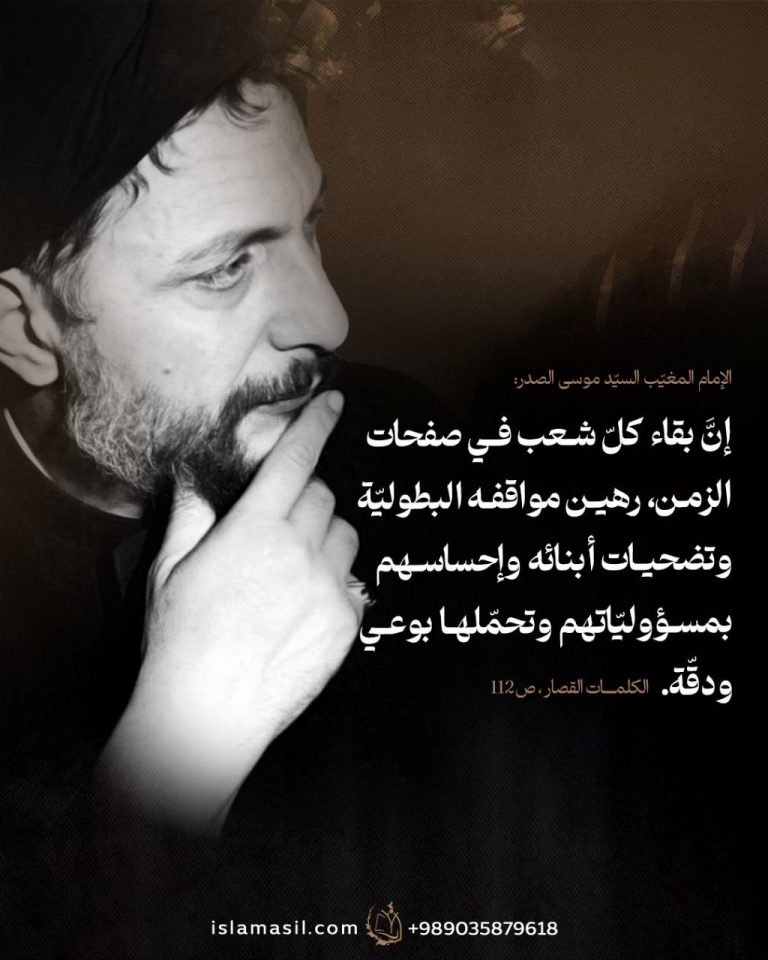في مناظرةٍ علميةٍ تناولت موضوع «مكانة العقل في الجغرافيا الفقهية»، شدّد الأستاذ أبو القاسم علیدوست، من خلال تفريقٍ دقيق بين «الفقه» بوصفه علمًا بشريًا و«الشريعة» بوصفها حكمًا إلهيًا معصومًا، على الدور المحوري للعقل العملي في عملية استنباط الأحكام الشرعية، مؤكّدًا أنّ الاجتهاد الشيعي يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، غير أنّ هذا الاجتهاد نصّيّ المحور لا مبنائيّ المحور، وأنّ الفقاهة الشيعية لا يجوز لها الغفلة عن المباني.
وبيّن ضرورة الالتفات، في عمليتي الاستظهار والاستنباط من النصوص، إلى المقاصد الشرعية وإدراكات العقل، من دون أن يتحوّل العقل وما يدركه من ملاكات إلى أساسٍ وبنيةٍ مستقلة لاستخراج النظريات الفقهية.
وفي المقابل، قدّم الأستاذ حسن رمضاني، مع تأكيده على الفهم العقلائي للمصالح والمفاسد بوصفها أساسًا للأحكام، مقاربةً وظيفية (براغماتية)، وصرّح قائلًا:
إنّ العلوم وإن قُسِّمت إلى منقولٍ ومعقول، إلا أنّ المنقول نفسه لا يُقبل ما لم يتحوّل إلى معقول. فجميع أحكام الدين عقلية، ويمكن لنا، من خلال التفريق بين الملاكات الأصلية والملاكات التبعية في الشريعة، أن نستبعد تلك الملاكات التبعية التي لم تعد منسجمة مع عالم اليوم، ونجعل الملاك الأصلي هو المعيار المعتمد.
وبحسب تقرير شبكة الاجتهاد، فقد انعقدت هذه المناظرة العلمية بعنوان «مكانة العقل في الجغرافيا الفقهية» بين الأستاذ حسن رمضاني (تلميذ آية الله حسن زاده الآملي وأستاذ الفلسفة والكلام) والأستاذ أبي القاسم علیدوست (عضو جماعة مدرّسي الحوزة العلمية في قم ورئيس جمعية الفقه والقانون الإسلامي في الحوزة العلمية)، وذلك برعاية مؤسسة الإمام علي (ع) البحثية.
القسم الأول من المناظرة
في القسم الأول من هذه المناظرة العلمية، تناول الأستاذان بيان معنى ومفهوم «الفقه» ومدى ملاءمته للقرن الحاضر.
وفي مستهلّ الحديث، أوضح الأستاذ أبو القاسم علیدوست، مؤلف كتاب «الفقه والعقل»، أنّ للفقه في العصر المعاصر ثلاثة اصطلاحات ومعانٍ:
- يُطلق أحيانًا على علم الفقه بوصفه حقلًا معرفيًا.
- ويُراد به أحيانًا عملية الاستنباط التي يقوم بها الفقيه.
- ويُراد به أحيانًا المسائل الفقهية المعيارية المتضمنة للأوامر والنواهي.
وأضاف: إنّ المقصود من «الفقه» في هذه الجلسة هو المعنى الأول، أي علم الفقه، وإن كان قد يُراد به في بعض الموارد ـ بقرينة السياق ـ معنى الاستنباط أيضًا.
وعليه، فإننا حين نتحدث عن «الفقه» فإننا لا نقصد به «الشريعة». فـالشريعة هي ذلك الجانب القانوني والاعتباري الذي جعله الله تعالى، ومن هنا يكون الفقه كاشفًا، وتكون الشريعة مكشوفة. وبناءً على ذلك، يسعى علم الفقه إلى استخراج الشريعة الإلهية من أدلتها ومصادرها، ووضعها في متناول المكلّفين.
وبيّن عضو جماعة مدرّسي الحوزة العلمية في قم أنّ الشريعة ليست متعددة، بل هي من الله تعالى وعلى لسان المعصوم، ولا سبيل للخطأ إليها، في حين أنّ الفقه نتاج الاجتهاد البشري؛ ولذا فإنّ نصيب الإنسان داخل في الفقه، ومن هنا يكون عرضة للخطأ، وغير معصوم، وقابلًا للاختلاف والنقد.
وعليه، فإن الحديث عن «الفقه والعقل» في هذا السياق يرمي إلى تحديد دور العقل في هذا الكيان الذي يتمثل في علم الفقه وعملية الاستنباط.
كما أشار إلى أنّ الشريعة تُطلق أحيانًا على مجموع الدين، ويُعبّر عنها بـ**«الشريعة بالمعنى الأعم»**، وأحيانًا تُطلق على الأحكام الشرعية خاصة، وتُسمّى «الشريعة بالمعنى الأخص»، وقد قارن في حديثه بين هذا المعنى الأخير وبين الفقه.
مداخلة الأستاذ حسن رمضاني
من جانبه، قال الأستاذ حسن رمضاني:
إنّ «الفقه» في اللغة يعني الفهم العميق، و«العقل» كذلك يدل في حقيقته على الفهم، وإن كان بعضهم قد أرجعه إلى مادة «العِقال» بمعنى المنع، ففسّر العقل بأنه القوة التي تمنع الإنسان من الوقوع في الشرور. غير أنّ المعنى الأصلي للعقل هو الفهم.
وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ﴾ يعني: لعلّهم يفهمون.
وبصورة عامة، فإنّ الفقه هو الفهم العميق للدين في الفروع الفقهية على أساس الأدلة الخاصة بها، لا في المسائل الاعتقادية وأصول الدين، وذلك في الموارد التي لا يوجد فيها نصٌّ صريح؛ لأنّ الاجتهاد في مقابل النص غير جائز.
القسم الثاني من المناظرة
في القسم الثاني من المناظرة، عمد الأساتذة إلى تبيين معنى ومفهوم «العقل».
قال الأستاذ أبو القاسم علیدوست في هذا السياق:
إذا افترضنا أنّ «الفقه»، بوصفه علمًا أو عمليةً استنباطية، يسعى إلى استخراج الشريعة من الأدلة والوثائق المعتبرة، فمن الطبيعي أن نرجع إلى «العقل». ومن المسلَّم أنّ المقام هنا ليس مجالًا لحوارٍ موسّع حول هذه المؤسسة المعرفية. فصدر المتألهين يرى أنّ لفظ «العقل» يُستعمل في معانٍ ومراتب متعدّدة، وأنّه لو جُعل موضوعًا لعلمٍ مستقل، وأُلّف فيه كتابٌ خاص، لكان ذلك في محلّه.
وعندما نقول «العقل»، فإنّ المقصود أنّ كلّ إنسان يجد في باطنه قوّةً يشعر أنّه يُصدر بها أحكامه، وبالاعتماد على إدراكات هذه القوّة يدرك حُسن الأشياء وقُبحها. فالقوّة التي يُدرك الإنسان بها هذه المعاني تُسمّى «العقل»، ونحن نعتمد هذا المعنى للعقل.
ويقول الأستاذ لنگرودي: إنّ بعض الأشياء لا يمكن تعريفها بحدٍّ جامعٍ مانع، ولكن يمكن إحصاء عناصرها ومكوّناتها.
ويقول الإمام عليه السلام:
«ما عُبدَ به الرحمن، واكتُسِبَ به الجِنان».
وكذلك في الروايات، حين نلج هذا الباب، نرى أنّ الإمام عليه السلام ينسب إلى العقل هذه العناصر والآثار بعينها؛ فالعقل نور، والعقل هادٍ، والعقل دليل. وكان فقهاؤنا وأكابر علمائنا، حين يتحدّثون عن العقل، يقصدون هذه المعاني نفسها.
كما هو معروف، يُقسَّم العقل إلى قسمين أساسيين: العقل النظري والعقل العملي.
فالعقل النظري هو ذلك العقل الذي يُشبه العقل الرياضي، والذي يُعنى بالإخبار عمّا «هو كائن». أمّا «العقل» فقد يتصدّى أحيانًا لمقام العمل، فيأمر بالواجبات وينهى عن المحظورات.
ومن البيانات المشهورة في هذا الباب أنّ العقل النظري والعقل العملي ليسا قوّتين مستقلّتين ولا ماهيتين متغايرتين، بل هما ماهية واحدة لها متعلّقان:
فإذا تعلّق العقل بما هو كائن، كان عقلًا نظريًا، وإذا تعلّق بما ينبغي أن يكون أو لا ينبغي أن يكون، كان عقلًا عمليًا.
وعليه، فإذا جرى الحديث عن دور «العقل» في الفقه، فإنّ المقصود هو العقل العملي.
سؤال دبیر الجلسة
طرح أمين الجلسة هذا السؤال:
ما هو ملاك العقل ومعياره؟
فعلى سبيل المثال، قبل 1400 سنة لم تكن العبودية تُعدّ أمرًا قبيحًا، بينما نرى اليوم، في القرن الحادي والعشرين، أنّ العقلاء يكادون يُجمعون على قبحها. فما هو معيار هذا العقل في الفقه؟
جواب الأستاذ علیدوست
قال الأستاذ علیدوست في بيان ملاك العقل وحجيّته:
إنّ واحدةً من أكثر القضايا إشكالية، وأعمق الثغرات النظرية، هي مسألة «الملاكات العقلية». ويمكن تقريب هذا البحث وبيانه بصورٍ متعدّدة.
فإذا كان اعتبار كلّ شيءٍ راجعًا إلى العقل، فبِمَ يكون اعتبار العقل نفسه؟
والجواب الممكن هو أنّ العقل يجد حجيّته واعتباره في ذاته.
فأنت لا تحتاج إلى إقامة دليل لإثبات جوعك، لأنّ هذا من قبيل العلم الحضوري لا العلم الحصولي. وإذا كانت القضية من سنخ العلم الحضوري، وكان الإنسان يجدها في باطنه، فإنّه يعتقد بها مباشرة، من دون أن يلزم دور، أو أن يبحث عن أداة خارج هذه المؤسسة المعرفية.
وإذا أقام العقلاء سيرةً معيّنة، فإنّها لا تكون محلّ خلاف، بل تكون مورد اتفاق العقلاء كافة.
مداخلة الأستاذ رمضاني
وقال الأستاذ حسن رمضاني في القسم الثاني من المناظرة، في حديثه عن ملاك العقل وحجيّته:
إنّ النفس الناطقة الإنسانية تتأثّر بالمبادئ العليا، وتدرك ما هو كائن في متن الواقع وتفهمه، وهذا ما نسمّيه فهم «الهست والنيست» (الوجود والعدم)، وهو ما يُعبَّر عنه بالعقل النظري.
وهناك قسم آخر من الإدراك لا يهدف إلى فهم ما هو موجود أو غير موجود، ولا إلى تصديقه أو إنكاره، بل يهدف إلى فهم ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه، وهذا هو ما يُعبَّر عنه بـ«العقل العملي».
ومحور بحثنا هنا هو إدراك الواجبات والمحظورات.
ولا شكّ أنّ الملاك في ذلك هو أنّ الإنسان، بالالتفات إلى الأدوات المتاحة لديه، وبإدارة العقل والقوّة التي يمتلكها، يدرك أنّ في فعلٍ معيّن أو في شيءٍ ما مصلحةً مُلزِمة لا يجوز تفويتها بحال، وأنّ عليه أن يُحقّقها بفعله، فيصدر الحكم بـالوجوب.
أو يدرك وجود مصلحة راجحة، فيُحكم بـالاستحباب.
أو يدرك وجود مفسدة مُلزِمة لا يمكن التغاضي عنها، وأنّ المصلحة تكمن في ترك الفعل، فيصدر الحكم بـالحرمة.
أو يدرك، بالأدوات المتوفّرة لديه، وجود مفسدة راجحة، فيُحكم بـالكراهة.
وأحيانًا لا يلتفت إلى أيّ مصلحة أو مفسدة، وهو ما يُعبّر عنه الفقهاء بـالإباحة.
وهنا، حيث لا يدرك العقل الإنساني شيئًا، فإنّه لا يُصدر حكمًا.
ويقول الإمام الرضا (ع):
لم نجد موردًا حُكم فيه بالوجوب إلا وكانت فيه مصلحة، ولم نجد في شريعة الإسلام موردًا حُكم فيه بالحرمة إلا وكانت فيه مفسدة.
وفي الحديث الذي أورده الأستاذ علیدوست بمضمون:
«ما عُبدَ به الرحمن، واكتُسِبَ به الجِنان»،
فإنّ الشطر الأوّل منه ناظر إلى البُعد النظري، أمّا الشطر الثاني فهو ناظر إلى بُعد العمل، ومختصّ بـالعقل العملي.
في معرض ردّه على إشكال أمين الندوة القائل بأن “الرق” كان يُعدّ أمراً مقبولاً لدى “العقلاء” قبل ١٤٠٠ عام، وكيف صار اليوم مذموماً في نظرهم، أوضح الأستاذ رمضاني قائلاً: “إنّ هذا المورد يُعدّ استثناءً من القاعدة العامة. فظروف ذلك الزمان ومقتضيات الفهم آنذاك فرضت نمطاً معيناً من التعامل مع أسرى الحروب؛ فإما السجن، وإما الاستفادة منهم كقوة عاملة عبر استرقاقهم. واليوم، لم يعد العقل الجمعي يرتضي الاسترقاق بصيغته القديمة، لكنه لا يزال يقبل بمبدأ السجن أو النقل إلى مراكز العمل (كالمناجم مثلاً) تحت الحراسة كقوى عاملة، ريثما تتهيأ مقدمات تحررهم؛ وهذا إجراء عقلائي بامتياز.”
وأضاف: “المقصود بـ (العقلاء بما هم عقلاء) هم الأحرار المستقلون في تفكيرهم، الذين يدركون المصالح والمفاسد ويبنون أحكامهم عليها. فعلى سبيل المثال، السرقة مفسدة يجب استئصالها، وكانت عقوبتها آنذاك قطع اليد. وكذلك الفاحشة عمل مذموم يقتضي الاجتثاث -لا سيما في حال الزنا بالمحصنة- ويتم ذلك بأي وسيلة يرتئيها العقلاء؛ وقد كان الرجم هو الوسيلة حينها. فإذا كان الهدف هو (اجتثاث الفاحشة)، فإن أي وسيلة تحقق هذا المقصد تُعدّ معقولة ومشروعة. ولكن، هل يتعين أن يبقى الرجم هو الوسيلة اليوم؟”
وأشار رمضاني إلى أن هذه المسائل تخضع لـ “القبض والبسط” (المرونة والمواكبة) وفقاً لظروف الزمان والمكان ومقتضيات المجتمع البشري، حيث ينبغي لـ “العقلاء بما هم عقلاء” دراسة الآفات والأضرار للوصول إلى استنتاج قانوني يحدد العقوبات المناسبة. وينطبق هذا الأمر على حدّ السرقة؛ فإذا كانت هذه العقوبة تحقق هدف حماية الملكية العامة والخاصة اليوم، استُمرّ العمل بها. كما أدرج مسائل الزكاة وحرمة الاحتكار ضمن الموارد القابلة للتغير والمواكبة التي تستوجب انعقاد المجالس التشريعية لدراسة آثارها وسنّ القوانين بشأنها.
وفي سياق متصل، استعرض تجربته مع الأستاذ علي دوست خلال رحلة الحج، حيث تداولا في مسألة “صلاة المسافر”، قائلاً: “المعيار العقلائي هو هل السفر يسبب (حرجاً) للمكلف أم لا؟ فإذا كان حرجياً، فالحكم بالتقصير هو حكم (امتناني). قديماً كان معيار الحرج يُقدر بمسافة ثمانية فراسخ، لكن مع تغير وسائل النقل، هل يبقى الملاك ذاته؟ على فقهائنا الجلوس وتبيين (الملاك التبعي) بناءً على (الملاك الأصلي)؛ فالملاك الأصلي هو صفة ‘المسافر’، والثمانية فراسخ ليست إلا ملاكاً تبعياً.”
كما تطرق إلى مسألة “الماء القليل”، موضحاً أن الأصل العقلائي يقضي بنجاسة الماء إذا تأثر بالنجاسة، أما إذا لم يتأثر (بأن لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه) فلا ينجس. وعن “الموسيقى”، أشار إلى وجود أدلة تحرم استخدام بعض الآلات، لكنه استدرك: “لا يمكن إطلاق القول بالحرمة؛ بل المدار هو (الغناء الشرعي) الذي يسلب الإنسان قيمه الإلهية ويرديه في وحل الحيوانية والشهوات، كالغناء الذي كان في عهد بني أمية. أما إذا كانت تلك الألحان وسيلة لترسيخ المعارف، فأي وجه للحرمة فيها؟”
من جانبه، وتعقيباً على كلام الأستاذ رمضاني حول القاعدة الكلية للوجوب والحرمة، قال الأستاذ علي دوست: “أنا أحصر دور العقل في دائرة الواجبات والمحرمات فقط، وأرى أن (قاعدة الملازمة) تختص بإدراك (المصلحة الملزمة) التي يتولد منها الوجوب، وإدراك (المفسدة الملزمة) التي ينشأ منها التحريم. ومع ذلك، فإن ما تفضل به الأستاذ رمضاني له مؤيدون من كبار أساطين الأصول، كالمحقق النائيني.”
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ علي دوست إلى الحديث الذي نقله الأستاذ رمضاني عن الإمام الرضا (عليه السلام) برواية “محمد بن سنان” حول مسألة المصالح والمفاسد، والذي يحمل مضمون: «حيثما وجدت المصلحة وجد الأمر، وحيثما وجدت المفسدة وجد النهي»، معقباً بأنّ هذا النص لا يثبت الملازمة العكسية -أي القول بأنّ كل مورد صدر فيه أمرٌ فهو يشتمل بالضرورة على مصلحة، وكل مورد صدر فيه نهيٌ فهو يشتمل على مفسدة- فهذا الوجه لا يمكن الدفاع عنه. إنّ الإمام (ع) في هذا الحديث يستهدف الفكر “الأشعري” بنقدٍ لاذع؛ إذ ذهب الأشاعرة إلى أنّ الإرادة الإلهية لا تتبع أي معايير موضوعية (ملاكات)، حتى صرّح ابن حزم بأنّ وصف الله بـ “الحكيم” هو مجرد اسم مجرد، لا بمعنى صدور أفعاله عن حِكَم ومصالح. ومن هنا، يقرّر الإمام (ع) في مواجهة هذا الاتجاه أنّ الأحكام الإلهية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية؛ وبناءً عليه، يطرح التساؤل: هل يسوغ للشارع المقدس جعلُ حكمٍ بناءً على مقتضى المصلحة؟ والجواب هو الإيجاب.
وعوداً على ما طرحه الأستاذ رمضاني حول مسائل “الرجم”، “الرق”، “صلاة المسافر”، “انفعال الماء القليل”، “الغناء”، و”قطع يد السارق”، أوضح الأستاذ علي دوست: «إنّ الزعم بأنّ إنكار “الرق” في عصرنا الحالي يُعدّ خروجاً عن ضرورة الشريعة، أو أنّ الرق بصورته المعهودة يمثّل ضرورة شرعية، هو زعمٌ غير سديد. فقد وجدنا في تاريخنا فقهاء خاضوا في هذا المضمار، ووجود مثل هذه الآراء الفقهية يفتح آفاقاً للتوسعة والمرونة. ألم يذهب المرحوم السبزواري في بحث “الغناء” إلى أنّ التحريم كان ناظراً إلى الغناء الذي كان سائداً في بلاط بني أمية وبني عباس؟ وفي مسألة “صلاة المسافر”، نجد أكابراً من فقهائنا لا يسلّمون بكون المسافة المحددة (٤٥ كيلومتراً ذهاباً وإياباً) موجبة للقصر بشكل قطعي؛ حتى إنّ بعض فقهائنا التقليديين، كآية الله الميلاني، نُقل عنه أنه كان يجمع في صلاته بين التمام والقصر في طريقه من قم إلى طهران».
وتابع موضحاً الفوارق المنهجية في الاستنباط: «نحن في مدرسة الاجتهاد الشيعي نؤمن بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بيد أنّ اجتهادنا “نصِّيُّ المرتكز” (نص محور) وليس “مبنائي المرتكز” (مبنا محور) فحسب. ففي الفلسفة الحقوقية الغربية، يُعدّ “المبنى” أو القاعدة النظرية بمثابة السند والوثيقة المرجعية لفيلسوف القانون، لعدم وجود نصّ مقدّس (قرآن أو رواية) بين يديه؛ أما في الفقاهة الشيعية، فلا ينبغي الذهول عن “المباني”، لكنّها فقاهة “سندية المرتكز” (سند محور). ومع ذلك، فإنّ تلك المباني قد تؤثر في فقه النص وفهمه؛ فقد يُفهم النص العام على أنه خاص، أو النص الخاص على أنه عام ببركة تلك المرتكزات. فعلى سبيل المثال، في مسألتي “الزكاة” و”الاحتكار”، قد لا تسعفنا الأدلة في توسعة الزكاة لتشمل غير الأصناف التسعة المشهورة، بيد أنّ يد “الحاكم الصالح والمصلح” تظل مبسوطة في حال قيام المصلحة. وفي سياق “الاحتكار” أيضاً، هل يتعين علينا حصر مواجهة الأزمة تحت عنوان “الاحتكار” الفقهي حصراً؟ أم يسعنا القول بأنّ للسلطة حق “التجريم” القانوني؛ فإذا شحّ “زيت الطعام” مثلاً في المجتمع، جاز اعتبار محتكره مجرماً؛ ذلك أنّ واقعة الاحتكار كانت قائمة حتى في عصر الأئمة (ع). لذا، فإنّ أي “انفتاح” ننشده لا ينبغي أن يكون عبر العبث بالأدلة، بل عبر التمسك بالمباني والأسناد، واتباع سياق “الفقاهة الشيعية الدارجة” والمضيّ قدماً وفق تقاليدها الرصينة.
خذ مثلاً مسألة “الرجم”؛ إذ يُقال إنها من تراث اليهود، لكننا حين نراجع الروايات نجد قرابة ١٠٠ رواية تتعلق بهذا الحكم. ومع ذلك، ثمة قاعدة تقضي بأنه إذا أدى تنفيذ “الحدّ” إلى إثارة “النفور” والابتعاد عن الدين، أو بلغ درجة من القبح (المجتمعي) بحيث لا يمكن الدفاع عنه، فلا ينبغي تنفيذه؛ لأنه قد يؤول في بعض الأحيان إلى ارتماء الآلاف في أحضان الكفر. فإذا ما رعينا معايير الاجتهاد وأعرافه، فلا يسعنا تجاوز هذه المحاذير».
ثم خلص الأستاذ علي دوست إلى القول: «ثمة ثلاث رؤى في هذا الصدد؛ الأولى: *الرؤية النصية التي تمنح الأصالة المحضة للنص والاسم، وليست مستعدة للتخلي عن أي رواية استناداً إلى العقل. الثانية: رؤية الأستاذ رمضاني وكثير من المثقفين والمجددين لدينا. والثالثة: الرؤية التي تقرأ النصوص في ضوء الغايات والمقاصد*، وهي التي أعتقد أنها تمثل المنهج الوسط».
وفي سياق متصل، استشهد الأستاذ حسن رمضاني بكلمة للإمام الخميني وردت في كتابه “كشف الأسرار”، حيث قال: «أحكام الدين هي ذاتها أحكام العقل، وهي لا تتغير بتغير الزمان؛ فاثنان زائد اثنين تساوي أربعة أبداً، والظلم قبيحٌ سرمدياً، ولم تكن الفاحشة والجور يوماً من الأيام حسناً ولن تكون كذلك؛ وسواء فني العالم وهلك، أو بلغ ذروة الحضارة والتعالي، فالحكم هو الحكم».
وعقّب الأستاذ علي دوست على هذا الاستشهاد قائلاً: «يجب علينا تحليل سياق هذا المكتوب؛ فقد صدر في مناخٍ كان يدّعي فيه البعض أنّ أحكام الله خاصة بما قبل ١٤٠٠ عام وأنها تفتقر للعقلانية، فكان لزاماً على الفقيه أن يقدّم ردّاً مناسباً لذلك الطرح. وهذا لا يعني بالضرورة أنّ الإمام يجعل العقل هو البنيان الوحيد في هذا الكلام. إن نصوصنا ليست على نسقٍ واحد؛ ومنطلقنا يجب أن يكون من “النص”، لكن النص قد يكون في بعض الموارد قابلاً لأن تؤثر في فهمه مقاصدنا ومبانينا الكلية».
وفي معرض إشارته إلى أنّ نصوصنا تمثل “الحد الأدنى” مراعاةً لظروف الزمان، تناول مسألة “تحريم الربا” قائلاً: «أرى أنّ أصل تحريم الربا يعود إلى منع تراكم الثروة لدى فئة معينة على حساب إضعاف فئات أخرى. بيد أنّ التساؤل المطروح هنا: هل “التسهيلات” التي تقدمها البنوك للأفراد تندرج تحت عنوان “القرض” ليترتب عليها بحث “الربا القرضي”، أم أنها نوعٌ من “المشاركة”؟ فإذا قُدِّمت هذه المبالغ بصفة القرض، فإن مسألة الربا القرضي ستكون واردة وحاضرة، ومن ثمّ تقع في دائرة الحرمة؛ أما إذا كانت تندرج تحت عقود التسهيلات الائتمانية، فهي تسهيلات تهدف إلى تمكين الفرد اقتصادياً، ولا ينبغي خلطها بالربا في القرض. كما ورد في الروايات أنه إذا أقرض شخصٌ آخر، فإنه يُستحب للمقترض أن يردّ أكثر مما اقترض».
وأردف الأستاذ علي دوست قائلاً: «إننا في الفضاءات الفكرية الأخرى -سواء تلك التي لا ترتضي إطلاقاً أخذ “المباني” بعين الاعتبار، أو تلك التي تنبذ النص بالكلية- نجد أنفسنا نقترب من بعضنا البعض. حتى “الأخباريون” يصرحون بأنه إذا خالف “الخبر الواحد” أو الرواية “العقل القاطع”، فإننا نضرب بتلك الرواية عرض الجدار، شريطة أن يكون ذلك العقل قطعياً لا ظنياً أو متوهَّماً».
وأضاف موضحاً: «إنّ بعض الأمور التي تُوسم بالربا ليست ربا في حقيقتها. لقد زرت أحد المراجع العظام، وقلت له: إنّ صوتكم هو الأعلى تقريباً في انتقاد العمليات المصرفية، حتى إنّ بعض مقلديكم استقالوا من وظائفهم في البنوك؛ ولكن، هل يمكننا بالنظر إلى وضع “التضخم” في بلادنا أن نجزم بأنّ هذه العمليات هي ربا؟ إنّ مشكلة البنوك لا تقتصر على الربا فحسب، بل الربا واحد من مشكلاتها، ويجب أن نضيف إليها قضايا مثل “خلق النقد” وتراكم الرساميل وتحول البنوك إلى مؤسسات تجارية. أما في بحث “حيل الربا”، ففي بعض الأحيان تكون الحيلة حقيقية (صورية) ويجب الالتفات إليها».
وفي الختام، قال الأستاذ حسن رمضاني: «رغم تقسيم العلوم إلى قسمين: “منقول” و”معقول”، إلا أنّ ذلك “المنقول” ما لم يرتدِ حُلّة “المعقول” فلن يحظى بصفة “المقبول”؛ بمعنى أنه لا بد من تقديم دفاع عقلاني عن المنقول، وإلا فإنّ الدفاع غير المعقول يلحق الضرر بالدين نفسه أكثر من أي شيء آخر. وفي ظل مناخ العقلانية الذي يتجه إليه العالم اليوم، ما لم نجعل المنقول معقولاً، فلن يكون مقبولاً».
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل