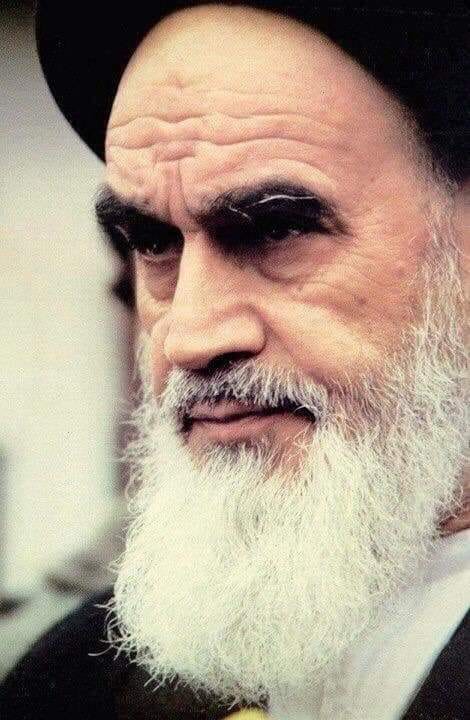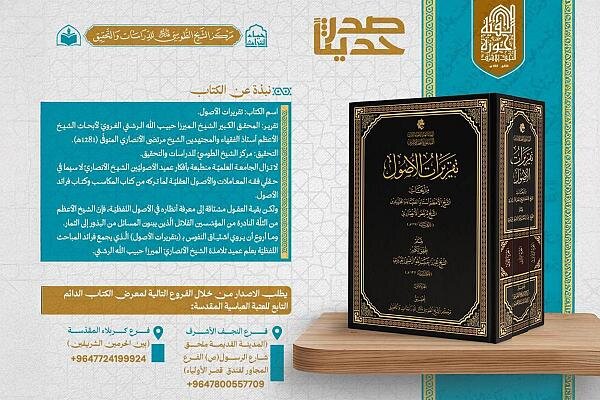الثباتُ على طريق الهدف
إن نجاح أيّ شخص مرهونٌ بأمرين:
الأول: الايمان بالهدف.
والثاني: الاستقامة والثبات والسعي الدائب لتحقيق ذلك.
إنَّ الإيمان هو المحرِّك الباطني والقوة الخفية الّتي تجر الإنسان شاء أم لم يشأ نحو الغاية الّتي يتوخاها، وتسهِّل عليه الصعاب، وتدعوه إلى العمل الدائب لتحقيق مقصوده، لأن شخصاً كهذا يعتقد اعتقاداً قويّاً بأنَّ سعادته، ومجده يتوقَّفان على ذلك.
وبعبارة اُخرى: إذا آمن انسان بأن سعادته ومجده يتوقفان على تحقيق هدف معيّن فانه سيندفع بقوة الإيمان نحو تحقيق ذلك الهدف، متجاوزاً كل الصعاب، ومتحدياً كل المشكلات في ذلك السبيل.
فالمريض الّذي يرى شفاءه في شرب دواء مرّ مثلا سيستسهل شُربه.
والغوّاص الّذي يعتقد اعتقاداً جازماً بأن ثمّة درراً غالية الثمن تحت أمواج البحر سيلقي بنفسه في قلب تلك الأمواج دونما خوف أو وجل، ليخرج منها بعد دقائق ظافراً بأغلى الجواهر.
بينما إذا كان المريض أو الغوّاص يشكُّ في عمله، أو يعتقد بعدم فائدته، فانَّه لن يُقدمَ عليه قط واذا ما أقدم فان عمله سيكون حينئذ مقروناً بالجهد والعناء.
فقوة الإيمان اذن هي الّتي تذلّل كل مُشكل، وتسهِّل كلَّ صعب.
غير أنه لا ريب في أنَّ الوصولَ إلى الهَدف لا يخلو من مشكلات وموانع، فلابدّ من السعي لرفع تلك الموانع، وإزالة تلكم المشكلات.
وقد قيل قديماً: أنَّ مع كل وردة أشواك، فكيف يمكن قطف وردة دون أن تُدمى أنامل القاطف بالأشواك المحيطة بها؟؟
هذا وقد بيّن القرآنُ الكريمُ هذه المسألة (وهي ان رمز السعادة هو: الإيمان بالهدف والثبات في طريق تحقيقه) في جملة قصيرة إذ قال: «إنَّ الَّذيْن قالُوا ربُّنا اللّه ثُمَّ استقامُوا تتَنَزَّلُ عَليْهِمْ الْمَلائكة أنْ لا تَخافُوا وَلا تَحزَنُوا وأبْشروا بِالجَنَّةِ الّتي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»([1]).
ثَباتُ النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وَصَبرُهُ:
لقد أدّت إتصالاتُ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الخاصّة، قَبل الدعوة العامة، وجهودُه الكبرى بعد الجهر بالدعوة، إلى ظهور وتكوين صفٍّ مرصوص من المسلمين في وجه صفوف الكفر، والوثنية.
فالَّذين دخَلُوا سرّاً في حوزة الإسلام والإيمان قبل الدعوة العامّة تعرَّفوا على المسلمين الجدد الذين لبُّوا داعي الإسلام بعد إعلان الرسالة، وشكّل القدامى والجدد جماعة قوية متعاطفة متحاببة، وكان ذلك بمثابة إنذار لأوساط الكفر والشرك والوثنية، أربكها وجعلها تشعر بالخطر.
على أنّ ضرب نهضة ناشئة والقضاء عليها كان أمراً سهلا لقريش، ولكنّ الّذي أرعب قريشاً ومنعها من توجيه مثل هذه الضربة هي أنَّ أفراد هذه الجماعة، وعناصر هذه النهضة لم يكونوا من قبيلة واحدة، ليمكن مواجهتها وضربُها بكلّ قوة، بل إنتمى من كل قبيلة إلى الإسلام، عددٌ من الأفراد، ومن هنا لم يكن إتخاذ أيّ قرار حاسم بحقّهم أمراً سهلا وبسيطاً.
من هنا قرّر سادة قريش وكبراؤها ـ بعد تداول الأمر في ما بينهم ـ أن يبدأوا بالقضاء على أساس هذه الجماعة، ومحرِّك هذا الحزب، والداعي إلى هذه العقيدة بمختلف الوسائل فيحاولوا ثنيه عن دعوته بالاغراء والتطميع تارة ويمنعوا من انتشار دينه بالتهديد والايذاء تارة اُخرى.
وقد كان هذا هو برنامج قريش وموقفها من الدعوة طيلة عشر سنوات وهي المدة المتبقية من سنوات البعثة من الفترة المكية، إلى ان قررت بالتالي قتله، ولكنه استطاع أن يبطل مُؤامرتهم بالهجرة إلى المدينة قبل أن يتمكنوا من القضاء عليه.
ولقد كان «أبو طالب» آنذاك زعيم بني هاشم ورئيسها المطلق، وكان رجلا طاهر القلب عالي الهمّة، شجاعاً، كريماً، وكان بيته ملجأ دافئاً للمحرومين والمستضعفين، وملاذاً أميناً للفقراء والأيتام، وكان يتمتع في المجتمع العربي ـ علاوة على رئاسة مكة وبعض مناصب الكعبة ـ بمكانة كبرى ومنزلة عظيمة، وحيث أنّه كان كفيلا لرسول اللّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم) بعد وفاة جدّه «عبد المطلب»، لذلك حضر سادة قريش بصورة جماعية([2]) عنده وقالوا له:
«يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سبّ آلهتنا، وعابَ دينَنا، وسفَّه أحلامنا وضلّل آباءنا، فإمّا أن تكفّه عنّا، وإما أن تخلّي بيننا وبينه».
ولكن «أبا طالب» قال لهم قولا رفيقاً وردَّهم ردّاً جميلا حكيماً، فانصرفوا عنه.
بيد أنَّ نفوذ الإسلام وانتشاره كان يتزايد باستمرار، وكانت جاذبيّة الدّين المحمَّدي، وبيان القرآن البليغ يساعدان على ذلك، فيترك اثره في الناس، وخاصة في الأشهر الحرم حيث تفد الحجيجُ على مكة من مختلف أنحاء الجزيرة، وكان النبيّ (لىاللهعليهوآلهوسلم) يعرض دينه عليهم، فكانت أحاديثه الجذّابة، وكلماتُه البليغة، ودينُه المحبَّب تؤثر في قلوب كثير منهم، فيميلون إلى الإسلام ويقبلون دعوة الرسول.
وهنا أدرك طغاة مكة وفراعنتها أن «محمَّداً» قد بدأ يفتح له مكاناً في قلوب جميع القبائل، واصبح له انصارٌ واتباعٌ في كثير منها، ممّا دفعهم مرّة اُخرى إلى الحضور عند «أبي طالب» حاميه الوحيد، وتذكيره بالإشارة والتصريح بالأخطار المحدقة باستقلال المكّيين وعقائدهم نتيجة نفوذ الإسلام وانتشاره فقالوا له أجمع: يا أبا طالب، إن لك سنّاً، وشَرفاً، ومنزلة فينا، وإنّا قد استنهيناك مِن ابن اخيك فلم تنهَه عنّا، وإنا واللّه لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا، حتّى تكفه عنّا، أو ننازله وإيّاك في ذلك حتّى يهلك أحد الفريقين.
فأدرك حامي الرَّسول الوحيد ـ بذكائه وفطنته ـ أنّ عليه أن يصبرَ أمام جماعة ترى وجودها، ومصالحها في خطر، من هنا عَمد إلى مسالمتهم وملاطفتهم، ووعدَ بأن يبلغ ابن اخيه «محمَّد» كلامهم. وقد كان هذا محاولة من «أبي طالب » لتسكين غضب تلك الجماعة الغاضبة وإطفاء نائرتهم، وتهدئة خواطرهم، ليتمَّ معالجة هذه المشكلة ـ بعد ذلك ـ بطريقة أصحّ وأفضل.
ولهذا أقبل ـ بعد خروج تلك الجماعة من عنده ـ على ابن اخيه، وذكرَ له ما قال له القومُ، وهو يريد ـ بذلك ضمناً ـ اختبار إيمان «محمَّد» بهدفه، فكان الردُّ العظيمُ، والجوابُ الخالد الّذي يعتبر من أسطع وألمع السطور في حياة قائد الإسلام الاكبر «محمَّد» رسول اللّه (صلىاللهعليهوآلهوسلم)، حيث قال لعمّه بعد أن سمع مقالة قريش: «يا عَمّ، واللّه لو وضعُوا الشَمْس في يميني، والقمرَ في يساري، على أن أترك هذا الأمر حتّى يظهرهُ اللّه، أو اهلكَ فيه، ما تركُته».
ثم اغرورَقتْ عيناه الشريفتان بدموع الشوق والحب للهدف، وقام وذهب من عند عمه.
وكان لتلك الكلمات الصادقة النافذة أثرٌ عجيب في نفس زعيم مكة وسيدها الوقور بحيث نادى ابن اخيه، وأظهر له استعداده الكامل للوقوف إلى جانبه، والحدب عليه رغم كل المخاطر، والمتاعب الّتي كانت تكمن له إذ قال: «اذهَبْ يا ابْن أَخي فَقُلْ ما أحبَبْتَ فَو اللّه لا اُسلمك لِشَيء أبداً».
سيرة سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله)، آية الله الشيخ جعفر سبحاني