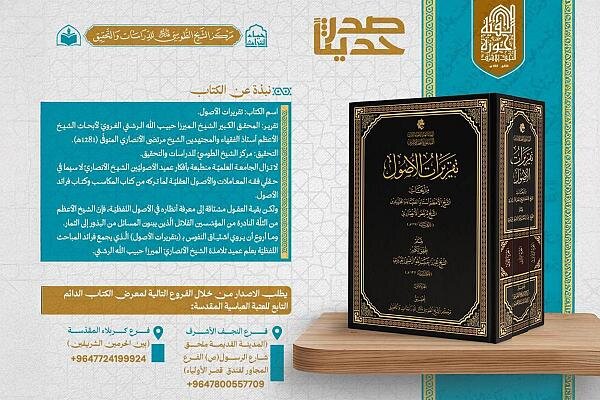تمهيد
قال تعالى: ﴿ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾1.
قبل الدخول في موضوع الاجتهاد والتفقّه في الدّين، أحببتُ أن أتحدّث قليلًا عن أحد المفكّرين في العالم الإسلاميّ ممّن خاض في الاجتهاد وأكّد عليه، وهذا المفكّر هو “محمّد إقبال اللّاهوري”، وهو من المفكّرين المعاصرين، وينحدر من شبه القارّة الهنديّة، الهند سابقًا والباكستان حاليًّا.
نشأ في أسرة مسلمة، ودرس العلوم الجديدة، وأنهى دراسته مع العلم أنّه قد درس العلوم القديمة أيضًا، وكان ذا حسٍّ إسلاميّ على العكس من الأغلبيّة الساحقة من طلّابنا الإيرانيّين الّذين سرعان ما يتأثّرون بالأجانب تأثّرًا عجيبًا، وكانت له شهادة عليا في فرع الفلسفة، وألّف كتبًا باللّغة الإنجليزيّة تعدّ من المصادر الّتي اعتمد عليها المستشرقون. وكان متحمّسًا للإسلام، وعلى درجة عالية من الوعي الإسلاميّ، وكان يعتقد أنّ الإسلام هو المنقذ الوحيد للبشريّة. وبالإضافة إلى أنّه من المجدّدين وأصحاب الاطّلاع على الأفكار الحديثة، فقد قال شعرًا كثيرًا. ولا تهمّنا الآن هذه الجوانب من حياته.
يقول هذا المفكّر: “قال لي أبي جملة أصبحت درسًا لي في حياتي، قالها عندما كنتُ مشغولًا بتلاوة القرآن، فسألني: “ماذا تفعل؟” قلتُ له: “أقرأ القرآن”، قال: “يا بُنيّ! اقرأ القرآن كأنّه نزل عليك”، فأثّرت هذه الجملة في قلبي أثر النقش في الحجر، وكنت بعدها كلّما أقرأ آية لا أتجاوزها حتى أتأمّل فيها وأتدبّر”.
ضرورة الاجتهاد
إنّ الّذي دعاني أن أذكر هذه الشخصية كلامه في الاجتهاد، موضوع بحثنا هذا، يقول “إقبال”: “إنّ الاجتهاد هو القوّة المحرّكة في الإسلام، مثله في ذلك مثل القوّة الّتي تحرّك السيّارة، فالسيّارة لا تتحرّك ما لم تكن لها قوّة تحرّكها، ولـ”ابن سينا” أيضًا كلام حول الاجتهاد يذكره في بحث جامع له في كتاب الشفاء عندما يتطرّق فيه إلى المبادئ الاجتماعيّة والمبادئ العائليّة. يقول: “لا حدّ للحاجات الّتي تظهر في حياة الإنسان”. إنّ الأصول في الإسلام ثابتة لا تتغيّر، وليست ثابتة من وجهة نظر الإسلام فقط، بل هي حقائق يسلم بها كمبادئ حياته في الأزمنة والعصور كافّة، وحكمها حكم منهج واقعي حقيقي لا بدّ منه، أمّا الفروع فهي متغيّرة ولا حدّ لها”.
ثمّ يردف قائلًا: “لهذا السبب نقول بضرورة الاجتهاد وأهميّته”. وبعبارة أخرى، لا بدّ من وجود أخصائيّين وخبراء في كلّ عصر، لهم القدرة على تقديم الحلول المناسبة لمشكلات ذلك العصر من خلال استنباط الأحكام الجزئيّة التفصيليّة الملائمة لكلّ فترة من المصادر المجملة للتشريع الإسلامي، ولهم القابليّة على الاستجابة للتطوّرات الحاصلة من خلال إدراكهم أنّ المسألة الفلانيّة الجديدة في أيّ أصل من الأصول.
ويمكن القول إنّ الاجتهاد قد فقَدَ روحه في واقعنا المعاصر، ولم تعد له تلك المنزلة الّتي تناسبه حيث يتصوّر الناس أنّ مسؤولية المجتهد تكمن في استنباط المسائل والأحكام الفقهيّة فقط، والّتي لها حكم واحد مهما تعاقبت الأزمنة والعصور مثل التيمّم، هل تكفي ضربة واحدة أو ضربتان؟ فأحد الفقهاء يقول: الأقوى ضربة واحدة، والثاني يقول: الأحوط ضربتان. وأمثال هذه المسائل، في حين أنّ هذه المسائل ليس لها أهميّة تذكر، إذ أنّ الأهميّة ينبغي أن تُركَّز على المسائل الجديدة والمستحدثة الّتي تظهر في كلّ عصر. ويجب التأكّد والاطمئنان من انطباقها على ما هو موجود في الشريعة من أحكام مجملة. لذلك، فإنّ “ابن سينا” ينطلق من هذا المنطلق، وفي تأكيده على ضرورة الاجتهاد ولزوم ترك بابه مفتوحًا في جميع الأزمنة والعصور. ولو أخذنا هذا الأمر بعين الحسبان، وبذلنا جهودنا لإعادة الحياة للاجتهاد بحقيقته، فسنكون على خلاف واضح مع عامّة المسلمين من غير أتباع أهل البيت، إذ يرون أنّ الاجتهاد مقتصر على أشخاص معيّنين، وهذا ما لا يراه أتباع أهل البيت، حيث يطالبون بترك باب الاجتهاد مفتوحًا في كلّ عصر من العصور، في حين يرى المسلمون عامّة أنّ المجتهدين أربعة فقط وهم: “أبو حنيفة”، و”مالك”، و”الشافعي” و”أحمد بن حنبل”، ويجوّزون عليهم الخطأ.
الاجتهاد والتفقّه في الدّين
يقول القرآن الكريم: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ..﴾2. فالنفر المذكور هنا هو النفر من أجل الاجتهاد، ومهما قيل في منطوق الآية، فالهدف واضح من ذلك النفر من خلال التّعبير القرآني نفسه عندما يقول: ﴿ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾. تطرّق القرآت إلى هذه القضيّة المهمّة، وسمّاها التفقّه في الدّين، وهذا التعبير أعمق معنًى من تعبير علم الدين. فهناك تعبيران إذًا، أحدهما: علم الدين، والثاني: التفقّه في الدين، والعلم مفهومه واسع، ويمكن إطلاقه على كثير من حقول المعرفة. أمّا التفقه فهو ليس كذلك، ولا يمكن استعماله في كلّ مكان؛ لأنّه يعني التعمّق في العلم، ودرجته أعلى من درجة العلم، وهو بعبارة أخرى، العلم العميق الّذي لا يتسنى لكلّ أحد، ويمكن أن نسمّي العلم السطحيّ علمًا ولا نسمّيه تفقّهًا.
يقول “الراغب الأصفهاني”: “التفقّه هو التوسّل بعلم ظاهر إلى علم باطن”؛ فهو التقاط اللبّ من بين القشور، وهو إدراك اللّامحسوس من خلال المحسوسات، وهو يعني أنّ الإنسان لا يتعامل مع الدين تعاملًا سطحيًّا، بل تعاملًا عميقًا هادفًا، مدركًا أنّ في الدين جانبَيْن: الجانب الروحي، والجانب المادي، مبتعدًا عن الفهم المبتور المشوّه للدين من خلال التركيز على جانب واحد فقط، ولا تتيَسَّر معرفة الدّين معرفة واعية من خلال جانب واحد فحسب، بل من خلال كلا جانبَيْه.
إنّنا نطالع الأحاديث والروايات الواردة أحيانًا فنجد بعضها يقول: “يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه”3. وهذا الكلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وله كلام آخر قاله وهو يستعرض مستقبل بني أميّة، ومنه: “أيّها الناس! سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه”4.
فهذه الأقوال تبيّن لنا أنّ قسمًا من التعاليم الدينيّة تشبه الإناء، وهي وعاء للقسم الآخر من التعاليم الدينيّة الّتي تشبه الماء. فهذا الوعاء ضروري ولكن لذلك الماء، ولو كان هذا الوعاء نفسه فلا يُكفأ ماؤه، أمّا إذا كان هذا الوعاء موجودًا من دون ذلك الماء فكأنّه غير موجود. فالإمام عليه السلام أراد من وراء هذا التشبيه أن يقول إنّ الأمويّين يفرغون الإسلام من محتواه، ويقضون على جوهره، ويشوّهون حقيقته، ولا يُبقون للناس منه إلّا القشور.
وللإمام عليه السلام كلام آخر، وهو أيضاً في صددّ الحديث عن بني أميّة، يقول فيه: “ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبًا”5. وإذا كان الإسلام هكذا، فهذا يعني أنّه فَقَدَ روحه، وأصبح معرضًا للسخريّة والاستهزاء بسبب تصرّفات الأمويّين المنحرفين.
فكلّ ما مرّ من أقوال وأمثالها تبيّن أنّ بعض النّاس يدّعي الإسلام ولكنّه الإسلام الفارغ من محتواه، الفاقد لروحه وحركيّته. والبعض الآخر يدّعيه كدين فاعل مؤثّر، أي الإسلام بما هو إسلام بحقيقته ومعناه.
تأثير الاجتهاد في متطلّبات العصر
ينقل أحد الأصدقاء أنّه في مرّة من المرّات واجهته مشكلة، فذهب إلى أحد معارفه يلتمس منه حلّها، مع أنّها كانت مشكلة بسيطة، ولكن بالنسبة إلى صاحبها كانت لها أهميّتها الخاصّة. يقول: “فاعتذر بعلّة أنّه يريد الذهاب إلى صلاة الجماعة، فلو قال أحد هنا أنّ الإسلام قد أكّد على صلاة الجماعة تأكيدًا كثيرًا إلى الحدّ الّذي لم يلتفت معه إلى قيمة العمل المؤدّى في قضاء الحاجة فهذا كلام خاطىء، وهل هناك فرق في حساب الله بين أن نصلّي فرادى أو نصلّي جماعة؟ ولِمَ أكّد الإسلام على صلاة الجماعة؟ أليس ذلك من أجل أن يعيش الناس جوًّا روحيًّا ومعنويًا، يلتقي أحدهم بالآخر، ويتفقّد أحدهم أحوال الآخر؟ وهو كذلك، وما ذكر من التأكيد على صلاة الجماعة وكثرة ثوابها هو لكي تصنع من الناس أناسًا ذوي عطف وضمير، ويسعى أحدهم في قضاء حوائج الآخر. فصلاة الجماعة قشر في داخله لبٌّ كامن، وما هذا اللبّ إلّا العواطف الاجتماعيّة والتفكير بأمور الآخرين”.
كلّ ذلك يدلّل على أنّ في الإسلام لبًّا وقشور، وله ظاهر وباطن. فلا بدّ من التفقّه إذًا. والتفقّه يعني حصول الإنسان على المعنى المراد، فلو قال أحد: إنّ الاجتهاد هو القوّة المحرّكة للإسلام، أو قال آخر: إنّه ضروري في كل عصر وزمان وروح الإسلام روح ثابتة في الأزمنة والعصور كافّة، فلا مكان للشبهة القائلة إنّ متطلّبات العصر تستوجب نقض حكم الإسلام. وهنا أودّ أن أذكر مثالًا من القرآن، وهو قوله تعالى:
﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ..﴾6، فهذا أمر بالإعداد واضح بكل صراحة، والهدف مذكور أيضًا، فالإسلام دين القوّة لا دين الضعف، وهذا ما يقرّ به أعداؤه من الأجانب.
يقول “ويل ديورانت”: لا وجود لدين دعا أتباعه إلى القوّة كالإسلام. فالإسلام أكّد على القوّة، وطلب من المسلمين أن يكونوا أقوياء، ويسوؤه أن يرى المسلمين ضعفاء، ولا ينسجم منطق الضعف مع تعاليمه؛ لأنّه يوصي المجتمع الإسلامي بإعداد نفسه بكلّ ما يملك من قوّة لمواجهة الأعداء. ومن ناحية الهدف والغاية يصدر الأمر السماوي بأن يكون المسلمون أقوياء من الناحية الماديّة إلى الحدّ الّذي يرهبون به أعداء الله. وكما نرى الدول الكبرى هذا اليوم كيف أدخلت الرعب في قلوب الشعوب، فكذلك يريد القرآن من المسلمين أن يكونوا أقوياء إلى الحدّ الذي لو رآهم أعداؤهم، يهابون سطوتهم، ويخافون منهم، ولا يخطر في بالهم الاعتداء عليهم. وهناك صنفان من القائلين بمنطق القوّة: صنف يطلب القوّة من أجل الاعتداء على الآخرين، وصنف آخر يطلبها لمواجهة ذلك الاعتداء، والحيلولة دون استفحاله، وهذا عين ما يريده القرآن الكريم إذ ينادي بالقوّة للوقوف بوجه الاعتداء والسلب والنهب، ولا يوصي المسلمين بالقوّة وسيلةً للاعتداء. وما أروع الأدب القرآني إذ يقول: ﴿ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ﴾7، وهنا يخاطب المسلمين أن لا يخرجوا عن حدّ العدالة حتى مع أعداء الله الّذين أساؤوا إليهم. وكذلك لا يجيز لغيرهم الاعتداء. فهذه أوامر ينبغي إطاعتها.
وعندما نأتي إلى السُنّة النبويّة الشريفة فإنّنا نلتقي بسلسلةٍ من الآداب والسنن المحمّديّة الّتي رسمها معلّم الإنسانية الأوّل لتكون منهجًا للحياة. والّتي تتّصل بموضوعنا سالف الذكر، ومن هذه الآداب السبق والرماية، – كما يصطلح عليهما في الفقه – وأكّد الإسلام على استحبابهما، وحرّم كلّ لون من ألوان المقامرة إلّا بهما، وهذا من مسلّمات الفقه إذ توجد أمثال هذه السنن والآداب في ديننا.
قد يأتي هنا من يتّصف بالتزمّت والجمود فيقول: إنّ الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ..﴾ شيء، وأمر الفروسيّة والرماية شيء آخر، أي إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوصى بهما، وأكّد على تعليمهما لأولادنا، فإنّما يدلّل على ولع منه فيهما، ولذلك يجب بقاؤهما على ما هما عليه في الأزمنة والعصور كافّة! والحال أنّ القضيّة ليست بهذا الشكل؛ لأنّ الرماية وركوب الخيل هما وليدا قوله تعالى:
﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾. والمُهمّ في الإسلام أن يكون المسلمون في الحدّ الأعلى من القوّة، وما الرماية وركوب الخيل إلّا مثالان عليها، ولا أصالة لهما لأنّهما يمثّلان الشكل التطبيقي لها.
وبعبارة أخرى، هما كاللّباس على البدن. والإسلام لا يرى لهما أصالة بل يرى الأصالة للقوّة، وهما أمّارتان على تلك القوّة. مع العلم أنّنا لا نقصد من كلامنا عدم الأصالة على اعتبار أنّهما من أوامر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لا من أوامر الله الواردة في كتابه العزيز! كلّا، إذ لا فصل بين أوامر الله وأوامر نبيّه، فهي أوامر واحدة، فليفهم من أراد! والقضيّة أنّ الإسلام أمر بشيء وأراد هو تنفيذه هو بذاته مرّةً، وأخرى أمر بشيء مقدّمة لشيء آخر، وما دور التفقّه في الدين إلّا أنّه يساعد الإنسان على بلوغ مراده.
وهناك مثال آخر في نهج البلاغة، حيث ينقل أنّ شخصًا جاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: لو غيّرت شيبكَ يا أمير المؤمنين، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: “غيّروا الشيب”، فقال عليه السلام: “الخضاب زينة ونحن قوم في مصبية”8. (يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وكأنّه يريد أن يقول عليه السلام إنّ هذا الأمر ليس له أصالة وذلك لأنّه كان لهدف معيّن يخصّ ذلك العصر، أمّا الآن فقد انتفى ذلك الهدف. لقد كان عدد المسلمين قليلًا، وبينهم شيوخ كبار قد اشتعلت لحاهم شيبًا، وعندما كان ينظر إليهم العدو يراهم قطعة بيضاء من الشيب فتقوى عزيمته، ويشتدّ ساعده، وترتفع معنويّته. ولا يخفى، فإنّ قوّة المعنويّات لها الدور الأول في المعركة، لذلك أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الشيوخ المقاتلين أن يغيّروا شيبهم حتى لا تقوى عزيمة العدو حينما ينظر إلى كبر سنّهم.
فهذا هدف كان يخصّ تلك الفترة بالذات، أمّا اليوم فلا وجود له. لهذا كلّ شخص حرّ من هذه الناحية، فتغيير الشيب أمر طارىء متغيّر، أمّا قوّة المعنويّات فهي أمر ثابت غير قابل للتغيير. ويجب أن يبقى مفعولها ساريًا في الأزمنة والعصور كافّة، وكذلك أضعاف معنويّات الأعداء في حرب أو في سلم، ينبغي أن تبقى على حرارتها في كلّ عصر. وما علينا نحن المسلمين إلّا الالتفات إلى هذه النقطة الحسّاسة، ورفع النواقص الموجودة عندنا، ولا نعمل ما من شأنه أن يستضعفنا الأعداء. وهذا مبدأ ثابت تتفاوت أساليب تنفيذه بين فترة وأخرى، وقد يكون تغيير الشيب أسلوبًا ملائمًا لفترة معيّنة، وقد يكون هناك أسلوب آخر لفترة أخرى، فلا تتغيّر إلّا أساليب التنفيذ لا غير، وهذا هو مغزى التفقّه في الدين والبصيرة فيه، إذ يقدّم لنا أنجع الأساليب وأنسبها في كلّ عصر منبثقة من تلك الثوابت الأساسيّة في الشريعة.
إنّ من مميّزات الإسلام أنّه جعل المتغيّرات الّتي تتبدل في كلّ عصر متّصلة بالثوابت الّتي لا يطرأ عليها أي تغيير، أي إنّه جعل للأحكام الفرعية التفصيليّة علاقة بالأحكام المجملة في الشريعة، ولا يستطيع أن يكشف هذه العلاقة إلّا المجتهد الّذي يعطي رأي الإسلام في كلّ واقعة من خلال الملكة الّتي يختصّ بها، وهذه هي القوّة الحركيّة في الإسلام.
لا يخفى، أنّ مظاهر الجمود عند الإخباريّين كثيرة، منها مظاهر الجمود والتزمّت الّذي عليه بنى الإخباريون موقفهم من “التحنّك”، والتحنّك يقابلُ الاقتعاط في اللّغة العربية، والاقتعاط يعني شدّ العمامة على الرأس. وقد تحرّر المرحوم “الفيض الكاشاني” من ربقتهم رغم إخباريّته، وبالإضافة إلى أنّه كان إخباريًّا، بيد أنّه كان شبه فيلسوف ممّا ساعد هذا الأمر على تنوير فكره.
لقد جمع المرحوم “الفيض الكاشاني” بين متطلّبات الروح والجسد، وأوتي قدرة على التشخيص. يقول هذا العالم: “كان الاقتعاط شعار المشركين، أي أنّهم كانوا لا يتحنّكون بل كانوا يشدّونها، لذلك فإنّ عدم التحنّك يعني القبول بشعار المشركين. وفي ضوء هذا التوجّه الّذي كان عليه المشركون، صدر الأمر بالتحنّك. أمّا في الحقيقة فلا موضوعيّة لهذا الأمر بما هو، بل الموضوعيّة تكمن في معارضة المشركين، وعلى المسلم الحقيقي أن لا يتمسك بشعار غير إسلامي وغريب عليه.
لقد كان هذا الأمر ساري المفعول في وقت كان يعيش فيه أولئك المشركون بذلك الشعار، أمّا اليوم فلا وجود لهم ولا وجود لشعارهم، لذلك لا ضرورة لهذا الشعار الّذي كانت فلسفته معاكسة ومعارضة للمشركين. هذا كلام المرحوم “الفيض”. فهل نسخ حكمًا إسلاميًّا بكلامه هذا؟
لا، بل إنّه استوعب فلسفة الأمر الصادر بالتحنّك وعرف مغزاه. وهذا هو معنى الاجتهاد الّذي عبّر عنه “محمد إقبال” بالقوّة المحرّكة في الإسلام، وهو نفسه الّذي رأى “ابن سينا” ضرورته في كلّ عصر وزمان. ولقد ميّز المرحوم “الفيض” بين اللبّ والقشور.
وهناك مثال آخر، لو سأل أحد: هل أنّ لبس القُبعة الأجنبيّة، أو لبس السترة والبنطلون حرام؟ نقول: لا، حيث إنّ هذه الأشياء قد حُرمت في عصر من العصور، والآن هي غير محرّمة. فمثلًا كانت القُبّعة تخصّ الأجانب في وقت من الأوقات، وكان لبسها يعني أنّ الإنسان مسيحيّ. لذلك كان المسلم إذا لبسها يرتكب حرامًا، ولكن بما أنّها اليوم أصبحت زيًّا سائدًا، وفقدت هدفيّتها، وليست اليوم كما كانت بالأمس، لذلك لبسها غير حرام. ولا حاجة أن يأتي نبيّ من الأنبياء ليحكم في هذه القضيّة، كما أنّ حكم الإسلام واحد لم يتغيّر.
في اعتقادي، إنّ الاجتهاد من معجزات الإسلام. ولا يعني الاجتهاد أن يجلس شخص ويفتي كيف يشاء. كلّا، بل له قوانينه الخاصّة به. وكما ذكرت سلفًا، فإنّ الإسلام تميّز بمواصفات ذاتيّة جعلته قادرًا على مواصلة دربه، وديمومة حركيّته دون أن يكون هناك تعارض أو تضارب مع قوانينه وقواعده الثّابتة. ولسنا نحن الّذين نمنحه قوّة الحركة والفاعليّة وفيه ثوابت لا ينال منها تطوّر الزمان شيئًا، ومتغيّرات تستوعب ظروف التطوّر، ورغم أنّه جعل التغيّرات تابعة للثوابت، فإنّ زمام الأمور يظلّ بيده. إنّ التفقّه في الدّين من أكبر النعم على الإنسان، وبه يكون هذا الإنسان ذا بصيرة ووعي.
* الإسلام والحياة، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.
1 سورة التوبة، الآية 122.
2 سورة التوبة، الآية 122.
3 السيد الرضي، نهج البلاغة (خطب الإمام علي عليه السلام)، ص 540.
4 م.ن، ص 150، خطبة 103.
5 م.ن، ص 157-158، خطبة 108.
6 سورة الأنفال، الآية 60.
7 سورة المائدة، الآية 8.
8 السيد الرضي، نهج البلاغة (خطب الإمام علي عليه السلام)، ص 558.