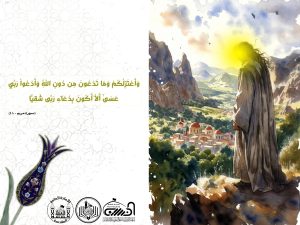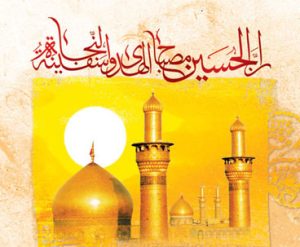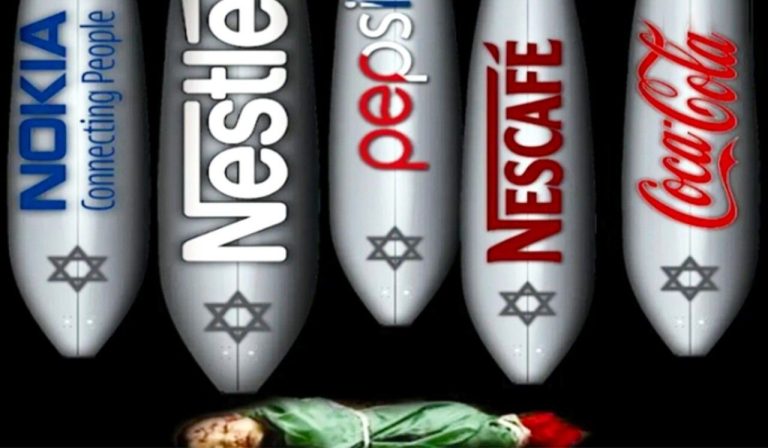* حاجة المجتمع إلى الوالي
قبل الدخول في صلب الموضوع لا بد من تقديم كلام في حاجة المجتمعات الإنسانية إلى الولاية والحكومة.
فالبعض يشكك في أصل حاجة المجتمع للوالي والحاكم، وهؤلاء إما أنهم من المتحررين الذين لا يعترفون بأي نوع من القيود والقوانين ولا يرضخون لأي حساب أو كتاب، وإما أنهم من الذين عانوا كثيراً من ظلم الحكومات.
هذه الفئات المختلفة التي تنكر حاجة المجتمع إلى الحكومة تشترك فيما بينها في الدافع وهو “الشهوة العملية”.
والقرآن الكريم يذكر أناساً دفعتهم شهواتهم العملية لإنكار النظام والحساب الأخروي: ﴿أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه * بلى قادرين على أن نسوي بنانه * بلا يريد الإنسان ليفجر إمامه﴾ (القيامة 3-5).
فلا مورد لشبهتهم من الناحية العلمية. أما السبب الذي دفعهم لحمل هذا الإشكال، فهو طبيعة الإنسان المادي الذي يريد دوماً أن يتخلص من اللجام ويرد إلى ميدان الفجور حراً طليقاً.
وبالطبع، فقد وجد من يطرح الشبهات العلمية في موضوع “حاجة المجتمع الإنساني للحكومة والإرادة”. ومن جملتهم الماركسيون الذين ينفون حاجة المجتمع إلى الحكومة بعد وصوله إلى مرحلة الشيوعية، بقولهم إن الحكومة هي وليدة الطبقات، وتنشأ لأجل الحفاظ على المنافع والمصالح الاقتصادية للطبقة الحاكمة. ولهذا فعندما تنعدم الطبقات، فإن الحكومة سوف تلحقها.
وقد نشأت هذه الشبهة من تصورهم بأن الاقتصاد هو أساس جميع الشؤون الإنسانية، غافلين عن أن العقيدة هي التي تبني أساس حياتهم، وبتبع العقيدة تنشأ الأخلاق التي تصوغ طريقة الحياة وأساليب العمل. من هنا، فإنه حتى لو أزيلت الطبقات المادية والاقتصادية، فسوف يبقى الاختلاف في العقيدة والأخلاق، وبالنتيجة يكون الاختلاف في السلوك والعمل. كما يحدث على أثر السهو أن يقع في المعصية، وأحياناً يكون ذلك نتيجة العمد. والاختلاف بين الأمرين في مقام تعيين الحكم والإثبات باللحاظ الوضعي يحتاج إلى القانون والمحكمة القضائية. فالحياة الاجتماعية بدون النظام الذي يحقق الانسجام بين السلوكيات المختلفة، وبدون الوالي الذي يحرس هذا النظام لن تخرج إلى حيز الوجود ولن تتحقق.
غاية الأمر أن هذا الوالي إما أن يكون فرداً أو جماعة، وطريقة الولاية إما بالمشورة أو بغيرها. إذن فالمجتمع بدون الوالي الذي يحفظ الانسجام وينظم القوانين الفردية والاجتماعية لن يكون له قوام ودوام.
وفي تاريخ الإسلام، كان الخوارج من الذين طرحوا شعار ﴿إن الحكم إلا لله﴾ (الأنعام 157)، نافين بذلك أي إشراف أو حاكمية على المجتمع.
فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام راداً عليهم: “كلمة حق يراد بها باطل” نهج البلاغة.
بمعنى أنه لو كان المقصود: إن الحاكمية بالأصالة لله فهذا مما لا شك فيه، ولكن إذا كان المقصود أنه لا يمكن لأحد أن يكون حاكماً فهذا كلام باطل لأن لازم ذلك شيوع الهرج والمرج. فأصل الحكم، وإن كان مختصاً بالله تعالى لكن الولاية هي للعباد الصالحين الذين يعينهم الله مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وقال عليه السلام: “وأنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر”.
* الحاصل الأولي في ولاية الأفراد
بعد إثبات حاجة المجتمعات البشرية للوالي والحاكم، يأتي هذا البحث في أنه ليس لأي إنسان حق الولاية والإشراف على الأفراد الآخرين.
فالإنسان يطيع من أفاض عليه نعمنة الوجود، وحيث أن الناس العاديين لم يمنحوه الوجود، ولم يكونوا مؤثرين في بقائه ودوام وجوده، لهذا فإن رأي الواحد منهم ليس ملزماً للآخر. وعدم لزوم اتباع الناس بعضهم لبعض هو الأصل الأولي في ولاية الأفراد بالنسبة للجميع.
* ولاية الله سبحانه
فيما مضى، ذكرنا بعض الآيات التي تشير إلى انحصار الولاية التكوينية والتشريعية بالله سبحانه. أما ما سنبينه الآن فهو:
حيث إن الإنسان يتلقى جميع شؤون وجوده من الله تعالى فهو مكلف بإطاعته وحده، وأما اتباع القوانين الصادرة عن غير الله فمشروط بتعيين ذلك وتحديده من قبل الله تعالى.
* ولاية وقيادة الأنبياء العظام عليهم السلام
الأنبياء هم أشخاص أثبتت رسالاتهم من الله تعالى من خلال الإعجاز والتحدي، وجاء الأمر الواضح باتباعهم وإطاعتهم.
وفي مورد إطاعة الأنبياء. (يأذن الله) التي هي إطاعة لله يقول القرآن الكريم: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله﴾ (النساء 64).
* استمرار الولاية الإلهية وقيادة الأوصياء عليهم السلام
بما أن القيادة أمر ضروري للمجتمعات الإنسانية، فإن الحاجة إليها بعد رحيل الأنبياء تبقى كما هي.
وإضافة إلى هذا البرهان العقلي الذي يحدد ضرورة استمرار القيادة الإلهية، يمكن إقامة برهان آخر بالاستعانة بما نزل في الوحي الإلهي. فإضافة إلى مجموعة الأحكام الفردية المطروحة في الدين، يوجد سلسلة من التعاليم الاجتماعية (الداخلية) كالحدود والديات والقصاص والتعزيرات وأمثالها، وسلسلة أخرى من التعاليم الاجتماعية الخارجية كالجهاد والدفاع وأمثالها.
إن وجود هذه الأحكام يشير إلى حاجة الدين للقوة التنفيذية والولاية الاجتماعية.
أضف إلى ذلك، البراهين النقلية الكثيرة جداً والتي تؤكد ضمن النهي عن تولي القيادة الغير إلهية على ضرورة القيادة الإلهية واستمراريتها.
* منطق القرآن الكريم في قطع الولاءات الباطلة
ينهي القرآن الكريم، في معرض قطع جذور الولاءات الباطلة وما يمكن أن يؤدي إليها، عن أي تول أو نصرة للذين خرجوا عن الدين.
وبالطبع، فإن هؤلاء الخارجين عن الدين طائفتان: الطائفة الأولى هم الذين يمكن العيش معهم بسلام، فيجوز إقامة العلاقات الحسنة معهم بشرط عدم سريان محبتهم إلى القلوب، أما الطائفة الثانية فهم الذين يؤذون المسلمين دينياً، فينبغي إظهار الانزجار والعداوة منهم.
فإذا لم يلتفت المسلمون لهذا الأمر القرآني، ومالوا إلى الكفار فإنهم سوف يصبحوا منهم، أما إذا راعوا حدود التبري جيداً فإنهم سوف يكونوا لائقين لمنصب “أولياء الله”.
ولأن النفي في مثل هذه الأمور مقدم على الإثبات، فقد بحث التبري أولاً لقطع العلائق مع الكفار، وبعدها طرح التولي. وإن كان التولي الموجود في فطرة الإنسان مقدماً على التبري الذي هو أمر عارض.
فتقدم التولي على التبري، كتقدم التوحيد على الشرك. ففي كلمة التوحيد “لا إله إلا الله” يتقدم النفي “لا إله” على الإثبات “بالاً الله”. لكن بما أن “إلاّ” ليست للاستثناء حتى تنحل جملة “لا إله إلا الله” إلى جملتين بل هي بمعنى “غير”، فمجموع كلمة التوحيد لن يكون أكثر من جملة واحدة.
وهكذا فإن غير “الله” الذي يمكن أن تقبله الفطرة الإنسانية ليس إلهاً آخر، أي أن أصل “الله” كعنوان مسلم أمر مفروغ منه، وغيره وهو المسلوب من حيث إنه أمر عار. إذن، فهذا النفي ليس لتثبيت ذلك الأمر الأصيل والذاتي، بل لأجل سلب أمر عارض.
إذن ينبغي الالتفات إلى أنه وإن كان من ناحية ترتيب الآيات القرآنية كما في سورة المائدة وكثير مثلها مما يرتبط بالتبري قد ذكر التبري من أعاء الله مقدماً على التولي، لكن في الواقع فإن التولي كالتوحيد أصيل ومتقدم، والتبري كالشرك عارض ومتأخر.
وكمثال سنذكر هذه الآيات التالية في التبري من الولاءات الباطلة، والتمسك بالولاية الإلهية، وفي تعريف بعض الأوصياء الذين عينوا لاستمرار الولاية الإلهية بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم أن الله لا يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين * ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد إيمانهمن أنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعنزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم * إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكعون * ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ (المائدة 51-56).
وفي القرآن الكريم، كلما أتى الحديث عن الدين المشترك، أو إعلان السلام والهدوء وأمثاله، فإن اليهود والنصارى يأتي ذكرهم بعنوان “أهل الكتاب”، لأن لهذا العنوان جاذبية خاصة بدليل الارتباط بين الإنسان والكتب السماوية.
أما إذا جاء الحديث عن إعلان الانزجار والتبري، فإنه يذكرهم باسم اليهود والنصارى، وفي الآيات المذكورة بما أن الكلام حول التبري فقد ذكروا بالعنوان نفسه: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾.
فجامع الأمم الواحدة المحبة، ومن يصل به الأمر إلى حبهم فإن أرضية الميل إليهم تصبح معدة أكثر، لأن الحب والبغض يصبحا مانعين من الحكم الصحيح، كما قيل: “حب الشيء يعمي ويصم”. وكذلك “بغض الشيء يعمي ويصم”.
وبسبب الدور الذي للمحبة في علاقات الأمم والشعوب تقول الآية الكريمة: ﴿بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾.
وفي القسم الأخير من الآيات المذكورة في البداية، يقول الله تعالى بعد الأمر بالبراءة من اليهود والنصارى: ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾، وهذا البيان يشير إلى أنهم ظالمون، والظالم لن يتمتع بأي لون من ألوان الهداية ولن يصل أبداً إلى المقصد بل يبقى دائماً في وسط الطري.. فإذا أصبحتم في زمرتهم لن تصلوا إلى المقصد. وكلمة “لا يهدي” في هذه الآية هي بمعنى الهداية التكوينية والإيصال إلى المطلوب، ولا يعني ذلك أن باب الهداية التشريعية مسدود أمام الظالم، لأن الظالم إذا تاب فإن توبته سوف تقبل.
وتعليق حكم عدم الهداية التكوينية وعدم وصول اليهود والنصارى على وصف الظلم مشعر بعلية هذا الوصف، بمعنى أن الظالم من حيث هو ظالم سوف يبقى محروماً من الهداية التكوينية الإلهية ويبقى في منتصف الطريق، وأما هداية الله التشريعية فهي عامة، وقد أرسل الله تعالى الأنبياء لأجل هداية جميع الناس، وكذلك القرآن الذي يأتي ذكره ﴿هدى للناس﴾.
وكما أشير من قبل، فإن النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء كي لا تنشأ محبتهم، وإلا فالحياة المسالمة والعيش الأمن وإقامة العلاقات التجارية وغير التجارية بل وإقامة العلاقات الإنسانية مع غير أهل الكتاب جائز بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى نصرتهم ومحبتهم.
وفي سورة الممتحنة وفي مورد العيش السلمي مع الكفار يقول تعالى:
﴿لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهيكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون﴾ (الممتحنة 8-9).
فالكافر الذي يلجأ إلى دولة الإسلام، أو يقيم معاهدة مع الدولة الإسلامية، يصبح التعدي على حقوقه وأمواله حرام. وأما الكافر الذي لم يقم معاهدة مع دولة الإسلام ولم يلجأ إليها، وإنما هو مشغول بمحاربة المسلمين وإخراجهم وإبعادهم، أو أنه يساعد من يحاربهم، ففي هذه الصورة فإن حكمه حكم الحربيين، وأمواله من فيء المسلمين، وليس لأي مسلم الحق في توليهم، وإذا فعل ذلك كان من زمرة الظالمين.
ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر بشأن حرمة التعدي على حقوق الكفار الذين هم تحت ظل دولة الإسلام أو معاهدة المسلمين: “ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق”.
وفي رواية مرسلة، نقل أيضاً أن “الإنسان أخو الإنسان أحبّ أو كره” فهذا الحديث وإن لم يكن له سند، فإنه حديث صادق، لأن الناس أخوة ما لم يقوموا بإيذاء وقتل وتفريق بعضهم البعض.
وفي الآيات (مورد البحث) من سورة المائدة يقول تعالى بعد النهي عن محبة اليهود والنصارى: ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم﴾.
استفيد من تعبير “يسارعون فيهم” مكان “يسارعون إليهم” للإشارة إلى أن الاندفاع والحضور في جمع الكفار عند هؤلاء المنتحلين للإسلام لم يكن قد نشأ بعد.
وتوضيحه: أن التبري من اليهود والنصارى وإن كان هو الأصلي الكلي الدائم والثابت لكن الآيات المذكورة نزلت في المدينة لأن مكة لم يكن فيها سوى المشركين والوثنيين وأما اليهود والنصارى فلم يكن لهم أي حضور حتى ينهى عن محبتهم ومعاشرتهم. أما في المدينة، فإن فرقة من أهل الكتاب كانت حاضرة، وفي هذا الجو كان من بين المسلمين المبتلى بضعف الإيمان أو المصاب بالنفاق من يحاول أن يسيتغل التقرب إليهم على أمل أنه إذا تقدم مشركو مكة نحو المدينة وانتصروا على المسلمين فسوف يكون لهم ملجأ آمن. ولأجل إزاحة الستار عن هذه الروابط السرية ذكر القرآن هذه الحالة بعنوان أنها مرض سياسي في القلوب. كما فعل في سورة الأحزاب عند الحديث عن أحد الأمراض الأخلاقية. حيث يقول آمراً نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض﴾ (الأحزاب 32).
فمثل هذه الأمراض القلبية ينبغي أن تعالج. فإذا لم يعم ذلك فإن الشيطان وبناء على الأصل الكلي ﴿في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً﴾ (البقرة 10) يهيىء أرضية تفاقم المرض.
وفي السورة المباركة “الفتح” يكشف النقاب عن بعض الأمراض السياسية الأخرى: ﴿بل ظننتم إن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً﴾ (الفتح 12).
وفي الآيات التي دار البحث حولها من سورة المائدة أيضاً يتم فضح هذا الظن الباطل وكشفه. إن منطقهم في الارتباط والتوجه السياسي نحو الكفار بقولهم: ﴿نخشى أن تصيبنا دائرة﴾ يجاب عليه: ﴿فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده﴾ وعندها يصبح أولئك الذين في قلوبهم مرض نادمين.
وعند متابعة الآيات، يقول تعالى بعد آية لا ترتبط مباشرة بمسألة اتخاذ الولاية: ﴿يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه﴾.
إشارة إلى أن ما يساعد على التقدم في الحرب ويثبت الإسلام هو المحبة ذاتها. وبما أن هذه الطائفة محبة لله محبوبة من قبله فإنها سوف تكون من أنصاره. مثلما أنكم إذا كنتم تحبون اليهود والنصارى فسوف تضلوا مثلهم.
إذن فمحاربة الكفار تتطلب محبة الله، لا ما يعرف باسم المعلومات (الاختصاص)، بل أن العلوم العادية عندما يكون لها أثر ويكون لسوق الدرس والبحث رواج، فإن كل ذلك ببركة بطولة المجاهدين المشتعلين في متاريس العشق والمحبة والصبر والاستقامة. وإلا فإن الخطر لو ازداد أكثر لتعطلت الدروس جميعاً. ففي يوم الخطر لا شيء ينفف سوى المحبة.
وفي بقية الآية عند وصف المقاتلين الذين هم أهل المحبة الإلهية يقول تعالى: ﴿أذلة على المؤمنين﴾ أي أن الواحد منهم ذلول لا ذليل لأن الذلة عذاب، وليس لأي أحد الحق في أن يذل نسه أمام مؤمن آخر. فالممدوح هو التواضع لا المذلة. كما ورد في الحديث الشريف في أحد جوامعنا الروائية: “إن الله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه” (فروع الكافي ج5 ص64).
وتعدي أذلة على حرف “على” بدلاً من “لدى” أو “عند” يشير إلى حفظ الاستعلاء والعظمة عند المجاهدين الذين بتواضعهم يفرشون سفرتهم من الكرامة والجود لأهل الإيمان.
الأثر الأخير للمحبة الذي ورد في الآية، غير حفظ النظام والعطف بين المؤمنين هو الانزجار من الكفار والعزة عليهم ﴿أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم﴾.
وبعد بيان التبري في بقية الآية يأتي إظهار التولي: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾.
فالإنسان بعد أن يطرد عن نفسه كل أنواع الأمراض والضعف الروحي وكل أنواع المحبة والنصرة غير الإلهية، فحينها سوف يدخل تحت الولاية الإلهية، وعندها سوف يكون وليه الله ورسوله والذي يتصدق حين الركوع.
النقطة الأولى في الآية هي أنه في بدايتها ورغم الحديث عن ولاية الله ورسوله وبعض المؤمنين، فإن كلمة الولي وردت بصيغة المفرد، وهذا يشير إلى أن هناك ولاية واحدة هي بالأصالة لله تعالى وبالتبعية لرسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام.
وفي القرآن الكريم كثيرة الموارد التي هي من هذا القبيل حيث يأتي الحديث عن الله سبحانه والنبي الأكرم، ثم يكون رجوع الفعل أو الضمير إلى المفرد: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ (الأنفال 24) أو ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون﴾ (النور 48).
ففي هذه الموارد يكون العمل أو الحكم من قبل الله تعالى، أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو المظهر للعمل أو المبلغ لذلك الحكم.
والنقطة الأخرى في آخر الآية هو ارتباطها وبدون شك بإحدى الحوادث التاريخية. ففي الفقه، ليس من المستحبات أو الواجبات في الصلاة أن يتصدق الإنسان في حال الركوع.
لهذا، فبسبب أن الآية الكريمة لا تشير إلى حكم من الأحكام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الآية، من منكم قد فعل هذا؟ وإذا برجل يحمل بيده خاتماً ويشير إلى أمير المؤمنين مجيباً: ذاك الذي يصلي هو الذي أعطانيه.
وبالنتيجة فإن الآية تعرف بالشخص الذي سوف تكون ولايته واجبة على المؤمنين بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد تثبيت مسألة الولاية مقابل الظالمين والضالين عن المقصد والبعيدين عن الولاية الإلهية، تذكر الآية التالية تغلب وانتصار أناس وصلوا إلى المقصد ببركة الولاية الإلهية والهداية الربانية ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾.