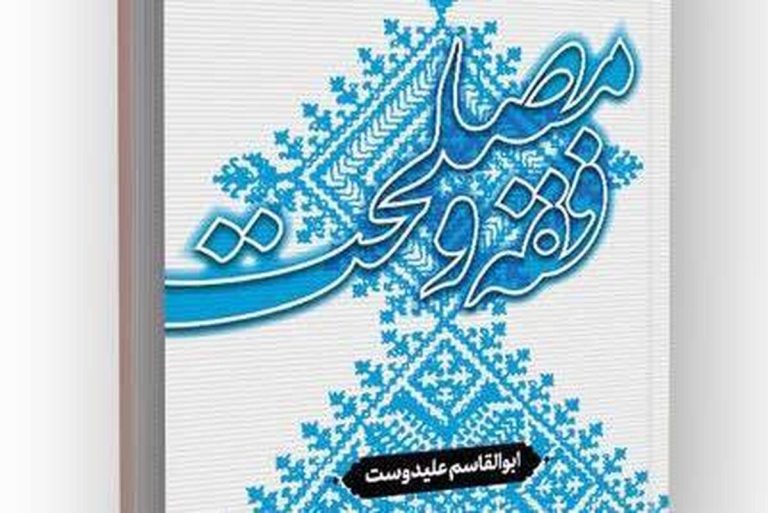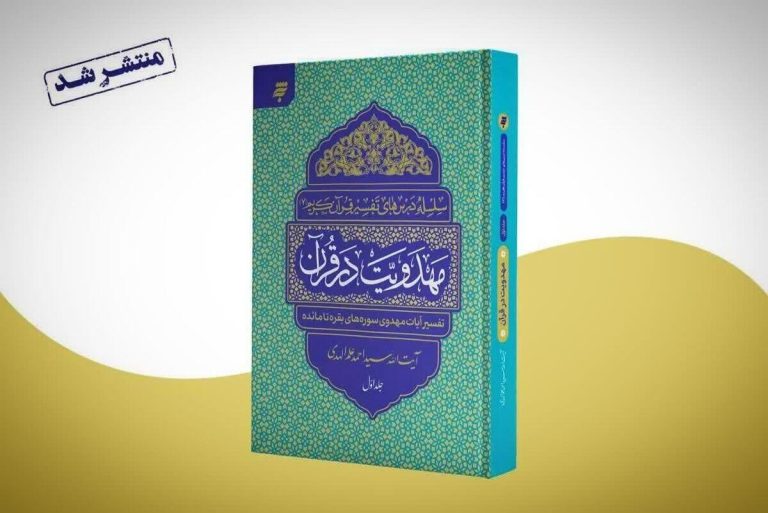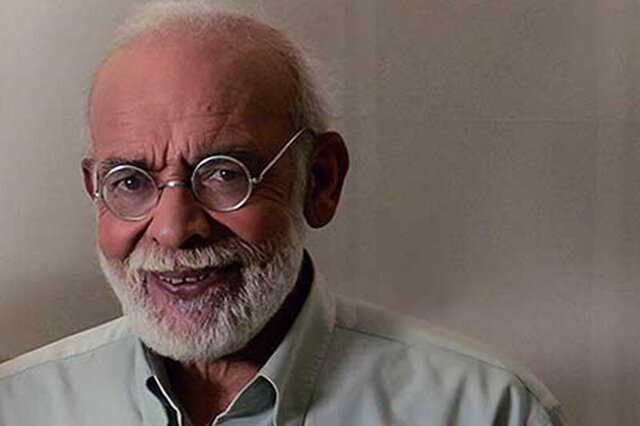يُظهر تحليل التحديات الأساسية المرتبطة بقضية المهدوية أنّ تحقّق العدالة العالمية ليس أمرًا مستحيلًا، بل هو ممكن حتى في أحلك الظروف، كما شهد التاريخ الإسلامي في مراحله الأولى. كما تؤكّد الشواهد العلمية ونظريات عدد من العلماء، من بينهم البروفيسور ربِك، إمكان العمر الطويل من الناحية العلمية. وتشير دراسات متعدّدة عابرة للتخصّصات إلى أنّ الانتظار الواعي والفاعل، لا الانتظار السلبي، يمكن أن يسهم في الحدّ من كثير من الآفات والمشكلات الاجتماعية.
تمهيد
هل يمكن، في عالمٍ يعجّ بالظلم وانعدام العدالة، أن يُعقَد الأمل على قيام عدالة شاملة؟
كيف يمكن لإنسان أن يعيش أكثر من ألف عام؟
ولماذا لا يتحقّق الظهور في عصر الغيبة، رغم حاجة المجتمع الماسّة إلى الهداية؟
هذه الأسئلة، وغيرها، تمثّل جملة من الإشكالات الفكرية التي طالما شغلت أذهان شريحة واسعة من الناس في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا السياق، أجرَت وكالة أنباء «حوزة» حوارًا مع حجّة الإسلام والمسلمين محمدرضا فؤاديان، المتخصّص في قضايا المهدوية، تناول فيه أبرز الهواجس الفكرية المطروحة في هذا المجال، وقدّم إجابات دقيقة ومستندة إلى مصادر دينية ومعطيات علمية، نضعها بين أيديكم أيها القرّاء الكرام.
السؤال الأول: كيف يمكن لإنسان أن يعيش أكثر من ألف عام؟ وهل ينسجم هذا العمر الطويل مع المعارف الطبية الحديثة؟
من أكثر الشبهات شيوعًا وإثارة للنقاش في موضوع المهدوية مسألة طول عمر الإمام المهدي (عج).
فالتساؤل عن كيفية إمكان أن يعيش إنسان أكثر من ألف سنة، وما إذا كان ذلك قابلًا للإثبات أو التفسير من منظور الطب والعلوم الحديثة، لا يزال حاضرًا بقوّة في الأذهان.
وفي الإجابة عن هذه الشبهة، تناول العلماء المسألة من زاويتين أساسيتين
الزاوية الدينية، والزاوية العلمية، حيث قدّم كلّ منهما معطيات تبيّن أنّ طول العمر، وإن بدا استثنائيًا، لا يخرج عن دائرة الإمكان العقلي والعلمي.
عمر الأنبياء والأولياء آلاف السنين: نوح وعيسى والخضر عليهم السلام
من المنظور الديني، يعرض لنا القرآن الكريم نماذج متعدّدة لأعمارٍ مديدة.
فعلى سبيل المثال، عاش النبي نوح (عليه السلام) ما يقارب ألفين وخمسمئة سنة، قضى منها تسعمئة وخمسين عامًا في مقام النبوّة. وكذلك النبي عيسى (عليه السلام)، الذي يصرّح القرآن الكريم بشأنه بقوله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ﴾؛ فلم يُقتَل ولم يُصلَب، بل رُفع إلى السماوات، وهو حيّ إلى يومنا هذا.
ومثال آخر هو النبي الخضر (عليه السلام)، الذي اتّفق المسلمون جميعًا على أنّه ما يزال حيًّا. وتُظهر هذه الشواهد بوضوح أنّ الله تبارك وتعالى، متى شاء وأراد، قادر على أن يمنح عبدًا من عباده عمرًا طويلًا جدًّا.
ومن الزاوية العلمية، فإنّ الإنسان المعاصر، في ظلّ التقدّم اللافت في العلوم الطبية، يسعى باستمرار إلى إطالة عمره.
وينبع هذا السعي من حقيقة أنّ الإنسان، على الرغم من جميع قدراته وإمكاناته، يبقى محكومًا بعمرٍ محدود لا يتجاوز في الغالب سبعين أو ثمانين عامًا. ومن هنا، انكبّ علماء علم الجينات على البحث والدراسة من أجل اكتشاف ما يُعرف بـ جين طول العمر.
إثبات إمكان العمر الذي يتجاوز ألف عام في النظريات العلمية
النقطة الجديرة بالانتباه هي أنّه لا يوجد بين العلماء من ينكر أصل إمكان طول العمر أو يعدّه أمرًا مستحيلًا من الناحية العقلية أو العلمية.
ومن أحدث النظريات المطروحة في هذا المجال ما نُسب إلى «البروفيسور رِبِك»، العالم الألماني، إذ يرى أنّ استهلاك المياه متعدّدة الجزيئات يمكن أن يَحول دون تدهور الخلايا ويُسهم في إطالة العمر. وهذه المياه، التي توجد غالبًا في المناطق المرتفعة، تتميّز بتركيب جزيئي يختلف عن الماء الاعتيادي، وهو تركيب يُشبِه ـ من حيث البنية ـ الماء الثقيل المستخدم في الصناعة النووية.
وقد أُلّف إلى يومنا هذا أكثر من سبعين كتابًا ردًّا على الشبهات المتعلّقة بطول العمر، وقد أثبتت هذه المؤلّفات، من الجانبين الديني والعلمي معًا، إمكان تحقّق العمر المديد.
إنّ جميع المعجزات الإلهية الواردة في القرآن الكريم تشهد على هذه الحقيقة الراسخة، وهي أنّ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾؛ فالله سبحانه وتعالى قادر على كلّ شيء. وبناءً على ذلك، فإنّ طول عمر الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف)، من منظور الإعجاز الإلهي، أمرٌ ممكن تمامًا ومُثبَت.
فالله المتعال، وهو القادر المطلق، قد تفضّل ومنح هذه الموهبة الخاصة لـ إمام الزمان (عج).
سؤالٌ يُطرح كثيرًا: لماذا لا يظهر الإمام المهدي (عج) في زمن الغيبة مع أنّ المجتمع في حاجة ماسّة إلى هدايته؟ وما ثمرة هذه الغيبة؟
تُجيب الروايات عن هذا الموضوع من خلال ثماني مجموعات من النصوص تُبيّن العلّة والفلسفة والحكمة وراء غيبة الإمام (عج). وقد جمع الشيخ الطوسي هذه الروايات كلّها، وصرّح بأنّ أهمّ سبب للغيبة هو حفظ حياة الإمام.
ويبرز بعد ذلك سؤال آخر: ما فائدة إمامٍ لا تراه العيون؟
العلماء، في مبحث «فوائد الإمام الغائب»، ذكروا ثلاث عشرة فائدة.
ويُقال هنا إنّ عدم الرؤية لا يعني عدم الفائدة. فمثلاً، لا أحد يستطيع أن يرى قوّة الجاذبية بعينه، لكنّ الناس جميعًا يوقنون بوجودها، ويدركون أنّها ضرورية لحياة الإنسان على الأرض.
وكذلك، نحن لا نرى الله تعالى وهو غيبُ الغيوب، فهل يمكن الادعاء بأنّ الإيمان بالله لا أثر له في حياة البشر؟
ثم يُطرح سؤال آخر: لماذا لا يظهر الإمام، مع أنّ الحاجة إليه شديدة في عصر الغيبة؟
الجواب أنّ الله تعالى قد أنعم على الناس قبل الإمام المهدي (عج) بأئمّة عظام، كالإمام الحسن العسكري (ع)، والإمام الهادي (ع)، والإمام الرضا (ع)، والإمام الجواد (ع)، وأمير المؤمنين (ع). غير أنّ الناس لم يعرفوا قدرهم، وانتهى أمر هؤلاء الأئمّة العظام إلى القتل أو السجن أو النفي.
والإمام الحسين (ع) أيضًا كان قادرًا على قيادة العالم، ونهض لمواجهة الظلم في زمانه، لكنّ الناس لم يقفوا معه، فاستُشهد مظلومًا.
والإمام المهدي (عج) هو آخر حجج الله على عباده، وقد ادّخره الله للبشرية. ولما لم تكن الأمم أهلًا لوجوده بينهم، جعل الله عزّ وجلّ ظهوره مؤجّلًا خلف ستر الغيبة، حتى يبلغ البشر مرحلة النضج الفكري، وحتى يشعروا اضطرارًا حقيقيًا إلى حجّة الله.
ينبغي للإنسان أن يدرك عجز المذاهب البشرية عن تحقيق الظهور.
إنّ ظهور الإمام المهدي (عج) لن يتحقّق إلا حين يريده الناس حقًّا؛ فـ الإقبال العام أحد الشروط الأساسية للظهور.
وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾، أي إنّ الله لا يغيّر مصير قومٍ حتى يُغيّروا ما في داخلهم.
نحن اليوم نشهد ظلمًا عالميًا واسعًا، ويُطرح السؤال: لماذا لا يظهر الإمام المهدي (عج)؟ وهل يرضى الله وحجّته بهذا الظلم؟
الجواب: كلا، حاشا لله وحجّته أن يرضيا بالظلم.
المشكلة الحقيقية أنّ البشر هم الذين ارتضوا هذا الظلم وخضعوا له.
يقول الإمام محمد الباقر (ع):
«دولتنا آخرُ الدُّول، ولن يبقى أهلُ دولةٍ إلا قد ولّوا حتى لا يقول قائلٌ: لو ولّينا لعدَلنا، ثم يقوم صاحبُ الحقّ بالحقّ والعدل.»
فما لم يبلغ البشر طريق انسداد المذاهب الفكرية والسياسية، وما دام الناس يتوهّمون أنّ مدارس كـ الليبرالية أو الشيوعية قادرة على حلّ مشكلاتهم، فلن يتحقّق ظهور الإمام المهدي (عج).
وحينما يصبح الناس طالبين للتغيير بصدقٍ وحاجة حقيقية، عندها يمنحهم الله وليّه.
شبهة إدارة العالم في ظلّ التعقيد التكنولوجي
قد يُسأل: كيف يمكن لقائدٍ واحد أن يؤسّس حكومةً موحّدة على مستوى العالم، مع ما يشهده العصر الحديث من تعقيدات تكنولوجية تجعل الإدارة العالمية أكثر صعوبة؟
من أبرز الشبهات المطروحة حول حكومة الإمام المهدي (عج): كيف يستطيع شخصٌ واحد إدارة العالم بأسره؟
واللافت أنّه في النقاشات المعاصرة حول العولمة والعالمية، أصبح مفهوم الإدارة الواحدة والقيادة الموحّدة مبدأً مقبولًا لدى مختلف المدارس الفكرية.
نحن هنا نتحدّث عن قيادة سماوية.
وكما تمكّن النبي الأكرم (ص) من إدارة الإسلام في رقعةٍ واسعة، فإنّ الإنسان الكفوء القادر يستطيع إدارة العالم. فالأمر يرتبط تمامًا بمستوى كفاءة القائد:
فهناك من لا يتجاوز قدرته تربية عددٍ محدود من الأشخاص، وهناك من يستطيع إدارة شركةٍ كبرى، ومن يمتلك خصائص استثنائية يمكنه إدارة العالم.
إنّ الخصائص الفريدة للإمام المهدي (عج)، وفي طليعتها العلم والعصمة، تجعله أهلًا لإدارة العالم. فنحن نتحدّث عن قيادة سماوية بكلّ ما للكلمة من معنى.
واليوم تسعى المنظّمات الدولية إلى إدارة العالم من خلال سنّ القوانين العالمية، وطرح فكرة العملة الموحّدة، والسعي إلى إزالة الحدود بين الدول.
فإذا خضع البشر لقيادة سماوية تمتلك القدرة الحقيقية على هداية الإنسان وإدارة شؤونه، فإنّ الإمام المهدي (عج) قادرٌ على إدارة العالم بكلّ يُسر. غير أنّه لا بدّ من الالتفات إلى أنّ قيادته، إلى جانب المشروعية الإلهية، تحتاج أيضًا إلى القبول الشعبي.
ولهذا يُثار في عصرنا هذا السؤال: كيف ستتشكّل الحكومة العالمية في ظلّ التكنولوجيا الحديثة؟
والجواب أنّ هذا العصر، بما يحمله من أدوات واتّصال وتنظيم، لا يُعيق قيامها، بل يُمهّد لها متى ما توفّر الإنسان المستعدّ لقبول القيادة الإلهية.
في زمن ظهور الإمام المهدي (عج)، سيبلغ العلم درجةً من الازدهار تفوق ما هو عليه اليوم بخمسٍ وعشرين مرّة.
والنقطة المهمّة أنّ التكنولوجيا المعاصرة، على الرغم من تقدّمها، خلّفت آثارًا وتبعاتٍ سلبية كثيرة؛ من ذلك ثَقب طبقة الأوزون نتيجة الغازات الدفيئة التي تنتجها الدول المتقدّمة، وتخريب البيئة، فضلًا عن التأثيرات السلبية العميقة في أسلوب حياة الإنسان.
ورد في رواية عن الإمام الصادق (ع) أنّه قال: منذ زمن آدم (ع) إلى عصر ظهور الإمام المهدي (عج) لم ينكشف من العلم إلا حرفان، أمّا عند ظهور الإمام المهدي (عج) فإنّ العلم سيزدهر خمسةً وعشرين ضعفًا.
وفي ذلك العصر، سيغدو العلم الذي تحتكره اليوم قلّة من القوى العظمى علمًا عالميًا متاحًا للبشرية جمعاء. وهذا العلم الشامل، الخالي من الآثار التدميرية السائدة اليوم، يكشف أنّ العالم العلمي الحديث، كلّما ازداد تقدّمًا، ازدادت حاجته إلى حجّة الله ووليه.
ويقول الله تعالى في الآية العشرين من سورة لقمان: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾
فأيّ إنسانٍ اليوم يستطيع أن يدّعي أنّ ما في السماوات والأرض كلّه في متناول يده؟
ويقول القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾
إنّ هذه الآيات إنّما تجد معناها وتجسيدها الكاملين في عصر الظهور. وكلّما اتّسعت دائرة العلم، تجلّت حاجة الإنسان إلى القيادة الإلهية بصورةٍ أوضح وأعمق.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفّقنا للتعرّف أكثر على معارف المهدوية، وأن يرزقنا الفهم والبصيرة في هذا الطريق.
ما فائدة طول انتظار الظهور في تحريك المجتمع وتقدّمه؟
للإجابة على هذا السؤال الجوهري، ينبغي النظر إلى الأبعاد المختلفة لمفهوم الانتظار وآثاره وبركاته العديدة، إذ لا يقتصر على بعدٍ اعتقادي بل يمتدّ إلى جميع أوجه الحياة الإنسانية.
يروي الإمام السجّاد (ع) في حديثٍ عميق المعنى أنّ الله يمنح المنتظرين الحقيقيين عقلًا راجحًا وفهمًا ساميًا، حتى تكون فترة الغيبة بالنسبة لهم كأنّها زمن حضور الإمام نفسه.
فهؤلاء يعيشون حضور الإمام في أعماق وجدانهم وإن لم يروه بأبصارهم.
وتُظهر هذه الرواية النورانية أنّ المنتظرين الواقعيين يتمتّعون ببصيرةٍ نافذة وإدراكٍ عميق، يجعلهم يشعرون بوجود الإمام في حياتهم العملية، ولهذا قال الإمام السجاد (ع):
«إنّ أهلَ زمانِ غيبتِه، القائلين بإمامته، والمنتظرين لظهوره، أفضلُ أهلِ كلِّ زمان؛ لأنّ الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله (ص) بالسيف، أولئك المخلصون حقًّا، وشيعتُنا صدقًا، والدعاةُ إلى دين الله سرًّا وجهرًا.»
الانتظار في حقيقته مفهومٌ متعدد الأبعاد يؤثّر في مختلف ميادين الحياة الفردية والاجتماعية والروحية.
في البعد العسكري، يقتضي الانتظار الحقيقي من المؤمن أن يحافظ على جهوزيته الدائمة، لا بمعنى الانزواء في البيت متسلّحًا سلاحًا خاملاً، بل بمعنى السعي المستمرّ لتقوية القدرات الدفاعية، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾
فالآية تؤكّد أنّ قوّة المنتظرين يجب أن تكون في حالة نموّ وفاعلية دائمة.
وفي البعد الاجتماعي، يمنح الانتظار الإنسان هويةً ورؤيةً ورسالةً، إذ يجعله يعيش لقضيةٍ سامية تتجاوز ذاته. ولذلك أصبح مفهوم الانتظار اليوم موضوعًا للدراسة في الحقول الأكاديمية المتنوّعة، خصوصًا في العلوم الإنسانية وعلم النفس والاجتماع.
وتشير دراساتٌ بين تخصّصية كثيرة إلى أنّ الإيمان بالانتظار الإلهي يُحدث توازنًا نفسيًا، ويساهم في تقليل الاضطرابات السلوكية والاجتماعية، نظرًا لما يشيعه من الأمل والثقة بالمستقبل.
وجاءت رواياتٌ عديدة تذكر فضيلة المنتظرين الصادقين، فالمؤمن الذي ينتظر الإمام المهدي (عج) يُعدّ كأنّه حاضرٌ في خيمته المباركة، وفي روايةٍ أخرى: «من مات منكم وهو منتظرٌ لهذا الأمر، كان كمن كان في فسطاط القائم، بل كمن قارع معه بسيفه، بل كمن استُشهد مع رسول الله (ص).»
وهذا الثواب العظيم يشير إلى أنّ الانتظار ليس طريقًا سهلًا، بل هو مسلكٌ جهاديّ وتربويّ طويل.
الانتظار في معناه الحقيقي يولّد الحركة والنشاط في المجتمع، وليس الركود كما يتوهّم البعض.
في الروايات، وُصف الانتظار بأنّه «أفضل الأعمال»، وهذه العبارة تفيد أنه فعلٌ وسلوكٌ عمليّ، لا مجرّد فكرة أو حالة نفسية.
فلو كان مجرّد شعورٍ داخليّ، لقيل: “أفضل الحالات” أو “أفضل الأفكار”، لكن الحديث قال: «أفضل الأعمال انتظار الفرج»، أي أنّ الانتظار ينبغي أن يظهر في السلوك والعمل اليومي للمنتظر.
الانتظار عملٌ تحريكيّ، يقوم على الحركة المستمرة والسعي الفعّال، وفقًا لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾
فما يناله الإنسان مرهونٌ بسعيه وجهده.
من هذا المنطلق، فالانتظار الحقّ ليس جلوسًا خاملاً أو انفعالًا سلبيًا، بل سعيٌ دائم لإصلاح الذات والمجتمع.
وعندما يُطرح التساؤل: هل الانتظار يؤدي إلى تراجع المجتمع؟
يجب أن نقول: بالعكس تمامًا، فقد أثبتت التجارب الفكرية أنّ الانتظار الحيوي أو البنّاء يدفع المجتمع إلى النموّ والتحرّك والتقدّم.
فمن يؤمن بقدوم المصلح العالمي، يعلم أنّ عليه أن يهيّئ الأرضية لظهوره، فـ «المنتظر للمصلح ينبغي أن يكون صالحًا»، كما يقول القرآن الكريم: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾.
وهذا الفهم العميق للانتظار، يحوّله إلى قوّةٍ اجتماعية خلاّقة، تُوجّه المجتمع نحو الصلاح والنهوض والاستعداد العملي لاستقبال الظهور المقدّس، تمهيدًا لإقامة دولة العدل الإلهي الشامل التي وُعدت بها الإنسانية جمعاء.
كيف يمكن تمييز الطريق الصحيح من الخاطئ أمام موجة الادّعاءات المتعدّدة بالاتصال بالإمام المهدي (عج)؟
للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي الإشارة أولًا إلى أنّ هذه الظاهرة ليست حكرًا على أتباع المذهب الشيعي، بل شملت أتباع الأديان والمذاهب الأخرى أيضًا، حيث وُجد مدّعون كاذبون في مختلف الاتجاهات العقائدية عبر التاريخ وحتى يومنا هذا.
المدّعون الكاذبون في قضايا المهدوية في الأديان المختلفة
ففي أوساط أهل السنّة ظهرت شخصيات ادّعت المهدوية بغير حقّ. وقد شهدنا مؤخرًا في بعض مناطق العالم الإسلامي من ادّعى زورًا أنّه «المهدي السوداني»، ما يدلّ على أن ظاهرة المدّعين الكاذبين موجودة بين المسلمين عمومًا، وليست مقتصرة على مذهبٍ بعينه.
وفي المسيحية أيضًا نجد نماذج مشابهة؛ إذ ادّعى عدد من الأشخاص عبر التاريخ أنّهم المسيح الموعود أو المخلّص المسيحي. وما يزال الأمر قائمًا إلى اليوم؛ ففي روسيا، على سبيل المثال، يوجد شخص يزعم أنه المسيح المنتظر.
كما شهدت الديانة اليهودية هذه الظاهرة، ومن أبرز نماذجها المدعو شابتاي زَوي، الذي أعلن يومًا أنّه «المسيح اليهودي» وأنه قادر على قيادة بني إسرائيل إلى الأرض الموعودة.
وقد خدع أتباعه حين أقنعهم ببيع بيوتهم وأراضيهم والانضمام إليه بأموالهم وجوازاتهم، ثم قلد معجزة موسى (ع) بالعكس، فأدخلهم في النهر، فغرقوا بعد أن أخذ ما لديهم من متاعٍ ومال.
تظهر أمثال هذه الحالات بسبب الطابع الجاذب لمفهوم المنجي والمخلّص لدى الإنسان، وما يحمله من رجاءٍ وخلاصٍ نفسي واجتماعي.
ففي كلّ الأديان والمذاهب يوجد من يستغلّ هذا الشعور الفطري، فيدّعي كذبًا أنّه على صلة بالمنجي، أو أنّه هو المنجي نفسه، في محاولة لجذب الناس تحت عنوان الخلاص الروحي أو الإصلاح العالمي.
معايير التمييز بين المدّعين الصادقين والكاذبين في قضية المهدوية
السؤال الأساسي هو: كيف نميّز الحقّ من الباطل في هذه الادّعاءات؟
تشير التجارب والروايات إلى أنّ المدّعين الكاذبين غالبًا ما يشتركون في صفاتٍ محددة، منها:
- غياب الأساس العلمي والمنطقي القوي؛ فهم يستندون في دعواهم إلى رؤى وأحلام شخصية لا يمكن الاعتماد عليها كمعيارٍ شرعيٍّ أو عقليٍّ للتمييز بين الحقّ والباطل.
- إهانة العلماء ورفض الرجوع إليهم؛ فكثيرًا ما يصفون الناس بالجهل، وينهونهم عن مراجعة العلماء الربانيين، محاولين إبعادهم عن المرجعيات الدينية الموثوقة.
- التساهل في الدين والإباحية في الفكر والسلوك؛ إذ يميل هؤلاء إلى تعطيل الأحكام الشرعية مثل الخمس والصلاة، ويجرّون الناس من الالتزام إلى التفلت، ومن روح التدين إلى حالة اللادينية والانحلال.
وتشير الروايات الإسلامية إلى أنّ الواجب الشرعي أمام هذه الادّعاءات هو الرجوع إلى العلماء الحقيقيين.
فالعالم الديني هو من يجتهد بالاعتماد على الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ويستند إلى ضوابط علمية دقيقة في استنباط الأحكام.
وإذا رأينا شخصًا يعارض أصول الدين، ويستغني عن العلماء، ويستند في قوله إلى الرؤى والأحلام، وكانت كلماته ضعيفة لا سند لها من النصّ والعقل، فعلينا أن نحذر؛ فاحتمال الوقوع في شِبَاك هؤلاء المدّعين كبير.
إنّ معرفة هذه المعايير تحفظ المؤمن من الانخداع بالادّعاءات الزائفة، وتعينه على التمسّك بـ الطريق الصحيح للانتظار، الذي هو في جوهره التزام بالأحكام الإلهية وأخذٌ عن العلماء الصادقين.
وتتّضح أهمية هذه المسألة أكثر في عصر الغيبة، حيث يصبح التمييز بين الحقّ والباطل وحفظ العقيدة الصحيحة من أعظم مهامّ المنتظرين الحقيقيين للإمام المهدي (عج)، لأنّ صيانة الإيمان في زمن كثرة الادّعاءات خيرُ استعدادٍ لعصر الظهور المبارك.
لماذا لم تتحقق بعض علامات الظهور رغم ورودها في الروايات؟
للإجابة عن هذا السؤال، ينبغي أولًا النظر إلى تصنيف علامات الظهور كما ورد في الروايات المعتبرة، فليس جميعها على درجة واحدة من التأكيد والقطع.
العلامات الحتمية للظهور
من بين علامات الظهور، خمس علامات عُدّت حتمية وقطعية الوقوع في المصادر المعتبرة، وهي:
- قيام السفياني
- الخَسف بالبيداء
- قيام اليماني
- الصيحة السماوية
- قتل النفس الزكية
وقد أكّدت روايات متعدّدة وصحيحة على أنّ هذه العلامات الخمس واقعةٌ لا محالة قبل الظهور الشريف، أمّا سائر العلامات المذكورة في الكتب فهي غير قطعية، أي أنّ وقوعها ممكن لكن ليس مضمونًا، وربما تتغيّر من خلال مبدأ البداء الإلهي في التقدير.
لماذا لم تتحقق بعض العلامات إلى الآن؟
إنّ من أكثر الأسئلة تداولًا بين الباحثين والناس هو سبب عدم تحقّق كثير من العلامات التي تكررت في المصادر المختلفة.
وللجواب عن ذلك، ينبغي أولًا أن نميّز بين الروايات المعتبرة علميًا وبين ما أُدرج لاحقًا في بعض الكتب التي لا تستند إلى توثيقٍ دقيق. فموضوع علامات الظهور بسبب جاذبيته وشعبيته كان ميدانًا واسعًا للتأليف، حتى ألّف فيه كثير من الكتّاب مسلمين ومسيحيين على حدٍّ سواء.
ومن أمثلة هذه المؤلفات كتاب “ماذا قال علي (ع) عن آخر الزمان”، وكتاب المصري “المسيح أو البشر قدس” لعيسى داود.
وقد ذكر مؤلفا هذين الكتابين أحداثًا سياسية وإقليمية معاصرة واعتبراها أحاديث نبوية أو علامات للظهور، مع أن كثيرًا منها لا أصل له في الكتب الحديثية الموثوقة عند الشيعة.
الدراسة العلمية لعلامات الظهور
لأجل فهمٍ صحيح وممنهج لبحث العلامات، يُعدّ كتاب العالم نصرت الله آيتي الموسوم بـ «تأملٍ جديد في العلامات الحتمية للظهور» عملًا علميًا رائدًا.
يتناول هذا الكتاب مباحث محورية مثل:
- دور العلامات في هندسة الدين ومنظومته المعرفية.
- موقع العلامات إلى جانب الأخلاق والأحكام والعقائد.
- بحث مفهوم البداء وتأثيره في العلامات الحتمية.
- المعايير الأربعة لتشخيص تحقق العلامات في واقع العصر الحديث.
إنّ هذه الأبحاث تمهّد لفهمٍ رصين لمكانة العلامات ودورها الحقيقي في النظام الإلهي، وتساعد المؤمن على التعامل معها بوعيٍ وتوازنٍ بعيدًا عن التسرّع أو الانخداع.
من العلامات إلى الشروط: التحوّل المفهومي المطلوب
ينبغي أن نلتفت إلى رؤية القادة والعلماء الكبار تجاه هذا الموضوع.
ففي كتابٍ جامع بعنوان «ما منتظر هستیم؛ المهدوية في المنظومة الفكرية للقائد الأعلى»، وهو عمل يتضمن نحو ثلاثمئة إلى أربعمئة صفحة من كلمات الإمام الخامنئي منذ ما قبل الثورة إلى عام 1385 هـ.ش، لا نجد ولا كلمة واحدة تتحدث عن علامات الظهور.
وهذا يدلّ على أن التركيز المفرط على العلامات قد يكون مضلّلًا ومُلهيًا عن جوهر الانتظار.
المنهج الصحيح في الدراسات المهدوية هو أن نكون شرط-محورين لا علامة-محورين، أي أن يكون اهتمامنا بـ تهيئة شروط الظهور لا بمجرد رصد العلامات والأحداث.
وفي هذا السياق، يُعدّ كتاب الأستاذ محسن قرائتي بعنوان «شروط ظهور الإمام المهدي (عج) في القرآن الكريم» من المصادر المهمة التي أسهمت في ترسيخ هذا التوجّه العلمي والقرآني.
دور المنهج الشرطي في تصحيح فهم المهدوية
واجبنا الأساس هو أن نوجّه المجتمع نحو الاهتمام بشرائط الظهور، كالإصلاح الأخلاقي، والوعي السياسي، والاتحاد الاجتماعي، والاستقامة الإيمانية، بدل الانشغال المفرط بمقارنة الروايات بالأحداث اليومية.
إنّ اعتماد منهج الشرطية بدل العلاماتية يمنع الانحراف عن فهم المهدوية الحقيقي، ويساعد على بناء التهيئة العملية الواقعية للظهور، ويحمي الناس من الوقوع في فخّ التفسيرات والتطبيقات غير الصحيحة للعلامات.
إنّ هذا التحوّل من العلامة إلى الشرط يُعتبر ضرورة فكرية ومعرفية في عصرنا الذي كثرت فيه التأويلات الخاطئة والتطبيقيات الاعتباطية للروايات.
وينبغي أن نتذكّر أنّ الهدف من بيان العلامات في الروايات ليس التنبّؤ بالأحداث المستقبلية ولا مطابقة الوقائع الجارية عليها، بل إعداد المجتمع المنتظر وتهيئته نفسيًا وسلوكيًا وفكريًا لاستقبال ذلك اليوم الموعود الذي يتحقق فيه وعد الله: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾.
في الختام، هل يمكن في عالم اليوم المليء بالظلم والجور أن نأمل بقيام عدالة عالمية شاملة؟
يُعدّ موضوع العدالة من أكثر المحاور حضورًا وتكرارًا في روايات المهدوية، حيث ورد في أحاديث كثيرة أنّ الإمام المهدي (عج): «يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت ظلمًا وجورًا».
ومن هنا يُطرح السؤال الجوهري: كيف يمكن إقامة عدالةٍ مطلقة في عالمٍ تغمره أشكال الظلم والاضطهاد؟
الوضع الاقتصادي والاجتماعي لشبه الجزيرة العربية في بدايات البعثة
لفهم هذه القضية بصورة أعمق، يمكن الرجوع إلى نموذجٍ تاريخيّ بالغ الدلالة. فعندما بُعث النبيّ الأكرم (ص) بالرسالة، ما هو حال شبه الجزيرة العربية آنذاك؟
تشير الدراسات التاريخية إلى أنّ الناس كانوا يعيشون في أسوأ الظروف الإنسانية.
فعلى المستوى العقدي، بلغ الانحراف حدّ أن كانوا يصنعون أصنامهم من التمر ثم يعبدونها. وعلى المستوى الاجتماعي، كانت جريمة وأد البنات شائعة، في مشهدٍ من القسوة والظلام.
في تلك الأجواء الحالكة، بدأت بعثة النبي (ص) كنور شمعةٍ صغيرة، ثم ما لبثت أن اتّسعت وانتشرت، حتى تحوّل ذلك النور إلى شمسٍ أضاءت العالم كلّه.
وهذه التجربة التاريخية تؤكّد الحقيقة المعروفة: «إنّ مع العسر يسرًا، وإنّ نهاية الليل المظلم فجرٌ مشرق». والنقطة المحورية هنا هي أنّه كلّما ازداد الظلم انتشارًا، ازداد بحث البشر عن طريق الخلاص.
تشبيه طبي لضرورة العدالة المطلقة
يمكن توضيح هذه الحقيقة بمثالٍ طبيّ.
فالإنسان إذا أصيب بصداعٍ عابر، قد تكفيه حبّة دواء بسيطة، أمّا إذا كان المرض خطيرًا، كوجود ورمٍ في الدماغ، فإنّ العلاج يتطلّب مركزًا طبّيًا متخصّصًا وتشخيصًا دقيقًا وطبيبًا حاذقًا.
وبعبارة أخرى، كلّما اشتدّ المرض، ازدادت الحاجة إلى الطبيب الأعلم.
وهكذا هو حال البشرية؛ فكلّما تعمّق الظلم واستفحل، تولّد في الإنسان ضغطٌ داخلي يدفعه للبحث عن عدالةٍ مطلقة، وعن قائدٍ عالمي لا يعمل لمصلحة قومٍ أو عِرقٍ أو دولة بعينها، بل يسعى لإنصاف جميع المستضعفين في الأرض، وهذه هي السمة الجوهرية للإمام المهدي (عج).
العدالة العالمية: مطلب إنساني عام
حتى على مستوى المؤسسات الدولية، بات الإقرار بالحاجة إلى العدالة العالمية أمرًا واضحًا. فالمساعي لوضع قوانين كونية شاملة، والسعي لتحقيق العدالة لجميع الشعوب، تكشف عن أنّ هذا الهمّ أصبح قضية عالمية.
واليوم تحوّل الحديث عن العدالة العالمية والتوزيع العادل للثروات والموارد الطبيعية إلى خطابٍ إنسانيٍّ عام، تتداوله الأوساط الفكرية والسياسية في مختلف أنحاء العالم.
الإنسان أمام مسؤولية بناء حضارة جديدة
لقد خصّصت فصلية “الانتظار” في عدديها الثالث عشر والرابع عشر ملفًا كاملًا لموضوع العدالة العالمية، وناقشت هذه القضية من زوايا متعدّدة: من القرآن والسنّة، إلى آراء المتكلّمين، والفلاسفة، وعلماء الاجتماع.
وهذا التناول المتنوّع يؤكّد أنّ العدالة العالمية تُعدّ حاجةً أساسية معترفًا بها في جميع العلوم الإنسانية.
كما تناول المرحوم آية الله الإمامـي الكاشاني في كتابه ذي الجزأين «خطّ الأمان» منذ مقدمته فكرة أنّ العدالة العالمية هي الضالة المنشودة للبشرية، وأنّها مطلبٌ فطريّ متجذّر في وجدان الإنسان.
فلا يمكن أن نجد في أيّ بقعة من العالم إنسانًا عاقلًا يرضى بالظلم طوعًا.
وبحكم الحُسن والقُبح العقليين، يُدرك البشر جميعًا قبح الظلم وحُسن العدل، بغضّ النظر عن أديانهم وثقافاتهم.
لماذا يستمر الظلم رغم الإقرار بقبحه؟
هنا يبرز السؤال: إذا كان الجميع يعترف بقبح الظلم وحُسن العدالة، فلماذا لا يزال الظلم قائمًا؟
الجواب أنّ الإنسان بفطرته يتطلّع إلى العدالة الشاملة، وهذه النزعة الفطرية نفسها هي التي تمهّد لظهور شمس الولاية العظمى.
(وبعبارة أخرى: يستمرّ الظلم رغم الإقرار بقبحه، لأنّ معرفة الحقّ لا تعني الالتزام به. فالظلم لا ينتج من الجهل بقبحه، بل من تغليب المصالح والأهواء والقوّة على القيم الأخلاقية. كما أنّ الأنظمة البشرية، وإن رفعت شعارات العدالة، تفتقد إلى القدرة والحياد والالتزام الشامل لتطبيقها، فتتحوّل العدالة إلى مبدأٍ نظريّ لا واقع عملي. ومن هنا يبقى الظلم قائمًا ما دامت القيادة العادلة الجامعة غائبة، وتتحقّق العدالة الكاملة فقط حين تتوحّد المعرفة بالحقّ مع القدرة على تنفيذه دون خضوع لمصلحة أو هوى).
وبتعبير قائد الثورة الإسلامية، فإنّ البشرية مدعوّة لبدء حضارةٍ إنسانيةٍ جديدة قائمة على العدل والكرامة.
وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يوفّقنا جميعًا للقيام بواجبنا في التمهيد لظهور الإمام المهدي (عج)، وأن يجعلنا من العاملين الصادقين لإقامة العدل، لا من المنتظرين القاعدين، حتّى يتحقّق الوعد الإلهي بقيام العدالة العالمية الشاملة.
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل