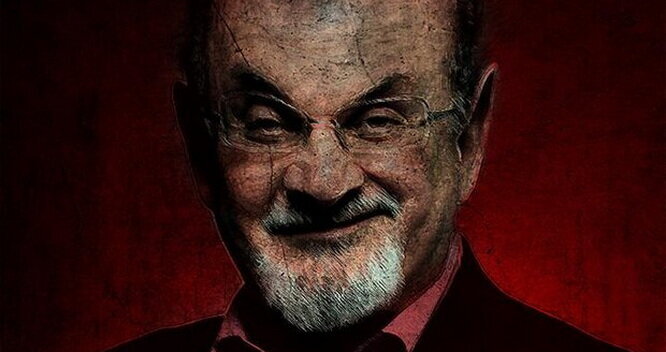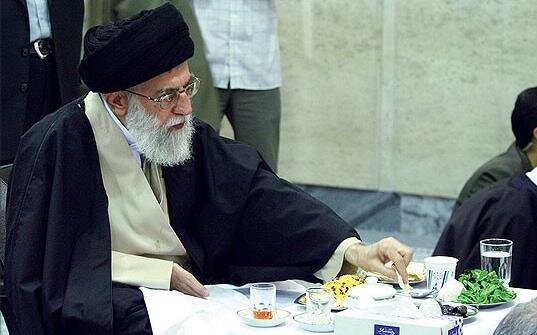يعتبر الانتماء من أهم العناصر التي تساهم في بناء شخصية الإنسان بشكلٍ عامّ وللشباب بشكلٍ أخصّ لطبيعة هذه المرحلة العمرية، وهي القاعدة الأساسية التي يجب ترسيخها حتى يمكن أن يُنطلَق منها للبناء عليها والسير نحو الأمام قُدُماً
يقول تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى﴾[1].
يعتبر الانتماء من أهم العناصر التي تساهم في بناء شخصية الإنسان بشكلٍ عامّ وللشباب بشكلٍ أخصّ لطبيعة هذه المرحلة العمرية، وهي القاعدة الأساسية التي يجب ترسيخها حتى يمكن أن يُنطلَق منها للبناء عليها والسير نحو الأمام قُدُماً، ومن دون الانتماء يبقى الشابُّ بكافَّة وجوده يعيش على هوامش الجماعات الأخرى، واليوم إحدى أكبر المشاكل التي يعاني منها شباب اليوم هي الهوية المضطربة أو المتزلزلة في مقابل الهويات المتعددة التي يرى نماذجها العملية والتي يتأثر ببعض أفكارها، فيحاول أن يصوغ منها هويةً تناسبه، أو أنه يرى فيها ذاته وكماله بل وشخصيته المستقبلية. وهذا الانتماء لا يوجد عند المرء وليد لحظة، بل هو نتيجة تراكم جهود ضخمة، وهو بحاجة إلى توجيهٍ مستمر ومراقبة دائمة وتصويب من أهل العلم والمعرفة حتى يبقى انتماءً سليماً لا لبس فيه.
لا شكّ أنّ الانتماء حاجة فطرية عند الإنسان وخاصةً الشباب الذي يرى ضرورة انتمائه إلى جماعة يكون جزءاً منها وتعبر عن حاجاته وطموحاته وتنسجم مع خصوصيات عصره على مستوى العلوم والمعارف من جهة وعلى مستوى التحديات المختلفة وسبل مواجهتها من جهةٍ ثانية.
ومن هنا فإنّ هناك قاعدتين أساسيتين يجب البدء منهما والبناء عليهما قبل الحديث عن أيّ بناء على مستوى الأبعاد المختلفة، لأنه ما لم تكن قاعدة البناء قاعدة صلبة ومحكمة فإنّ البناء عليها سيكون بناءً على الرمل، وبالتالي فإنه مهدَّد بالسقوط والإنهيار، وهاتان القاعدتان هما:
1- تعميق الانتماء.
2- تعزيز الانتماء.
أولاً: تعميق الانتماء
وفي مقام الحديث عن هذا الجانب يمكن العمل على النقاط الثلاث التالية:
1- تقوية الرؤية التوحيدية: بمعنى تعزيز حضور الله في حياة الشباب وما يترك ذلك من أثر في سلامة عقيدته وتحصينه في وجه التحدِّيات، فلا يكون هذا الحضور حضوراً شكلياً، بل حضور يبعثُ الروح في نفسه فيحمل هذه الرؤية كرؤية ثورية يتمرد من خلالها على الواقع السيِّئ ويعمل لإصلاحه، وهذا ما يُفهم من قوله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ * قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ * قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾[2].
وهذه الرؤية تتطلَّب التركيز على القرآن والمفاهيم القرآنية والتعمُّق بسيرة الأنبياء والأولياء لفهمها بطريقة واعية كمنهج ديني إيماني في مواجهة شتى أنواع الشرك ومشاريع الاستكبار وأن لا يكون هذا الحضور حضوراً باعثاً على الحياد والإنطواء.
2- تمتين وترسيخ القضية: فللشباب دور هامّ في انتمائهم إلى الحق في هذا الصراع الانساني والحضاري والتاريخي، فهم ليسوا فئةً حيادية أو غير مبالية، وليسوا فئة متلقية وغير فاعلة أو غير منتجة، بل هم العمدة وعليهم الرهان بعد الله، ولأن الانتماء حاجة فطرية فيجب المبادرة إلى ترسيخ الوعي عندهم بالقضايا الساخنة على امتداد العالم وتقوية بصيرتهم بما يجري حولنا، ولأنّ هذه الفئة يراهن عليها الجميع كان من الضروريّ العمل عليها قبل أن يسبقنا إليهم غيرنا ويصوغ لهم انتماءات وهمية ومُثُلاً عليا صناعية لا تمت إلى العقيدة والأخلاق بِصِلة.
3- تمتين الانتماء للمشروع: أي أنه بعد وضوح القضية يجب أن تتبنى فئة الشباب المشروع التغييري بكافة أبعاده الثقافية والفكرية والعسكرية لما يشكل ذلك من بعد ديني وإنساني، وأن تكون في صلبه فهم ضباط الحرب الناعمة وقادة الحرب العسكرية والسد المنيع في وجه الحرب النفسية والحرب الإعلامية، سيما وقد شهدت ساحتنا تجارب رائدة على مستوى التغيير والمقاومة وكان عنصر الشباب هو العنصر الحاسم والأساسي فيها.
ولا يخفى أنّ الانخراط بهذا المشروع يعني استنفار هذه الشريحة على العلم والمعرفة والإيمان والأخلاق والهوية وبناء المجتمع وسد ثغراته وتحمل المسؤوليات الجسام من أجل النهوض بالمجتمع نحو الكمال والرقيّ وتوفير أسباب السعادة له.
ثانياً: تعزيز الانتماء
والمراد هنا أنه لا بد من تشخيص المشكلة التي يواجهها الشباب بشكلٍ مباشر، والسؤال المركزي هنا هو: لماذا نرى شبابنا اليوم منتمياً ومفاخراً بهويته ثم لا يكون سلوكه وأولوياته مُتطابقةً مع هذه الهوية؟ أين الخلل القائم بين النظرية والتطبيق؟ وهل هذه المشكلة ثقافية أم تربوية أم بنيوية؟ وهل إنّ شبابنا جُرفوا في الغزو الثقافي والحرب الناعمة التي يشنها الغرب بأقذر أسلحتها وأخذت منهم هذه المفاهيم المسممة مأخذها فبات الشابُّ عندنا تتنازعهُ أشكال متناقضة من الثقافات، فعقله في مكان، وقلبه وعواطفه في مكانٍ آخر وعاداته وسلوكياته في مكان ثالث.
وفي التشخيص الدقيق لهذه المشكلة نرى أنّ هناك فجوة كبيرة في بناء الشخصية الشبابية تجعلنا نميل بشكلٍ قويّ إلى أنّ طبيعة المشكلة هي مشكلة سلوكية.
وإذا كانت المشكلة كذلك فلا بد من التوجُّه نحو مسارين أساسيين:
الأول: تحديد المواصفات المعيارية التي تمكننا من تحديد الخلل، ثم نحدد المطلوب، ثم نعمل على العلاج لردم الهوة بين ما هو قائم وما هو مطلوب.
ومن الطبيعي أن لا يكون العمل عشوائياً على مختلف الصفات رغم أهمية أيّ صفة كمالية في بناء الشخصية، بل المطلوب العمل على خصوص الصفات الأساسية والتي هي محلّ حاجة وابتلاء.
ويمكن تقسيم هذه الصفات إلى قسمين: ما يرتبط بالمعرفية وما يرتبط بالنمطية والسلوك.
أما المعرفية فتشمل المعرفة الفقهية والمعرفة المفاهيمية والاطلاع على الثقافة العامة والوعي الاجتماعي والمعرفة العلمية الأكاديمية.
وأمّا النمطية السلوكية فتعني تقوية البعد الإنساني، فتشمل الأخلاق الاجتماعية من قبيل الأخلاق في الأسرة والعمل، كما تشمل مكارم الأخلاق كالوفاء بالعهود والصدق والصراحة والشفافية والقناعة والعفة والإنفتاح على الآخر والسلامة البدنية واحترام الوقت.
الثاني: تحديد أهم الاستراتيجيات لاجتياز هذه المراحل نحو الهدف المطلوب ومن ثَمَّ البدء بالعلاج: ونعني بها مختلف أبعاد الشخصية الشبابية التي يجب العمل عليها والتي تُشكل بمجموعها نموذج الشخصية الشبابية الإيمانية المنشودة، وهذا المحور ما سنبينه بالتفصيل في المحاضرة القادمة.
زاد البصيرة في شهر الله، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
[1] سورة الكهف، الآية: 13.
[2] الأنبياء، 58-60.