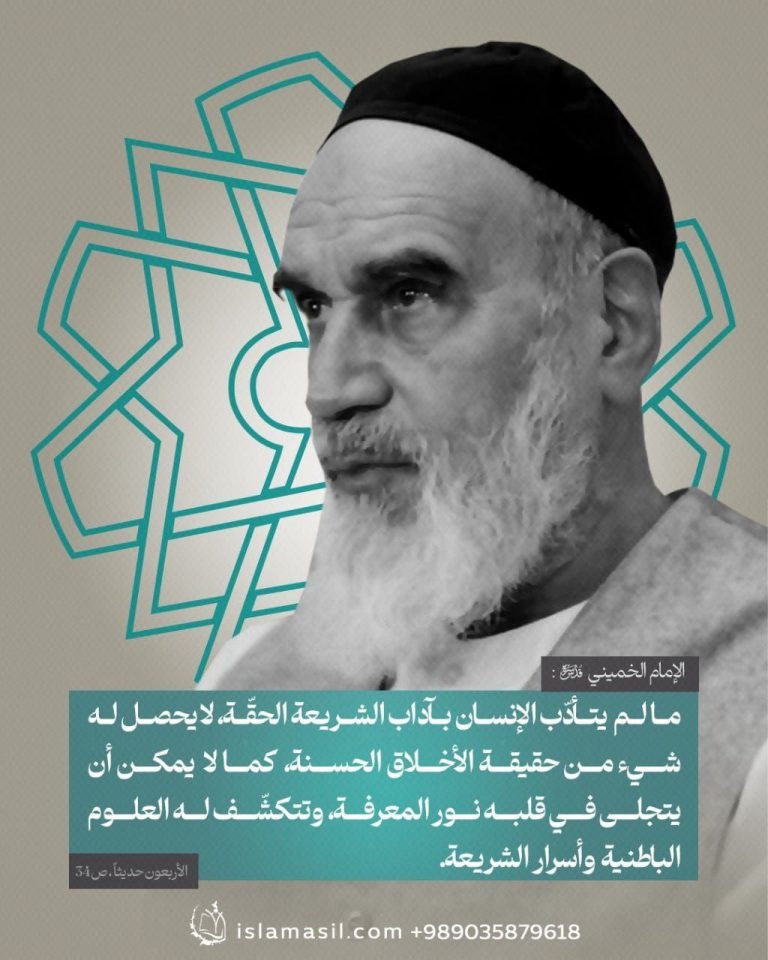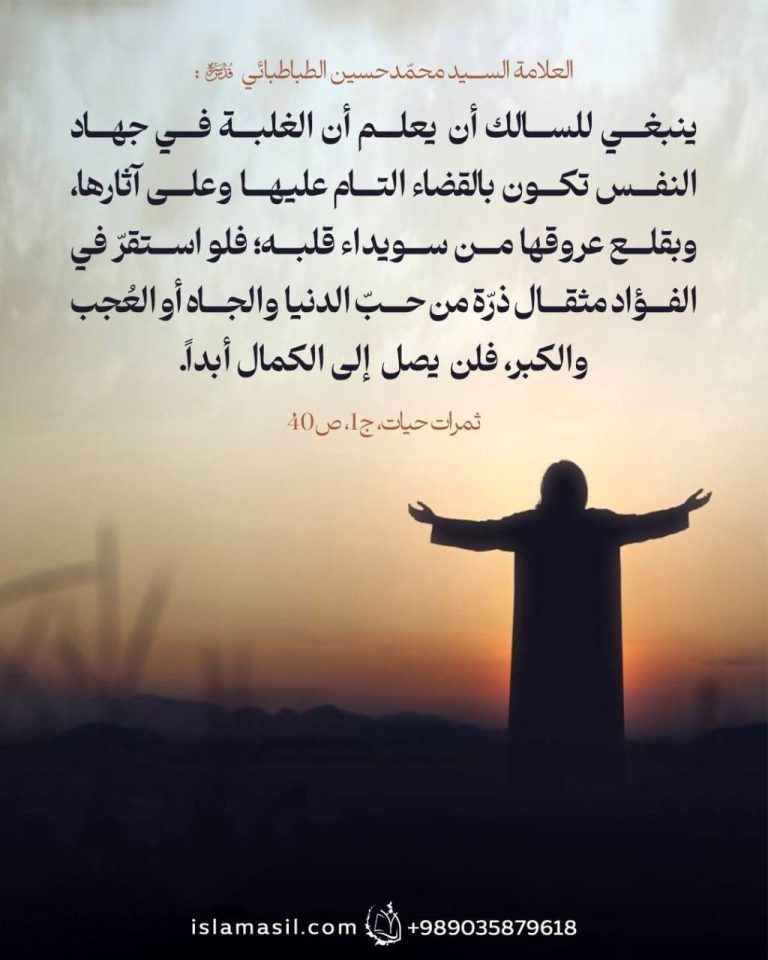إذا كان الحديث عن أسلوب الحوكمة في جمهورية إيران الإسلامية يُراد منه أن يكون تحليليًا، دقيقًا وداخليًا، فلا بد أن يتجاوز مستوى الأحكام الشائعة حول أوجه القصور التنفيذية أو الأخطاء العرضية أو ضعف بعض السياسات، ويرتقي إلى مستوى أعمق؛ أي مستوى المنطق السائد في الحوكمة. في هذا المستوى، لا يتعلق الأمر بالأشخاص أو المؤسسات، بل بكيفية صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وطريقة تعريف القضايا، ونموذج ترتيب الأولويات للأهداف الكبرى. لذلك، النقد الحالي لا ينبع من موقف خارجي، بل من منظور موافق على جوهر النظام وقلق من أجل مستقبله؛ منظور يبحث عن استمرار وتطوير الجمهورية الإسلامية ليس من خلال تثبيت الوضع الراهن، بل عبر إعادة التفكير العقلانية في أسلوب الحوكمة.
الافتراض المحوري لهذه المذكرة هو أن جزءًا كبيرًا من التحديات المتراكمة للجمهورية الإسلامية لا يمكن تفسيره بمجرد الإشارة إلى الضغوط الخارجية أو العقوبات أو حتى أوجه القصور الإدارية. هذه العوامل، رغم كونها حقيقية وفاعلة، لا تُفسر إلا جزءًا من القضية في أفضل الحالات. القضية الأساسية هي أن المنطق السائد في الممارسة الحوكمة يميل أكثر إلى «حوكمة البقاء» بدلًا من «حوكمة التنمية»؛ منطق يركز على الحفاظ على الاستقرار، وصد التهديدات، وإدارة الأزمات المستمرة، وليس على تراكم تدريجي للقدرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من الواضح أن المقصود بـ«التنمية» في هذا السياق هو التنمية بمعناها المحلي والحضاري، وهو مفهوم قريب من «التقدم» الذي يهدف إلى رفع قدرات المجتمع بشكل متوازن ضمن إطار هويته التاريخية والثقافية والقيمية، وليس إعادة إنتاج نموذج التنمية الكلاسيكي في الأدبيات الغربية، الذي في كثير من صيغته يختزل التقدم إلى النمو الاقتصادي والعقلانية الآلية والانفصال عن السياقات المعنوية والاجتماعية. بناءً عليه، التمييز بين «حوكمة البقاء» و«حوكمة التنمية» يعكس طريقتين مختلفتين في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع ضمن أفق التنمية المحلية، وليس مقارنة بين نماذج مستوردة أو مقلدة.
تكمن أهمية هذا التمييز في أن الجمهورية الإسلامية ليست مجرد نظام سياسي قائم، بل تحمل أفقًا حضاريًا. والحضارة بطبيعتها مرتبطة بالتنمية متعددة الأبعاد والمتشابكة؛ التنمية التي تشمل المؤسسات السياسية، والهياكل الاقتصادية، ورأس المال الاجتماعي، والقدرات الثقافية، والعقلانية الإدارية، والقدرة الفعلية للمجتمع على التحرك. في هذا الأفق، مجرد البقاء، حتى وإن كان مستقرًا، لا يكفي، ويجب أن تنتقل الحوكمة بالضرورة من منطق البقاء إلى منطق التنمية، كنهج سائد لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
بالطبع، الحوكمة من أجل البقاء في فترات تاريخية معينة ليست مذمومة، بل قد تكون عقلانية وضرورية؛ خاصة في الظروف الثورية أو الحروب أو التهديدات الوجودية. تبدأ المشكلة حين يتحول هذا المنطق الطارئ إلى الوضع الطبيعي، وحتى في فترات الاستقرار النسبي يظل يلقي بظلاله على اتخاذ القرار وصياغة السياسات. في هذه الحالة، تمتد الأدوات واللغة المستمدة من منطق البقاء إلى المجالات التي بطبيعتها تنموية وتتطلب أفقًا طويل الأمد، ومشاركة اجتماعية، وبناء مؤسسي مستدام.
من هذا المنظور، السؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية قد نجت أو لا، بل ما إذا كان منطق الحوكمة السائد قد أعيد ضبطه وفق الأفق الحضاري ومتطلبات التنمية الشاملة أم لا. طرح هذا السؤال في حد ذاته دليل على الوفاء بجوهر النظام؛ إذ لا يمكن لنظام يطمح لتقديم نموذج بديل أن يظل غير مبالٍ بالفجوة بين الأفق النظري والممارسات العملية للحوكمة. وبناءً على ذلك، تسعى هذه المذكرة، اعتمادًا على نظريات التنمية وبمنهج تحليلي وغير شعاري، إلى توضيح التمييز المفهومي بين «حوكمة البقاء» و«حوكمة التنمية»، وتبيان كيف أثّر غلبة منطق البقاء بشكل هيكلي على الأداء العام للجمهورية الإسلامية. الهدف ليس اختزال التنمية في بعد محدد أو تقديم حلول تنفيذية، بل صياغة دقيقة للمسألة التي، دون فهمها، ستظل أي إصلاحات أو تحولات سطحية وغير مستدامة.
لتفسير دقيق لمسألة الحوكمة في الجمهورية الإسلامية، قبل أي تطبيق تجريبي، من الضروري إقامة تمييز مفاهيمي وتحليلي بين منطقي حوكمة مختلفتين؛ تمييز متجذر في الأدبيات النظرية للتنمية وبناء الدولة وعلم الاجتماع السياسي، يتيح الانتقال من الوصف العام والأحكام المعيارية إلى مستوى التحليل البنيوي. المقصود بهذا التمييز ليس تقييمًا أخلاقيًا أو مواجهة مبسطة، بل صياغة نوعين «مثاليين» من الحوكمة، يتشكل كل منهما وفق نوع محدد من القضايا، وترتيب الأولويات، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
تظهر حوكمة البقاء في الحالات التي يُنظر فيها إلى القضية المحورية للنظام السياسي على أنها الحفاظ على الوجود، ومنع الانهيار، والتصدي للتهديدات الفعلية أو المحتملة. في هذا المنطق، ترى الدولة نفسها في حالة طوارئ دائمة أو شبه دائمة، والعقلانية التي تحكم القرارات عقلانية تفاعلية، قصيرة المدى وموجهة للسيطرة. تُعرف القضايا هنا ليس كفرص لتراكم القدرات، بل بشكل رئيسي كمخاطر يجب احتواؤها أو دفعها. لذلك، تكون الأولوية للثبات السياسي، وتماسك بنية السلطة، وتقليل المخاطر الفورية، وتستند السياسات إلى إدارة الأزمات والتدخلات المؤقتة بدلًا من بناء مؤسسات مستدامة وإصلاحات تدريجية. هذا المنطق يميل بطبيعته إلى تركيز السلطة، وإضعاف المؤسسات الوسيطة، وتقييد المشاركة الاجتماعية؛ ليس بالضرورة بدافع سوء النية، بل لأن المشاركة والحوار الاجتماعي في أفق البقاء يُعتبران مصدرًا محتملًا لعدم الاستقرار.
من منظور علم اجتماع التنمية، تترافق حوكمة البقاء مع نوع من القصر المؤسسي؛ أي أن السياسات تركز أكثر على النتائج الفورية في احتواء الأزمات، بدلاً من آثارها التراكمية وطويلة المدى على رأس المال الاجتماعي، والثقة العامة، والقدرات المؤسسية. في هذا الإطار، تتحول الدولة أكثر إلى لاعب يدير المجتمع بدلًا من أن تكون شريكًا في التنمية.
في المقابل، ترتكز حوكمة التنمية على منطق مختلف؛ منطق تكون فيه القضية المحورية ليست مجرد بقاء النظام السياسي، بل تحسين جودة النظام الاجتماعي وتراكم مستدام للقدرات المؤسسية على جميع المستويات. في هذا المنطق، لا يُختزل التطور في أي مجال، بما في ذلك الاقتصاد، بل يُنظر إليه كعملية متعددة الأبعاد ومتشابكة تشمل السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والمجتمع، والبنية الإدارية معًا. تعتمد حوكمة التنمية على النظامية، والثبات المؤسسي، وقابلية التنبؤ، بدلًا من مجرد الاستجابة للأزمات، وتعتبر الدولة نفسها ليس فقط حافظًا للنظام، بل مهندسًا للمؤسسات التي تجعل المشاركة والثقة والتعاون المستدام بين الدولة والمجتمع ممكنًا. في هذا الإطار، تُعتبر المشاركة الاجتماعية، والنقد، والمطالبة، وحتى الصراعات المؤسسية جزءًا طبيعيًا من آلية التقدم.
في حوكمة التنمية، تكون العقلانية السائدة عقلانية طويلة المدى وتراكمية. تُصمم السياسات بناءً على النتائج البنيوية وعابرة الأجيال، ويصبح بناء المؤسسات، وشفافية القواعد، واستقرار اتخاذ القرار، وإمكانية التنبؤ بالمستقبل عناصر أساسية للحوكمة؛ وهي عناصر، بدونها، حتى وفرة الموارد المادية لن تؤدي إلى تنمية مستدامة.
تزداد أهمية هذا التمييز عندما يُنظر إليه في سياق الطموح الحضاري للجمهورية الإسلامية. فبناء الحضارة يتطلب إنتاج نظام اجتماعي مستدام، ديناميكي وقابل لإعادة الإنتاج؛ نظام لا يقتصر على البقاء فحسب، بل يكون نموذجًا يحتذى ويُلهم الآخرين. هذا الأفق يتوافق بطبيعته مع حوكمة التنمية، ويتناقض مع سيادة منطق البقاء المزمن. لذلك، المسألة الأساسية ليست صراع البقاء والتنمية، بل الفشل في الانتقال المؤسسي والواعي من منطق البقاء إلى منطق التنمية في ظل بقاء سياسي مؤكد، على الأقل على المستوى الهيكلي.
فهم هذا التمييز المفاهيمي يتيح تحليل أداء الجمهورية الإسلامية بشكل شامل، ليس كحالات فردية، بل بالنسبة لمنطق الحوكمة السائد، وهو منطق تشمل نتائجه كامل النظام الاجتماعي والسياسي.
التبعات الهيكلية لغلبة حوكمة البقاء
كما أظهرت الأقسام السابقة، إن غلبة منطق حوكمة البقاء لا تقتصر على ظهور قصور جزئي أو تقلبات مؤقتة، بل تترك آثارًا عميقة وهيكلية على النظام الاجتماعي والسياسي ككل. غالبًا ما تتشكل هذه التبعات بشكل تدريجي وتراكمي، ولذلك قد تبدو غير مهمة أو حتى غير مرئية على المدى القصير؛ إلا أنها على المدى الطويل تضعف قدرات النظام التنموية وتواجه أفق بناء الحضارة بتحديات جوهرية. إن فهم هذه التبعات أساسي لفهم سبب صعوبة تجاوز الوضع الراهن.
أول تبعية هي التآكل التدريجي لرأس المال الاجتماعي وانخفاض الثقة المؤسسية. في المنطق الذي تُعتبر فيه إدارة التهديد والسيطرة على الاستياء أولوية، لا يُنظر إلى الثقة العامة على أنها رأس مال استراتيجي، بل كمتحول ثانوي. ونتيجة لذلك، لا تصمم السياسات بالضرورة لتعزيز الثقة المؤسسية، وأحيانًا تؤدي إلى إضعافها. هذا الاتجاه يقلل مع مرور الوقت من ثقة المواطنين بكفاءة وعدالة وتوقعات النظام الحاكم، ويجعل النظام يقع في دائرة من انعدام الثقة وزيادة تكاليف الحوكمة؛ دائرة ترتبط مباشرة، من منظور نظريات التنمية، بإضعاف القدرات التنموية.
التبعية الثانية هي إضعاف المؤسسات وغلبة المنظور قصير المدى على المستوى المؤسسي. في منطق البقاء، تتحول المؤسسات، أكثر مما ينبغي، من آليات مستدامة لحل المشكلات إلى أدوات لإدارة الظروف الخاصة. هذه النظرة تمنع تكوين استقلال نسبي، وسلطة تخصصية، وقدرة على التعلم المؤسسي، وتجعل القرارات أكثر شخصية، مؤقتة، ومعتمدة على الظروف اللحظية. ويكون القصر المؤسسي مدمّرًا بشكل خاص للمشروعات التنموية التي بطبيعتها تحتاج إلى آفاق طويلة المدى، بل ويعيد تفسير البرامج التنموية ضمن منطق البقاء ذاته.
التبعية الثالثة هي تغيير موقع المجتمع من فاعل تنموي إلى مجرد قضية حوكمة. في حوكمة البقاء، يُنظر إلى المجتمع أقل كشريك في التنمية وأكثر كمصدر محتمل للاستياء أو عدم الاستقرار. تدريجيًا، يؤدي هذا المنظور إلى تحقق ذاتي: كلما أصبح المجتمع تحت سيطرة ردية أكبر، تقل إحساساته بالتأثير والانتماء والفاعلية الإنتاجية. بينما في نظريات التنمية الاجتماعية والسياسية، تُعد المشاركة الفاعلة للمجتمع مصدرًا رئيسيًا للدينامية والابتكار. إن تقييد هذه المشاركة يزيد الفجوة بين الدولة والمجتمع ويجعل التعبئة الاجتماعية للأهداف الكبرى، بما في ذلك الأهداف الحضارية، أكثر صعوبة.
في المجمل، تؤدي كل هذه التبعات في النهاية إلى انسداد تدريجي لأفق بناء الحضارة. فبناء الحضارة يتطلب تراكمًا مستمرًا لرؤوس الأموال المادية والرمزية، وبناء مؤسسات مستدامة، وإنتاج معنى، ومشاركة فعالة للمجتمع في مشروع تاريخي. على الرغم من أن حوكمة البقاء قد تخلق استقرارًا قصير المدى، فإنها على المدى الطويل تقلل قدرة النظام على إنتاج نظام اجتماعي ملهم وقابل لإعادة الإنتاج. في هذه الحالة، تتسع الفجوة بين الطموحات الحضارية الكبرى والتجربة المعيشة للمجتمع، وتصبح هذه الفجوة مصدرًا للشك، وانعدام الثقة، وتآكل الشرعية الوظيفية. في النهاية، البقاء الذي لا يقوم على التنمية المؤسسية لا يجعل التنمية الشاملة ممكنة فحسب، بل يجعل بقاء النظام طويل المدى أكثر كلفة وهشاشة.
المؤلف: علي باشتن سبزواري، باحث في العلوم السياسية
*ترجمة مركز الإسلام الأصيل