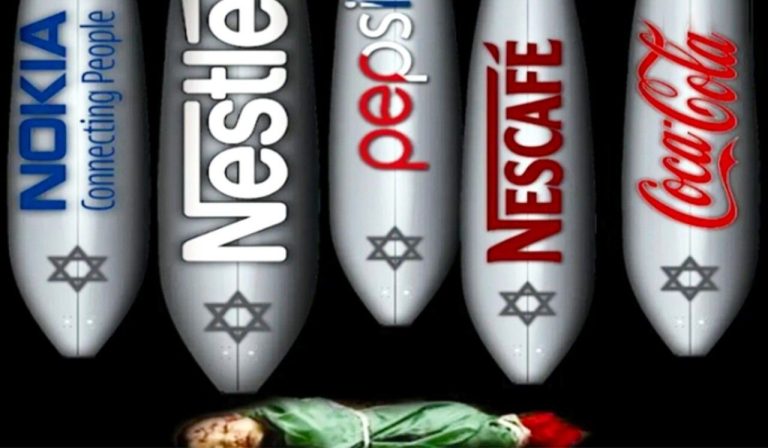بسم الله الرحمن الرحيم ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ* يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ* فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (البقرة: 8 – 10).
المنطق السائد بين أهل النفاق هو أنّهم يُعلنون شيئاً ويستبطنون شيئاً آخر، ما يجري على ألسنتهم هو الإسلام وإعلان الشهادتين، أمّا ما هو في الباطن، وفي أعماقهم، فالكفر والنفاق. ولذلك، نجد أنَّ الله تبارك وتعالى فضحهم، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾. ما هو هدفهم؟ هدفهم تبيّنه هذه الآية: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ أي إنّهم يَخدعون الله والمؤمنين: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾.
* ﴿فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾
﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾؛ يُبيّن الله تبارك وتعالى أنّ مرض تلك الجماعة هو النفاق؛ لأنّ النفاق هو أن تُظهر شيئاً وتستبطن شيئاً آخر، أن تُقبِلَ بوجه وتُدبر بوجهٍ آخر، كما قال الإمام الصادق عليه السلام. لكنّ اللّافت للنظر في هذه الآية هو قوله تعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾. قد يقول قائل: إذاً، الله تبارك وتعالى هو الذي أحدث هذا المرض، وهو الذي يزيد هؤلاء مرضاً. هذا الكلام جوابه أحد تفسيرين:
1- التفسير الأوّل: إذا ابتُلي الإنسان بمرضٍ ما، سواءٌ كان مرضاً جسديّاً أم نفسيّاً، ولكنّه أهمل نفسه من دون أيّ علاج، فسوف يزداد مرضاً، وتتفاقم حالته. مثلاً: إذا عانى أحدٌ من داء في معدته، وأهمل تناول الأدوية، فإنّ وضعه الصحيّ سيزداد سوءاً تدريجيّاً، إلى أن يقضي عليه المرض أيضاً. والأمراض النفسيّة من هذا القبيل؛ لو فُرض أنّك كذبت لأوّل مرّة، فمن واجبي شرعاً أن أنهاك عن المنكر، فأقول لك: “لا تَعد إلى الكذب ثانيةً”، لكنّك مع ذلك أهملت نفسك، وصرت تكذب بصورة مستمرّة، بحيث أصبح الكذب عادةً من عاداتك؛ لأنّك أهملت علاج مشكلتك من البداية.
كلّ مرض إذا تُرك من دون علاج فسوف يتفاقم، هذه قاعدة ثابتة. من هنا، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾؛ بمعنى أنّ الله تبارك وتعالى وَضع قانوناً وسنّة لهذا الكون، وهو: إنّ أيَّ إنسان، سواءٌ كان منافقاً أو مبتلياً بأيّ مرض من الأمراض، إذا ما ترك نفسه وأهملها من غير علاج، فسوف يتفاقم مرضه بشكلٍ تدريجيّ. هؤلاء المنافقون ابتُلُوا بهذا المرض، وهو مرض النفاق، لذلك كان ينبغي لهم أنْ يتصدّوا لمعالجته، ولكنّهم أهملوا أنفسهم. وهذا الإهمال هو الذي أدّى إلى أن يتفاقم المرض، ويزداد النفاق شيئاً فشيئاً.
2- التفسير الثاني: هو أن نقول: إنّ هذا المثَل مشابهٌ لمثَل نوح عليه السلام. فيقول الله تعالى عن لسانه عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَ فِرَاراً﴾ (نوح: 5-6)؛ إنّ دعوة نوح عليه السلام لهؤلاء للإيمان، وليس معقولاً أن يكون سبباً لابتعادهم عن الإيمان، مع أنّه عليه السلام، كلّما دعاهم تمادوا في ضلالهم. وهذا ما نلاحظه أيضاً في حياتنا اليوميّة. فعلى سبيل المثال: قد يأتي أحدهم ويقول لابنه: يا ولدي، عليك أن تتّجه بهذا الاتّجاه، وإلّا سوف تَفسد أخلاقك. ومع ذلك، كلّما استمرّ في تنبيهه، كلّما ازداد عناده، فازداد ضلاله.
أيضاً، الأمر نفسه بالنسبة إلى هذا المنطق. أجرى الله تبارك وتعالى الكثير من الحجج على هؤلاء المنافقين؛ وكلّما أجرى لهم حجّةً ابتعدوا أكثر، وازدادوا في غيّهم وضلالتهم ونفاقهم أكثر فأكثر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً﴾، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾.
* ﴿لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ﴾
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (البقرة: 11). إنّ عبارة ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ لها تفسيران:
1- التفسير الأوّل: أنّ هؤلاء كانوا يقولون إنّهم متديّنون؛ إذ كانوا يُظهرون بصورة مستمرّة أنّهم قمةٌ في الإيمان؛ لأنّهم كانوا يشعرون في قرارة أنفسهم أنّهم متّهمون؛ لأنّ الإنسان المجرم يخاف من التّهمة بصورة دائمة، ويخاف من أن يُشار إليه بالبنان. فإذا سُئل أحد هؤلاء: لماذا تنافق؟ فالجواب الحاضر باستمرار هو: “أنافق؟! إنّنا نحن مصلحون”. إذاً، يحاول هذا الإنسان المنافق بصورةٍ مستمرّةٍ ودائمة، أن يؤكِّد أنّه من المؤمنين ومن المصلحين، لا لشيءٍ إلاّ لأنّه يريد أن يُبرز نفسه أمام المتديّنين أنّه قمّة في التديّن، وقمّة في المحافظة على مصالح المسلمين.
2- التفسير الثاني: أن نقول: إنَّ هؤلاء، نتيجةً لارتباطهم بمصالحهم، أصبحوا من أصحاب العقيدة النفعيّة، والمذهب المصلحي؛ أي إنّهم حيث يَرون مصالحهم ومنافعهم يذهبون. هكذا كان دينهم. هم جماعة من المنافقين لا يعرفون ضميراً ولا ديناً. وعندما يعيشون بهذه الطريقة، تُمسح مفاهيمهم وأفكارهم؛ لأنّهم انغمسوا في المادة وفي شهواتهم. ونتيجةً لذلك، يحسبون أنّ الفساد صلاحٌ، وبالعكس، وأنّ الخير شرٌّ، وبالعكس. ومع أنّهم مفسدون، فإنّهم يتصوّرون أنفسهم مُصلحين، ولذا قالوا: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾. أمّا في الواقع، فإنّهم، وبحسب تصريح القرآن الكريم، قمّة في الفساد.
* ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾. يظهر من هذه الآية أنّ ثمّة نقاشاً بين الطائفة المؤمنة والطائفة المنافقة؛ فالمؤمنة تطلب من المنافقة أن لا تفسد في الأرض، بينما الأخيرة تنفي قيامها بذلك، وتقول إنّها جماعة من المصلحين.
إنّ المنافقين، في الحقيقة جماعة متستّرة وراء عبارة “لا إله إلّا الله محمّد رسول الله”، أو وراء كلمة الإسلام. إذ إنّ مقتضى نفاقهم أن يتستَّروا. فكيف كان يحصل جدال ما بين هاتين الطائفتين، الطائفة المؤمنة والطائفة المنافقة؟ هذا سؤال.
أمّا السؤال الآخر، فهو: لو كانت الطائفة المنافقة، واضحة للعيان ومعروفة، فلماذا سكت نبيّ الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم عنها؟ ألا يشكّل المنافقون خطراً كبيراً على دولة الإسلام؟ ما داموا يشكّلون خطراً كبيراً على دولة الإسلام، فلماذا تركهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤدِّبهم على أقلّ تقدير؟ السؤال الأوّل يأتي جوابه لاحقاً، فيما سنجيب عن السؤال الثاني لأهميّته.
* ماذا كان هدف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟
حتّى نستطيع الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي أن نتصوّر وضع الدولة الإسلاميّة في الجزيرة العربيّة. طبعاً، المؤمنون، وعلى رأسهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، استطاعوا بعد الهجرة إلى المدينة المنوّرة، أن يبنوا دوَيلة صغيرة في المدينة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن رئيس عشيرة، أو زعيم قبيلة أو قرية أو مدينة، وإنّما كان مبعوثاً للعالمين: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: 107)، وليس لأهل المدينة المنوّرة فقط، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم أنَّ رسالته ينبغي أن تنتشر في كلِّ أنحاء العالم.
من هنا، كان ينبغي له صلى الله عليه وآله وسلم أن يحمي هذه الدولة من جميع الجهات، لكي تنتشر الدعوة، وترفرف راية “لا إله إلّا الله” فوق كلِّ أرض. نتيجةً لذلك، أدرك أعداء الإسلام أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سيعمل على توسيع رقعة نفوذ الإسلام، ففتُحت عليه جبهات عدّة من الخارج: جبهة قريش (وقريش كانت قويّة)، وجبهة اليهود (وهم كانوا أقوياء جدّاً، لا سيّما في خيبر)، وجبهة الأعراب (الذين يعيشون في البوادي أيضاً). هذه الجبهات الثلاث كلّها كانت منصبَّة على هذه الدويلة الصغيرة والناشئة، وكلّ واحدة منها كانت تكيد للإسلام، ولهذه الدويلة الصغيرة.
وهكذا، اليهود كانوا يحيطون بالمدينة المنوّرة من جميع الجهات، وأزلام قريش كانوا يتمركزون في مكّة، والأعراب كانوا يساندون قريشاً من جميع الجهات، وأفضل مثال على هذا الأمر هو واقعة الأحزاب، التي تُجسّد مدى تحالف هؤلاء الجماعة ضدّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضدّ الإسلام.
هجموا هجمةً واحدةً على المدينة المنوّرة، ولكنَّ الله هو الذي ردَّهم فقط، وليس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو المؤمنون؛ لأنّ المؤمنين كانوا قلّة وضعافاً جدّاً، وقد أرسل الله لهم مرضاً فأقعدهم. في مثل هذه الحالة. والسؤال هنا: هل كان من الحكمة أن يفتح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه كلّ تلك الجبهات؟ الجواب: طبعاً لا. لذلك عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنّ الجبهات من الخارج كثيرة، وإذا فتح جبهة إضافيّة مع المنافقين في الداخل، فستصبح الحرب عليه من الداخل ومن الخارج في آنٍ، هذا كان كفيلاً بالقضاء على دولة الإسلام. فبفضل تسديد الله تبارك وتعالى لهؤلاء الجماعة، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مضافاً إلى حكمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم استطاعوا أن يتجاوزوا هذه المحن كافّة، وأن ينتصر الإسلام، وأن يمتدّ نفوذ عبارة “لا إله إلّا الله” إلى دولةٍ لا تغيب عنها الشمس.
* رسالة حيّة خالدة
هذه هي رسالة الإسلام التي اجتازت 14 قرناً من الزمن، وهي إلى الآن في ثوب جديد، أفضل من ذاك الذي كان يلبسه المسلمون في ذلك الوقت. وهذه الرسالة ليست متوقّفة على شخص معيّن، بل سوف تستمرّ إلى الأبد، رغم ما يكيد لها الأعداء من مكائد؛ لأنّ الله تبارك وتعالى وعدنا النصر، وقال في كتابه الكريم: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (التوبة: 32).
(*) درس ثقافيّ للشهيد السيّد عبّاس الموسويّ (رضوان الله عليه)، في تاريخ 8/4/1986م.