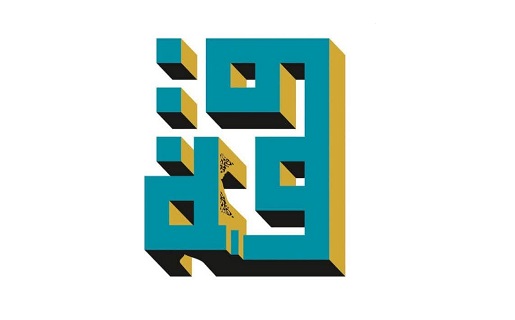منذ سنوات، ما إن يقع حدثٌ ما، حتى يبدأ المنظّرون والتيارات الفكرية المتغرّبة في تحليل الوقائع وتأطيرها بمفاهيم مستوردة ومترجَمة. وبعض هذه التحليلات، لما يبدو عليها من منطقيةٍ وتماسك، تجد طريقها إلى أعمدة الصحف أو صدور المنصّات الإخبارية‑التحليلية. غير أنّ أحد أكثر هذه المقاربات خطأً هو الحكم على المرونة الجمعية، وما يقابلها من المرونة الاجتماعية لدى المجتمع الإيراني.
منذ أحداث العنف وانتهاك الحرمات عام 2009م (1388هـ ش)، وصولًا إلى أعمال التخريب والعنف في كانون الثاني/يناير 2026م (ديماه 1404هـ ش)، مضت ستة عشر عامًا. ووفقًا للنظرة الاستيرادية السائدة، إذا أردنا تحليل حدّ التحمّل والصبر لدى الناس خلال هذه المدّة، لوجب علينا القول إنّ عتبة ملامسة العنف وردود الفعل الشعبية تجاهه قد ارتفعت. وهذه الصورة من المرونة ليست إيجابية فحسب، بل تُعدّ – بحسب هذا المنطق – دليلًا على نجاح مثيري الشغب والعنف في تعويد الناس على فقدان الحساسية إزاء بعض مظاهر الانتهاك والتجاسر.
وبعبارة أخرى، كأنّ المجتمع – بصورة لاواعية وشبه غريزية – قد اكتسب نوعًا من المرونة السلبية والانفعالية؛ سلبية من حيث إنّ حساسيته تجاه الفعل المضاد لانتهاكات الكرامة وجرعات العنف الأقل قد تراجعت، وأصبح ردّ فعله متأخرًا نسبيًا.
ولإحكام صغرى وكبرى هذا الاستدلال، تلجأ هذه التحليلات إلى مقارنة الحساسية الراهنة للناس بحساسيتهم مثلًا في عام 2009م. فيُقال: في ذلك الوقت كانت شرائح من المجتمع تثور بشدّة وتخرج للاحتجاج ضد التخريب والفتنة بعد أفعال شنيعة كحرق مسجد أو المصحف الشريف، أمّا اليوم فقد شهدنا حرق عدّة مساجد بما تحويه من كتب مقدّسة، دون أن نلحظ ردود فعل مماثلة.
والنتيجة المنطقية لمثل هذا التصوير والتحليل هي تشجيع الطيف التخريبي والمثير للشغب على مزيد من الجرأة والجسارة في ارتكاب أعمال التخريب؛ إذ إنّ هذه التحليلات تعزّز ذهنية ممارسة العنف لدى التيار الفوضوي، ومن جهة أخرى تبثّ في الوعي العام معنى السلبية واللافاعلية الجمعية، بما لا يخلو من آثار جانبية خطيرة.
في مقابل هذه التحليلات التي تبدو صحيحة في ظاهرها لكنها سطحية في عمقها، تكشف حقيقة تغلّب الناس المتكرر على شتى أشكال الشغب والعداوات الميدانية عن الحاجة إلى صياغاتٍ أعمق وأدقّ، ترى في هذا التحمّل وضبط النفس إنجازًا إيجابيًا ناتجًا عن تراكم الخبرة في تجاوز الأزمات السابقة بنجاح.
فإذا نظرنا إلى المشهد من هذا المنظور – أي إذا أدركنا واقعه الحقيقي – اتّضح لنا لماذا كان الصبر العام والعقلاني لدى الناس أرقى وأجود استجابة ممكنة لمثل هذه الاضطرابات. وندرك كذلك كيف أنّهم، عن تجربة ووعي، لا ينجرّون إلى ثنائية تصعيد العنف وتفاقمه. لقد ارتفعت سرعة التمييز بين الاحتجاج والشغب، وأصبح من الطبيعي أن نشهد مسافةً واضحة وسريعة بينهم وبين مثيري الفوضى.
فإذا كانت فتنة عام 2009م قد احتاجت إلى ما يقارب ثمانية أشهر ليتمايز صفّ الناس عن صفّ المشاغبين والمتغلبين، فإنّ الاحتجاجات الأخيرة لم تحتج إلى أكثر من أقلّ من أسبوع حتى يتبلور هذا الفصل. ووفق هذا الإطار التحليلي، فإنّ عنف وتخريب المشاغبين لا يُعدّ فعلًا هجوميًا أو ابتكاريًا، بل هو في حقيقته ردّ فعل عصبي على عدم انخراط الناس معهم. وهذا الواقع كاد أن يسدّ السبل أمام معظم المحلّلين المتغرّبين لتبرير الوضع، فلم يبقَ لهم إلا اللجوء إلى تلك الصياغة الانفعالية للمشهد التي أُشير إليها في بدايات المقال.
لقد بلغ الناس عبر هذه السنوات درجةً من النضج والخبرة جعلت الطريق مسدودًا أمام العدو وأدواته الداخلية، فلم يبقَ لهم إلا خيار المواجهة الصلبة والتصعيد الخشن. إنّ القوة الناعمة والذهنية المنتصرة لدى الناس خلال هذه الأعوام دفعت العدو إلى الانزلاق نحو أطوار ارتجاعية قاسية، كالحرب والتخريب المباشر.
ورغم ما تفرضه هذه الوقائع من تكاليف متفاوتة، فإنّها ترسم في المحصّلة أسوأ السيناريوهات للعدو، أي تحقيق أعلى درجات تحصين المجتمع ضد شتى أساليب العداء؛ سواء أكان هذا الوعي حاضرًا بالفعل أم كامنًا بالقوّة. والمهمّ أنّ هذه اليقظة، عند المنعطفات الحاسمة، تحضر في الذاكرة الجمعية للناس أقوى وأرسخ من ذي قبل.